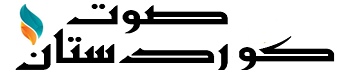المرض، ذلك الرامز للضعف الذي هو طبيعة البشر مذ سلكوا طرقاً مختلفة لعيش الحيز الزمني من حياتهم، لحين يعانقون الموت، وهو بمثابة القناعة المتصلبة عن سلسلة عوائد وتقاليد مجتمعية، تقود المرء لاستعمال لاشعوره، لامتصاص الموروث الاجتماعي، منذ طور الطفولة، لأن الطفل يمص ثدي أمه وإصبعه فيما بعد ولا يكتفي ، بل يمص بحدسه وإحساسه مع تقادم نمو فكره ،عوائد ومعتقدات البيئة وسلوكيات المحيطين به، هكذا أخذ حليم يوسف بالحديث عن ذلك الخلل النفسي والعضوي وما يقاربهما من صفات وخصائص تخص العقل وطريقة التفكير والقناعات التي تحيط بأهل البلد على نحو مسلم به وغير قابل للشك، كذلك فإن حديثه عن معتقدات بعض الناس أن طرق التداوي الطبية أحياناً قد لا تجدي مقارنة مع القناعة السائدة حول طريقة الشيوخ في معالجة المرض المستعصي، من ثم نظرة المجتمع لذلك تبعاً لأطوار عيشه وتطوره، إذ نجد الرواية مرآة لآلام الفكر والحب، وكذلك متنفساً لطرح الغبار القاتل الناتج عن ذلك التصارع العنيف بين قوى المعرفة والعطالة، إنها بناء منطقي لحياة مكتظة بالفناء وشخوصه، وانصهار كلي للعالم الصاخب في بوتقة خيال مدرك لما يحدث ، يواكبه لسان حال عارف بالعلة، وعامل على إجلاءها بجلاءها، وتبيان أسبابها ومسبباتها، لهذا تعمد الرواية الواقعية الحاملة في لبوسها المزدان بالتساؤلات، كل تلك الحياة المختزلة لنمط العيش وكذلك طبيعة النظام الذي أربك لدى العقل المعرفي ملكاته ومواهبه، لهذا نجد الجهد الإبداعي مواكباً لخلجات المرء ومدركاته على حد سواء، لإسباغ القيمة المثلى للمجابهة، وبيان حقيقته المتطلعة لحياة أكثر عدلاً ورفاهية، تأكيداً للطاقة التي تسعى دون تمييز أو هدف والتي تذهب لخدمة السلطة ومآربها، حيث نجد المعنى في رحلة الإنسان المعرفي في رحاب الوجود انطلاقاً من جغرافيته التي يحملها في سيماءه وسلوكه ومواقفه وثقافته، تجعلنا نقف أمام حقيقة التطلعات الحثيثة لإيجاد حياة أفضل خالية من العبودية والتسلط الناتجين عن امتصاص الجهل والخوف، وكذلك جملة التقاليد السلطوية في عبادة الجماهير للرعب القائم في حياتها ومؤسساتها، فبخوضنا لرمزية الخوف ما نلبث أن نقع في فخ التساؤلات المفتوحة على عديد الاحتمالات، التي تؤرخها الأحداث على طاولتي الزمان والمكان المتلاصقتين، ولعل الخوف يمثل أصل التنازع بين البشر وذلك التسلط القائم والذي يؤثر سلباً على الحياة بما يحمله المجتمع من معايير وقيم، فما أن يطغى الخوف على الذهن، حتى يتم تحوير القيم عبر تأثير الرعب المفروض على الذائقة العامة، إذ يمثل الخوف بداية التعلق بالوهم، حيث تشعر المجتمعات المسلوبة من حريتها وعقلها بأن الخوف شيء لابد من وجوده، وإنه مرتبط بوجود إله يجب أن يُعبد ويتم تقريب القرابين البشرية كرمى له، وكذلك فإن طاعة الحاكم من طاعته، وإن كل ما يحدث من بلاء وفساد، هو إرادة ذلك الإله السادي، لهذا نجد الخوف قد بات منظومة ناتجة عن تلاقح رغبات السلطوي، مع ما يفند أسباب بقاءه حاكماً بنص مقدس، يتلقفه البسطاء ببراءة ساذجة، وعنف ممنهج، لقد امتزج الخوف بالمكان والزمان والتربية والمعرفة التي يتلقاها التلاميذ في المدارس، وقد جعلت الحلوق مكتظة بالأنين والكآبة، جراء تقمصها للخوف باحترافية، حتى صارت الثقافة الشعبية والمكتسبة من حقول التربية والتعليم ، وجهاً لطبيعة المجتمع، الذي يتحدث عنه حليم يوسف في هذه الرواية، خوف بلا أسنان، لهذا ظلت الشجاعة في الخطاب الشرق أوسطي مجرد وسيلة لتقمص ماضي متخم بالأكاذيب والاعتزاز الوهمي الذي لا يمكن الاستنجاد به لبناء شجاعة مستمدة من الواقع الشاحب، أي من هذا الحاضر المحاصر بأغلال السلطة وممارساتها التعسفية تجاه المجتمع والأفراد، فأمام هذا الضغط التاريخي والإرث السلطوي، تجد المجتمعات نفسها في حالة من الاغتراب عن ذواتها، فتمارس عيشها بضرب من الجمود والاتكال والخوف من الغد، ولا يتم ردع الخوف بالسبل الفكرية، لغياب الفكر، والاكتفاء بالتسليم لحقيقة ما يحدث ، فهو قضاء وقدر حسب المفهوم الديني الجاهز لاستقبال الخوف، فالعين التي تبكي من خشية الله، وفق التعبير الديني المرمز، هي ذاتها تلك العين التي تبكي لبطش الحاكم، ورب العائلة وأستاذ المدرسة، فلا يمكن في الحقيقة فصل التراث الديني عن السلطوي في كونهما أداتين عميقتين في سحق التنوير الاجتماعي، لهذا تكتظ جموع الخوف في المسيرات التي تهتف بحياة الرئيس الخالد، ابن الله على الأرض، ذلك الذي أعطاه الإله الملك بقضاءه وقدره وإرادته، لهذا على الناس أبداً المسير هاتفين بحياته، وهم يحملون خوفهم كجينات تدخل أعماقهم وأذهانهم، وهكذا لن يتم بيسر خلع أقفال الخوف، حيث تتحول الشوارع إلى متاهات وسراديب تتنقل عبرها الكتل الآدمية، ولا تبدو الأخلاق الجمعية إلا معايير مقتبسة عن ثنائية الحاكم والمحكوم، على غرار الخالق والمخلوق، لهذا تبدو العقول خاوية سوى من ترهات وأقاويل يتناقلها البسطاء جيلاً تلو جيل، لتزيين نمط حياتهم الأشبه بتلك الفكاهة السوداء، التي تعتبر عنوان حياتهم وسر فظاظتها وتشاؤميتها، لتغدو أحلام الديمقراطية والانفتاح عن المجتمع مجرد قصص لا تكاد تملأ الأرواح الخاوية سوى من أحلام لا تقيها هاجس الضياع والاغتراب المزمن ، إن تشرب الفرد للخوف هو بمثابة ابتعاده عن الذات، واختفاء مظاهر التصالح مع عموم الأشياء التي تخص مزايا الإبداع الفردي في الوجود، لهذا يعمل السلطويون على تشبع المجتمع بالخوف منهم، بغية حصر الحياة الاجتماعية في مظاهر الإمتثال لولي
النعمة والقائد الأبد، والهتاف له وفداءه بروحه وماشابهه من شعارات، إذ أن الطفل يتعرض لهذا النوع من الإخصاء الفكري
1
والمعرفي منذ بداية دخوله للمدرسة وحمله لصور رئيسه المفدى ، لقد جعلت النظم الشمولية من الفرد، منافقاً ذليلاً، لا يجب أن يتحول لناقد، بل لمسلِّم لحقيقة واقعه، مرتهناً لكل لحظة خوف، جاعلاً من نفسه مريداً رديئاً بأبسط الأحوال، يقبل على ما وضع على طاولته إثر خوف وقمع وتهويم ممنهج ، ليكون بذلك مجرد مقاول أو عامل في مصنع الخضوع للأوامر والإلتزامات الباهتة المستمدة من عوائد ثيوقراطية دينية تم تحويرها بما يلائم ذهنية الحزب الإيديولوجية، لتتحول إلى دين شامل مكتظ بالخوف والطاعة القسرية، والخوف من الأمن، بدل من الإطمئنان لوجوده، إذ أن جهاز الأمن هو سلاح مسلط على الجماهير بغية إرهابها،والحد من تطلعها لعالم أفضل تسوده ثقافة الاختلاف وحرية التعبير، فحقيقة النزوع للعصيان والتمرد، تدفع بالمرء للتساؤل عن سر ارتياده لجغرافيا الخوف المشتقة عن عوالم تعج بالعصاب والسادية، إذ أنهما يوهنان الذات، يضعفانها على الدوام، حيث لا إرادة حرة في ظل الرهبة، ولا يكاد المرء يدخر شيئاً من سعة الفهم إزاء الإقصاء للحياة الطبيعية، حيث يسهم الموت في الخمول على الصعيدين الروحي والذهني، حيث ينعدم الإداراك باختفاء الحرية والتعبير عن الرأي، تتعطل مدركات ومواهب المعرفي، إذ يجد نفسه في بوتقة حصار مطبق، حيث تتجسد الأوهام والتقاليد المحبطة في ذوات الأفراد، ينتج الخوف ذلك العنف وجلد الذات، إزاء خيبات وأوجاع متراكمة، يفرز الخوف أيضاً الحرب الأهلية، فالأفراد ينفسون عن خوفهم من السلطة عبر شجارهم واحتقانهم ضد بعضهم البعض، حيث يجوعون ولا يجدون غير العنف وسيلة لإفراغ طاقة الخوف الكامنة في دواخلهم،لنجد أن ذلك كله مدعاة تفكر بحقيقة السلطة التي تعمل ليل نهار لتكبيل مجتمعاتها بأشكال التهويم والإخصاء المعرفي، ثمة علاقة بين الأب العنيف ورجل الأمن العنيف في أنهما يعملان تحت ظل القائد الإله، الذي يلهث خلفه قطيع آدمي خائف، يزيف طبائعه تبعاً لمشيئة منظومة القمع، تلك المنظومة التي بنت امبراطوريتها الإرهابية من النصوص الدينية المقدسة، والتي شرعنت مكوثها ووصايتها على شعوب لا تنفك عن ممارسة خضوعها بضرب من الاتكال والجمود وبصك مقدس لا مجال للشك فيه،نعم حيث للخوف رمزية كبيرة عظيمة التأثير على الحياة الدقيقة للمجتمع وأطوار أفرادها، إنها أساس كل انحلال روحي أو فكري، ولعله أيضاً نافذة مفتوحة لاستكشاف كل من هب ودب من مآسي ونكبات، حيث يولد من بطن الخوف ذلك التملق الذي بات من شعائر أمم القضاء والقدر، إنها مجتمعات استساغت الخضوع وثقافة القطيع، ولعق أحذية القادة والأولياء والمتصوفين أصحاب البركات، وتشربت أدبيات القائد الملهم الذي يفكر بالنيابة عن الغالبية المطأطئة، لهذا بات من الشائك استئصال هذا الورم النفسي الذي تأصل وساعدت النصوص المقدسة على رسوخه وتوطيده عميقاً، إذ للمقدس دوراً نفسياً بالغ الأثر في ذائقة الفرد، والتي عليها ينبني الأساس الحقيقي لقيام السلطة القمعية الفاسدة، إذ حينما تنشغل المعدة مع العقل في البحث عن لقمة العيش كل يوم ، لا يتراءى في ذهن اللاهث نحو الشبع إلا إرضاء من بيده مفاتيح كل شيء وهو على كل شيء قدير ، هذا من ناحية ، ويرادفها على الطرف الآخر، سلطة تحتكر الجهد والعمل وعلى اللاهث إبداء كل مظاهر التملق والصمت حتى يتيسر له الحد الأدنى من الحياة الجيدة، ومن هنا تتشكل أولى لبنات الخوف، ولعل ميلنا إلى التحليل وإرجاع الأسباب لمسبباتها هو ميلنا لتحسين طرائق توجيه التلقي نحو الأفضل، بغية الكشف عن كل ما يتم إخفاءه تحت مسميات مثالية باطلة، والمقصد من ذلك إسباغ دلالات إيجابية على الخوف والسلطة، أو محاولة الدفاع عن الإله الواحد المرادف للقائد الواحد والذي تنتشر صوره في كل مكان، ويخرج الناس حاملين صوره ليعبروا عن حبهم الشعاراتي له، إن كل من يحاول تحصين هذه التقاليد الشمولية الميثولوجية في أصلها، يعمل على تبرير الخوف والقداسة، وتجميله على نحو مكشوف وباهت، لا يمكن إنشاء فلسفة فوق أنقاض نسق مقدس يعتمد على الخضوع والتسليم بفكر القائد الفيلسوف، إذ يستحيل أن يكون السلطوي فيلسوفاً ناجحاً، أو أن يكون الفيلسوف سلطوياً حقيقياً، مازال ثمة شرخ عميق بين رؤى الفلاسفة وأصحاب السلطة والمنظرين بخصوصها، حيث لم ترقى تنظيراتهم سوى عن كونها مسوغات تحايلية هدفها تجديد ثقافة القطيع، والحد من بروز الإنسان المعرفي المتفوق،حيث نشأ الخوف في كنف الجهل، واعتبر مقوماً حقيقياً من مقومات نشر العنف والقداسة المتشبعة بالدم، ليسطر بسحنته الرمادية البؤس الموغل في الوجود، هكذا خيل للبشري أن الأساطير جزء من حياته، ولابد من أن يوقرها ، كونها جزء من ديانته التي يعتنقها، والتي باتت لزاماً عليه أن يصدقها ويتعامل معها كواجب وحرز للحفاظ على رأسه ولقمته في ظل منظومة تقاسمه كل شيء، مع الخوف ينعدم الاستقرار، تصبح الحاجة للثبات أمراً حتمياً في ظل حياة متزعزعة البنى ، يلهث الأفراد فيها إلى شيء يحقق لهم الطمأنينة، حيث يسخر أنصار الخرافة من مواهب ومدركات المعرفيين، ويتعاظم ذلك الصراع المضطرب فيما بينهما، ليعد امتداداً تاريخياً لمعارك الأمس، ليس لأجل السيطرة على الجغرافيا فحسب، وإنما لأجل تشريع منظومة الأقوى كونه الأجدر بالبقاء، على حساب الأضعف الذي يضمحل ويتلاشى،إننا نميل لإسباغ التعاريف على شتى المفاهيم التي نسلم بها مع كثرة إعادة حفظها وتلقينها في أنفسنا، كون المرء يميل إلى ما هو في سريرته الذهنية والفكرية على نحو رصين، لهذا كان التحديد بمثابة حصار ، وصار هذا الحصار بمثابة لزام يشهد على عبث تلك المصارعة اللغوية بين فريقين ، يزعم أحدهما أنه تفقه المعاني والأفكار عن كثب على عكس المقابل منه، لسنا مع القولبة، والتجمد في متن مجموعة مسلمات، إن ذلك سبب ضراوة في التوحش لدى الإنسان الشرق أوسطي، عبر تصوفه الديني والحزبي الراهن، إنه يمتص ويؤمن بعماء، دون معرفة أن كل رهان على قولبة فكر مسلَّم به ، هو بمثابة مغامرة اعتباطية، ولهذا أدركنا أن المعرفة التي نسعى إليها كمعرفيين ، هو زبدة التنوير والخلاص من قيد الترهل الفكري والتسطح الإيديولوجي،لتدشين معالم
2
ثقة ونهوض ضد أطوار الخوف التي رسختها المنظومة الأبوية بشقيها السلطوي والعائلي،حيث أن كل كتابة منحازة، والإيديولوجية تعريفاً ،هي مجموعة أفكار نتقنع بها تكون إما امتصصناها بالوراثة،أو باللاشعور،لا ننفك عنها،وان ادعينا التحرر منها.فآثارها جلية في الطباع .وإن تطبعنا بأفكار مكتسبة جديدة،فدعوى التحرر من كل شيء نسبي يبقى مجرد رغبة، الا أننا نتفاعل مع كل ما هو باطن فينا أو مكتسب،رغبة منا في إقامة تواشج ما على صعيد الأفكار والتعاليم،اذ سرعان ما تتحول الأفكار لاتجاهات..أما التصوف والتجمد في قيعانها.فتلك هي المعضلة الواقفة حجر عثرة في طريق نهضة المعرفي، حيث يحلينا الخوف إلى تخاطر وجودي حول تساؤلات الإنسان إزاء تجربة الحياة التي يعيشها من طور الصبا إلى طور النضج فالكهولة، لأن الخوف لا ينحصر مداه في العلاقة ما بين السلطة والجماهير، وإنما يتعداه ليشير إلى حياة المرء، وقلقه من المستقبل، وذلك الغموض الذي يلف طبيعة الحياة والسلوكيات، مما تسبب لدى المرء حالة من الحيرة والتأمل في المجهول، فلا يوجد ما وراء العدم، حيث تنقطع فلسفة الأحياء بمجرد أن يموت الحي، ويخرج من سجل الحياة الحركية، ليتعفن ويتفسخ ويعود لاستيطان التراب، ليتحول إلى شيء آخر وينضم للوجود على نحو متلاحم متوحد، بكل ذرات الحياة ومصادرها، إن تأمل الوجود لا بد وأن يمر من بوابة القلق، ولا تخلو الرواية من إشارات مهمة لمواكبة هذه الحقيقة وملابساتها في النفوس التي تقتات الحياة على نحو تأملي،لماذا يخاف الإنسان في ظل الوجود المتشعب والذاهب به للترهل والفناء؟!، ولماذا يضع البشر العراقيل الجمة في طريق بعضهم البعض، للحيلولة دون التمتع المنصف بمتع ولذائذ الحياة، فإلى جانب العدم الذي هو مصير كل الأحياء، يقف الإنسان في وجه المقابل منه، دون وازع معرفي، وإنما قائم على إلغاء الآخر لتقديم الذات، سفك الدم بمثابة تعجيل قدوم العدم، ليقبض على كل متحرك، ولعل الفوضى الناجمة عن العنف هو ما يخيف أكثر،وسط عالم أباح الموت في كل مناحي حياته، فالقمع وقتل الحب، وهدم العلاقات الطبيعية، وتلويث الطبيعة عبر الحرب، كل ذلك جعل الخوف الأكثر قرباً من الإنسان وبقية الكائنات، حيث يتحلل الجمال المجسد في الإنسان إلى وهم ودخان ناجم عن الخروقات الكبيرة للإنسان الجشع والأناني، وإضفاء مسوغات مقدسة واهية على طبيعة حربه ضد الآخرين، لقد برزت المحن العديدة بوجه المجتمعات الساعية لحريتها، وسط تابوهات كثيرة شلت حركتها، مما تعاظم قلقها تجاه مستقبلها، هو ذا المستقبل قد أفصح عن وجهه، وما لبث أن مر المجتمع بفوضى كبيرة، جراء ذلك العسف والجور المتراكم، والذي أنشأ داخل المقموع ثورة هائلة، ضد ما يشبه العدم والموت،حيث يقول نيكولاس بيردييف (Nicolas Berdiaeff(1 “:إن الموت هو الحقيقة الأعمق والأكثر دلالة في الحياة نفسها، لأنه يأخذ بالإنسان فوق ظواهر حياته اليومية السطحية، إنه الشيء الوحيد الذي يجعلنا نفكر في معنى الحياة ذاتها، والحياة نفسها لا معنى لها إلا في دلالة الموت عينه“. انها بلاد تعيش في دوامة الأحلام والآمال التي لا تنضب، كونها محط مواجهة وإصرار ضد تلك المظلومية التاريخية التي يعيشها الشعب الكوردستاني في أجزاء وطنه المحتلة، لهذا كان هذا الصمود والعناد بمثابة انتصار على مستوى الأفكار والآمال، وبذلك يمثل تجاوزاً على الحياة التي يعيشها الإنسان الكوردستاني على الهامش، حيث الوطن في رواية خوف بلا أسنان هو معنى الحياة المنتصرة على مفاهيم الموت والتلاشي، دعت حاجة المرء للتمسك بجذوره كنتيجة طبيعية عن شعوره بالغبن والظلم، وكذلك فهذه الحاجة تعد بمثابة البنية القويمة التي ينشدها الإنسان الطبيعي في زمن الحروب والإقصاء المفروض، إن استمرار النظم القمعية في سلوكها إزاء شعوبها، هو بمثابة الموت متعدد الأشكال، والذي يتم ممارسته لمزيد من الاحتقان والتحلل والفوضى المتراكمة، فحينما تتحول الحياة لميدان لممارسة الموت، تتعطل المدارك والمواهب الساعية لتمتين العلائق الطبيعية، تتحول المؤسسات والنظم إلى سلاح ضد الشعوب، حيث يكتظ الحدث الزماني والمكاني بأصناف الإبادات الثقافية والاجتماعية، وتصبح الحياة أشبه بموت طبيعي، هاجس لا ينفك عن تفاصيل عيشنا، وتوترنا ، يرافقه الإعلام الذي يسوق الوجع والعنف والدم، لتتحول الحياة هكذا لمشاهد عن الموت، تتموضع في كل ركن من أركان الحياة لتعبر عن نفسها بمظاهر الديكتاتورية والإقصاء وقمع الأقليات، والحروب الدينية، والتشرذم المجتمعي، فمن المفيد في هذا الصدد معرفة أوجه الموت المقدسة في مفهوم النظم الاستبدادية القمعية، إنهم يفرضون العنف على نحو ممنهج،عدا عن شبح الخوف الوجودي لدى الإنسان ، ثمة خوف سياسي اجتماعي، نفسي يستوطن تفاصيل الحياة، لا يمكن القفز فوقه، أو تجاهله، وتطرق الكاتب حليم يوسف للخوف عبر بوابة الشرق الأوسط، وتحديداً كوردستان، يمثل بمثابة النقطة المحورية في صميم هذه الرواية الوجودية والتي تعكس قلقاً حقيقياً تاريخياً، تمخض عن صراعات وويلات جمة، مرت بها هذه الرقعة على مسرح التاريخ، في ظل ذلك الغبن المفروض، يكمن ذلك التباعد بين الجماعات، والتي تصبح مستعدة لأي تصارع دموي، لنجد الخوف هو العشبة المفضلة لهذه الأنظمة ، والتي يتم استعمالها لإطعام القطيع البشري المتهالك، عبر أطوار حياتها وعيشها، وتقادم أجيالها، إنه الخوف يبقى ذلك الهاجس الضخم المستوطن العقول والقلوب، والمتحكم في طبائع الناس وعاداتها وتقاليدها، والناظم لسير حياتها ومسيرة أجيالها، لعل الموت استحوذ كافة خياراتها في الحرية والاستقلال، حيث يعد الموت بديلاً عن حياة الخوف، بات الموت أشبه بعرس الحلم، لبلوغ تلك الحياة الأفضل، حيث بات المستقبل قاتماً غامضاً في ظل هذا الخراب الذي يتسع ويتشعب أكثر ، في ظل غياب أشكال التآلف والود الاجتماعي، ذلك العبث الذي تمارسه النظم الاستبدادية متأت من نظرتها الضيقة والمغلفة بالجهل بالتعايش وثمراته الإيجابية، إنها منظومة ترفض المبادئ الإنسانية ، وتتعامل مع الخوف كضرورة لابد منها، لضبط فورة الجماهير وتطلعات أفرادها لحياة الرفاهية والتعددية، الأنظمة التي تزرح بالشر
3
والمظالم، في رقعة الشرق الأوسط، تركيا العثمانية التي خلفها إرث عظيم من التسلط والظلم وإبادة الشعوب وإذابتها في بوتقتها، وإيران الفارسية المغرمة بأمجاد الماضي المتخم بالتسلط والموت، والعراق وسوريا البعثيتين والتي وراءهما عروبة فرضت الإسلام بدموية على شعوب وثقافات، اكتسحتها وغطتها بطابعها العربي الإسلامي، إن هذه النظم المستبدة تقنعت بإرث نشر الخوف والموت ، حتى باتت على ماهي عليه الآن ، كامتداد لعصور وحقب، وما كوردستان المحتلة من قبل هذه النظم، إلا رمز تنويري لاسترداد ثقافة أمة وذاكرة شعب من مخالب الانصهار والإبادة، ورمز مقاومة تعبر عن وجود أمم تحاول نيل حريتها بالدم والحديد، لهذا تعاين رواية خوف بلا أسنان هذه المسألة الإشكالية على نحو إنساني فكري، لا يخلو من ملامسة الشجون والإفصاح عن مرارة الظلم والمعاناة، حيث يبدو الخوف في أحد صوره مقروناً بالإجحاف والظلم، جراء سلب ونهب الأراضي الكوردستانية في سوريا باسم الإصلاح الزراعي، والذي اعتبر بمثابة بؤس تم فرضه من دولة قمعية شوفينية، اعتمدت على صهر وإذابة كل المكونات العرقية في بوتقتها العربية، فهذا العبث بالحق، ووضع اليد على الملكية والحياة الاجتماعية، مثل أكبر حالة قهر في غربي كوردستان، حيث تعريب القرى والمدن الكوردية بأسماء عربية، وإجلاء الكورد من مناطقهم، لصالح استيطان العرب فيها، فالمشاريع العنصرية، أربكت لدى الإنسان الشرق أوسطي عموماً كل ثقة بالمؤسسة والدولة والقانون، وجعل الحياة ساحة للسلبية المشحونة بالاحتقان والظلم الممنهج ، الخوف ليس مجرد حدث، إنه دلالة واقعية متصلة في حياتنا وطبيعتها ومجرياتها، حيث بات اللون السائد في حياة المجتمع المقنع بالمنظومة الأبوية، للموت علاقة به، فمبرر الخائف هو خوفه من الفناء، وزوال الأمن، وقلق السلطوي من المطالبين بالحرية، هو خوف من تلاشي السطوة والمكانة، لهذا يسعى الجميع للتصارع لإبعاد شبح الخوف ما أمكن، حيث يعتقد الفيلسوف الألماني هايدجر (2)Heidegge يجب على الموت ألا يكون هاجساً وجودياً يقض مضاجعنا ،إلا أنه هاجس حقيقي يقض مضجع الأفراد المتحكمين بالمجتمع عبر أدوات القمع والترهيب، وهو أيضاً حياة معاشة لدى الغالبية غير القادرة على انتزاع حقوقها الطبيعية وتفعيل القانون المنتهك المعتمد على الإنصاف وبيان قيمة التعددية السياسية والاقتصادية لما لهما من نتائج إيجابية على المجتمعات والدول عموماً، حيث لا تسمح السلطات الديكتاتورية بإشغال عقل أفرادها بأشياء خارج عن أخطاءها وانتهاكاتها، إنما دأب وديدن الإنسان المقموع هو التفكير بذلك القمع والبؤس الذي يعيشه على مدار حياته وأطواره المختلفة، حيث تمسي الأحاديث كلها تحف المآسي الممارسة، والأماني الغائبة عن التحقيق، لنجد مدى تلك العلاقة ما بين الخطاب الديني والسلطوي المشتركين في إخافة الجماهير والحد من انطلاقها للأمام، ذلك الاغتراب الحقيقي الذي جعل الحياة متوقفة، والإنتاج مجرد كدح مجاني يقدم لذوي الجيوب المحدودة ممن يملكون زمام السطوة والتحكم بزمام الحياة ومؤسساتها، شخوص وإشارات غامضة تتناقلها رواية خوف بلا أسنان، إذ تحمل في طياتها سلوكيات الإنسان المختزلة ألوان الحياة على نمط واقعي يتوسط ما بين الرومانسية أو الواقعية المرمزة بمعالم ذو شجون، تضع القارىء في حيرة ودهشة، وترسل إليه إشارات خاطفة من خلال تجسيد الفضاء الزماني والمكاني وطبيعة الشخصيات، علاقتهم مع الخوف على حدة، وعلى نحو يسهب الخوض في عوالم الفتوة وقصصها ، فمن هروب مكاني متخم بدلالاته الوجدانية، ومن رغبة في إطلاق العنان للعواطف أو الغرائز بحدية، إلى رغبة أخرى بإثارة اللواعج والآلام لنتأمل هنا ص91: (كانوا يتجولون في الشوارع، بزعيقهم وشعاراتهم يطلبون الموت للكرد وقادتهم. هل جاؤوا للعب مباراة أم لخوض حرب؟!، تعلو قامة الأسئلة.جداول الحقد خلفت وراءها من دير الزور وحتى قامشلو أنهاراً من العداء.كانوا يتجولون داخل المدينة، ويطلبون من أهالي قامشلو تحرير فلوجة العراقية من الأمريكان. تتدحرج الأسئلة مع هذه الصرخات، هل يحملون كرة أم قنابل؟.. هل هذا فريق كرة قدم أم فريق قتل؟ كان الزمن في ذلك اليوم يسيل من تحت أرجل هذه المنطقة كماء عكر،امتلأ إستاد الجهاد بالجمهور منذ ما بعد الظهيرة.في أحد جانبي الملعب آلاف الضيوف الذين ملؤوا جيوبهم بالحجارة، يالهؤلاء الضيوف، بدل أن يحملوا وروداً وأعلام فريقهم، حملوا العصي والأسلحة وصور ديكتاتور مهزوم، يهددون مضيفيهم في عقر دارهم، يشتمونهم ويحتقرونهم. بينما كنت أفكر في هذا الحقد والبغضاء، ارتسم مرة أخرى أمام عيني سايكس الإنكليزي وبيكو الفرنسي، وكيف قسموا هذه الأوطان ببضعة خطوط، وكيف تحولت بعد رحيلهم إلى حدود مقدسة لدى سكان هذه البلدان! يبنون دساتيرهم وشرفهم وكرامتهم ومبادئهم على حماية هذه الحدود.)
تنقلنا هذه العبارات إلى تلك الأحداث الدامية التي وقعت في 12 مارس آذار 2004، في مدينة قامشلو، إثر هذه الانتفاضة تم قتل العشرات من الكردستانيين،حيث تراءى للإنسان الكردستاني، تلك المواطنة المزيفة، وذلك الحقد الدفين الذي تتعامل به المنظومة الشوفينة العنصرية ضدهم، وكذلك تيقن حجم ما يحاك من احتقان بين تلك المكونات، والتي كانت من ثمرات الآلة القمعية للنظام الحاكم، والتي كان لها الدور الأبرز في تفكك المجتمع وعدم تجانسه، فمئات الجرحى وآلاف المعتقلين يمثلون حجم الخوف المعاش في زنازين هذا الوطن الذي رسمه سايكس الإنكليزي وبيكو الفرنسي، لهذا أمست هذه الرواية بمثابة رسول لمناهضة الخوف، ذلك الذي غطى بالكراهية أديم الأرض والسماء، فالسلطة القامعة رسخت سلوكياتها في أذهان شعوبها، كي لا تتحرك الأخيرة ضدها، فكان الشعب في غالبه أدوات بيد هذه السلطة تؤلبها على بعضها كيفما تشاء ومتى تشاء، وقد حدث أن هبت الخراف من حظائرها ظناً منها أنها ستتغلب على هذا القمع، فإذ برصاصها ينقلب عليها، وإذ بها تهيئ الأرضية لسلطة أكثر حلكة وظلام، لاشك أننا نعني انتفاضة ما يعرف بالشعب السوري الذي
5
صنع حدوده سايكس الإنكليزي وبيكو الفرنسي،وهو ماضٍ إلى طريق عبَّدتها السلطات في ذهنيتها ولاشعورها، حيث أن السلطة الإقصائية أيقنت أن دوام تناسلها وبقاءها يعتمد على مدى نجاح ترسيخ منظومتها السلطوية في عقول وقلوب شرائح المجتمعات التي تحكمها، وبهذا تضمن أنها ستخرج مجدداً من عباءة الشعب المنكوب عقلياً وروحياً، لتجدد نفسها كما تبدل الأفعى والحرباء جلدها، وما خروج ما يسمى بداعش وما قبله القاعدة والإخوان وتلك التشكيلات السلفية إلا من بين هذه الفئات التي تعرضت لأمية ممنهجة وتخدير تام من رجال الدين والسلطة، إذ جعلوا المجتمع عبارة عن أحزمة ناسفة وألغام متصلة ببعضها البعض، ما إن يحدث الإنفجار حتى يغطي كامل المساحة، هذا يجعلنا نوقن أن السلطة بالتعاون مع رجل الدين واستناداً لنصوص مقدسة ، قد نجحوا تماماً في تعليب الجماهير تبعاً لأجنداتها، ولم تنجح إلا باعتقال المعرفيين، تصفيتهم أو إبعادهم خارج هذا المطبخ، إن تدمير موارد الوجود والحد من ازدهار الحياة والإنسان يتم بالتزامن مع ممارسات القمع وتحديث العبودية بمختلف أشكالها، لأجل حروب جديدة، وشروخ متتالية يدفع ثمنها الأبرياء، حيث أن تعقيد نمط الحياة متأت من شكل وممارسة السلطة وتسلطها كجهاز خوف مركز في أوساط الجماهير الشابة، ولكن العداء السافر بطبيعته يكشف عن وجهه النقاب، ضد كل صوت مؤثر وضع برنامج التغيير والانتفاضة في ذهنه، وجعلها من أولوياته، حيث يواجه المعرفيون الموت والقمع بوجه باسم، يرمز للصمود بوجه قوى التجهيل والقمع، ليعبروا عن التزامهم بماهية الجمال والإنصاف وقيمة الرفاهية في الحياة، إن استخدمت موارد وطاقات الناس بالشكل الذي يخدم تطلعاتها في التحول الديمقراطي، إن نموذج الموت المفروض على هذه المجتمعات ، هو القمع إلى مالانهاية، وترسيخه كمبدأ ديني مقدس مفروض من الله وبوساطة حراسه على الأرض، بات مسألة لا تحتمل الجدل، ولا يذهب ضحيته سوى المستنير الباحث عن سفينة خلاص لبشر يرحلون مع الطوفان، ما يذكرنا بمأساة سقراط(3) حينما ودع الحياة باسماً وهو يقول لتلامذته: „يجب على المرء أن يستقبل الموت بتفاؤل وفرح ولذا عليكم بالهدوء والتوازن” لهذا لم يكن الموت الجسدي هو ما يؤرقه بطبيعة الحال، وإنما قلقه على الأفراد والناس، خشية أن يرتحلوا إلى كهوف السذاجة والخوف من القمع والاحتكار السلطوي لكل شيء جميل، كان قلقه بمستوى ما يحمل من أفكار وتساؤلات، لهذا فقد استمدت منظومة الحكم الشمولي قوتها ،من تصفية المعرفيين والمعارف التي تحرك الأدمغة،وتجعل الجماهير تبحث عن حلول لأزماتها الفكرية على نحو خاص، وقد أدرك حليم يوسف مخاطر الخوف من تدميره لملكات العقل الذهنية لدى الناس، إذ تجعلها أشبه بألواح رخام متكسرة، وتهب أبداً الأرضية الخصبة لبروز الديكتاتوريات، إذ يجعل الخوف من الثائر ديكتاتوراً، ومن الأديب، مريداً أحمقاً، ومن المجتمع تماثيلاً محطمة، لهذا فرواية خوف بلا أسنان، تحمل في طياتها العديد من التساؤلات والتجسيدات الرمزية لماهية الخوف، وجذوره، وأثره على الفكر والجمال، ومناحي الحياة كافة، إنه بيان لعداء الحياة الجديدة، أو التحرر من سطوة الخرافة الجالبة للعنف من أوكار البدائية، فما جعل المجتمع يعيش الفوضى هو تعسف السلطة وجورها إزاءه، فالألم والمعاناة والفقد، هما مبدأ المجتمع المنكوب في ظل نظام قمعي، ألغى الإنصاف والعدل، حيث بات المستقبل على ضوء ذلك مجهولاً، إنه الجحيم السماوي المطبق في الواقع، والموت بأسوأ صوره، إن سيطرة العبودية كمنظومة أمنية على مفاصل الحياة، جعل البشر في حالة خوف دائمة، سببته أنانية المحتكرين للموارد، وغياب أشكال الوعي بالتعايش السلمي،إلى جانب سيطرة الفكر الديني على فئات المجتمع وفق مفهوم الإسلام السياسي، الذي نجحت المنظومة القمعية من تحويله فكراً إيديولوجياً، حيث استندت أدبيات حزب البعث الحاكم، على المنظور الاسلامي الديني في الحكم، إذ جعلت من العروبة أساساً للدين والأخلاق،وعليه شرعنت حكمها للمجتمع وقمعها للأقليات خصوصاً الشعب الكوردستاني، الذي يحتمي هو الآخر بحقوقه وخصوصياته القومية كردة فعل على التهميش والإقصاء والقمع الممنهج، حيث يتم الوقوف بضراوة أمام مطلب التغيير والتبدل الذي هما جزء من حركة التاريخ والحياة إجمالاً، فأمام العدم والفناء الذي هو مبدأ كل كائن حي يمر بأطوار مختلفة لغاية الترهل والمرض، تقف مفاهيم الغطرسة والموت لتقوم بتسريع الموت وتغطية الحياة بما يثقل الكاهل، لهذا نجد أن المنظومة القمعية تنحاز للموت أكثر منها للحياة، إذ يلهث السلطويين إلى تحويل الحياة لساحة تعذيب وتصفية، لخوفهم من الشعب، وتقضي الجماهير حياتها في سبات متنقلة من خوف إلى غضب ، سرعان ما تنتج عن ذلك ردة فعل عنيفة مصحوبة برياح الفوضى التي لا تنتهي، حيث تحيا المجتمعات في سجونها الكبيرة على امتداد رقعة بلادها، فتعيش حالة الاغتراب الداخلية، ولا تجد من الهجرة سوى حلاً مريراً تتقبله في النهاية راغمة، لهذا فالموت بين الجغرافيا والفرار، هو ما يمثل الخوف الدائم من مستقبل غامض المعالم، ينبأ بالمزيد من المعاناة والشعور بالكآبة السوداء، حيث تبحث الأنفس عن الطمأنينة المفتقدة، جراء القمع الممنهج الذي تعايشه في ظل الأنظمة الحاكمة والتي لا تدخر أي خطاب وهمي لترويض وامتصاص غضب الجماهير، حيث يتم تقسيم المجتمع إلا فرق وتشكيلات مضادة لبعضها البعض، التركيبة البعثية مثلاً تقوم على معاداة غير العربي في سوريا أو العراق، باعتبارهم خلايا نائمة قد يستخدمها الأعداء الخارجيون متى أرادوا، لهذا يجب تضييق الخناق عليهم، هذا عدا خوف السلطة من الشعب بعمومه، فالسجان يخاف مسجونيه، وإن كانوا في السجن، حيث يتم الاستمرار في زرع الحواجز عرقياً بين قومية وأخرى، دينياً بين مذهب وآخر، طبقياً بين شريحة مرتهنة لنظام الحكم ، وأخرى مناهضة لها ،فالصراع ما بين إرادة التغيير والخوف منه، بات وعاء يحوي قيم ومفاهيم الشرق الأوسط المتمخضة أصلاً عن ذلك التنازع، وفهمنا له يعتمد على مرورنا بطبيعة علاقة الوافد الخارجي بجغرافيا هذه المنطقة واحتفاءه بمظاهر الهوس بالسلطة والاستبداد
6
لصالح البقاء، وقد تمت ممارسة الاستعمار بواسطة الخوف والقمع، إذ عبرهما ألغيت أدوار المبدع الحر، وحلت مكانه لعبة السلطة في تعليب وتشويه كل طبيعي وحالة قائمة تحاول بناء شيء ما بمقدوره إزالة هذا الهدم المتلاحق للعلاقات الاجتماعية، من خلال زرع بذور الاحتقان، الذي بطبيعته يقيد حركة المجتمع والفرد، ويعطل من إمكانية بروز الحركة التنويرية الهادفة لإزالة الألغام السلطوية المحيطة بالعقل، فتعطيل حركة المجتمع هي إحدى وظائف السلطة القمعية ، لمواجهة الحقوق والتملص للواجبات تجاه الشعب،لا يبقى الخوف رابضاً لأمد طويل ، إذ سرعان ما يتبعثر ويتلاشى في انتفاضة تقتلع كل رهبة، كما حدث حين هبت المدن الكوردستانية في سوريا لتجديد العهد مع أرضها ودماء شهدائها وأهلها الآمنين في قامشلو، وهكذا نجد الخوف زائلاً بمحض الغضب ووجود الإرادة، لهذا ظل الخيار أمام مجموع الشعب المنهك هو الصمود بوجه ذلك اليأس والإحباط، نحو بعث يقظة الإنسان، وحربه لأجل الحرية والعدالة، حيث تجاهل الشعب المنكوب حينها ذلك الهراء الزائف المسمى بالمواطنة في ظل حكومة لا تراعي لهم عهداً ولا ذمة، فكانت تلك الهبة الشعبية، تعبيراً عن اتحاد الشعب الكوردستاني في كل مدنه وأريافه، ومحاولة لوأد الخوف للأبد، على الرغم من جبروت الطغاة وأساليب قمعهم، إلا أن لإرادة الشعوب رهبة بإمكانها زعزعتهم، فالخوف يعتبر رصيد السلطوي الذي يعتمده للبقاء في الحكم وزيادة الربح والنفوذ، وهو بالتالي خبز المجتمعات المتدينة، والمحتقنة سياسياً، فالأنظمة الاستبدادية تعتاش على مبدأ الخوف، كأسلوب ضامن لهيمنتها، كما أن رجال الدين المتواطئين تاريخياً مع السلطة،أسسوا منظومة الخوف انطلاقاً من مبدأ الوعيد بالجحيم، كنتيجة عن عصيان الله والتعاليم الواردة في النصوص المقدسة، ذلك أنتج نوعاً من التلاقح الخبيث بين الدين والسلطة كمركب فعال للقضاء على منابع الثورة الذهنية القائمة على تطوير الجدل الفكري، قد تم منع الجدل في السياسة والدين والجنس، كما تم تحويلهما كأفيون يتم تعاطيه خلف الكواليس، لإشغال الشباب به، وتنويمهم من خلاله أطول أمد، وبث البطالة والمنهاج الدراسي الجاف الخالي من التعليم الجوهري، سوى من التجهيل، وإشغال الشباب الجامعي على التفكير بالتخرج والتوظيف، إذ يمثلان أقصى طموحات الشباب في ظل عزلة اقتصادية خانقة، وفساد مدقع وشامل، وتحلل يتم ممارسته وراء الكواليس، وتمجيد للمادة التي تتيح للمرء تلك الحياة القائمة على التكاسل والنهب، كل ذلك قاد إلى نتيجة واحدة وهو التدهور الأخلاقي، والتردي النفسي الذاتي، وسحق منافع الناس،حيث تعمل الأنظمة الاستبدادية على زرع الشك والالتباس بين فئات المجتمع وشرائحه، لتنعدم الثقة بين الناس ، وتصبح الفوضى هي القالب الجامع لكل التناقضات العنفية التي من شأنها أن تقوض أركان المؤسسات كافة