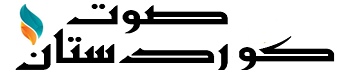حسب النص القرآني تعتبرالعدالة أساس الحكم و بالتالي فأن الهدف الأساسي من الفكر السياسي الإسلامي هو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الأمة وفقاً للمفهوم الإسلامي للعدالة. لقد وضع علماء المسلمين نظريات ومناهج محددة لتحقيق هذا الهدف. في هذا المقال، أود أن أنأقش بإيجاز بعض جوانب كلا النهجين (الواقعية والمثالية). بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون واضحاً أن الفلسفة السياسية الإسلامية بشكل عام تعتبر من الفلسفات ذات الطابع العملي، وهذا بدوره ناجم عن المنهج التطبيقي العملي للدين الإسلامي ككل, أن القاعدة القرآنية (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر), تشمل جميع مناحي الحياة والشق السياسي(الحوكمة) ليس بأستثناء من هذه القاعدة . كان هنالك نقد من البعض بأن الإسلام لا يمتلك نظرية أخلاقية بالمفهوم الحديث للمصطلح لأن الفقه الإسلامي طغى عليه في هذا الميدان. في حقيقة الأمر, وكما أشار اليه سابقا المفكر الجزائري مالك بن نبي في كتابه القيم الظاهرة القرآنية, أن النظرية الأخلاقية القرآنية قائمة على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, فهي بهذا الطريقة تكون كاملة متكاملة وشاملة ,فهي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر في نفس الوقت بخلاف النظريات الأخلاقية الأخرى التي تحدد قيمة الخير مثلا ولكن لا تشرح بالطريقة الكافية سبل تحقيقه و كذلك الشر وكيفية أجتنابه.
لقد وضع علماء المسلمين من أمثال الماوردي، وابن تيمية، وابن حزم، والأزرق، من بين أمور أخرى، وجهة النظر الواقعية هذه في الفقه السياسي الإسلامي. الماوردي يمثل مذهب الواقعية في الفكر السياسي الإسلامي، تعريفه وفهمه للخلافة كمؤسسة دينية واجتماعية على سبيل المثال، كافية لمعرفة تفكيره السياسي الواقعي؛ حيث يعتبر بحق مؤسس الفكر السياسي الإسلامي السّنّي، خاصة من خلال مؤلفه الهام، الأحكام السلطانية. عالم إسلامي واقعي آخر هو ابن حزم، مثله مثل الماوردي، يمثل نظرة واقعية للوضع السياسي في غرب العالم الإسلامي: الأندلس. بشكل عام، لم تكن آراء ابن حزم السياسية بعيدة عن الفهم السّنّي العام (لكونه ظاهري المذهب) للمؤسسات السياسية في الإسلام، وخصوصاً الخلافة.
هنالك نقطة يجب أن توضح, وهي بخصوص النظرية السياسية في الإسلام. لقد انتقد البعض النظام السياسي الإسلامي بأنه ليست لديه نظرية محددة (بخصوص مؤسسة الخلافة و الجدال الدائر حوله, أنظر كتابات علي عبد الرازق في كتابه الإسلام و أصول الحكم, كتب الأستشراق بشكل عام, الأستاذ ضياء الدين الريس وكتابه القيم النظريات السياسية في الإسلام وردور الشيخ احمد شلتوت, محمد الخضر حسين, الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور و الفقيه الدستوري المخضرم عبد الرزاق السنهوري في كتابه فقه الخلافة على كتاب الأسلام وأصول الحكم). حقيقة, يجب أن يفهم عدم تحديد نظام سياسي محدد ملتزم بمثابة دليل و برهان على حيوية وديناميكية وتطبيقية وواقعية الفكر السياسي الإسلامي الذي منح المسلمين بأعتماد نظام الحكم الذي يرونه مناسبا لظروف زمانهم ومكانهم شريطة أن يكون قائما على العدل و الحق و الشورى والعقيدة القرآنية الأيمانية الراسخة. هناك نظم سياسية تعتمد على الديمقراطية المباشرة عن طريق الأنتخاب الحر المباشر من خلال الأحزاب ومرشحيهم في البرلمان. وهناك دول ومجتمعات تعتمد الديمقراطية الغير مباشرة وتكتفي بمجلس أعيان أو شورى مصغر (بدون أحزاب- بما معناه ديمقراطية سادة خالية من حلاوة ومرارة التحزب), حسب طبيعة المجتمع وثقافته وتاريخه السياسي.
كلتا الحالتين مقبولة وسليمة مادامت تضمن المبادئ الرئيسية للفكر السياسي الإسلامي المستمدة أساسا من النص القرآني. وفي هذا السياق, أن نظرية ابن خلدون في قيام و سقوط الدول والحكومات ربما تكون غير صالحة لكل زمان ومكان, وبالتالي تكون نظرية العصبية القبلية غير قابلة للتحقيق في كل المجتمعات, كالمجتمعات الأسكندنافية في يومنا الحالي مثلا, لأن هذه المجتمعات لاتعرف للقبلية العصبية سبيلا, ومع ذلك تسجل عام تلو الآخر, أفضل مستويات المعيشة و الأستقرار على الصعيد العالمي. وربما أيضا يكون الفكر العشائري القبلي العصبي الخلدوني مضرا بمفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة أكثر من نفعه, وخاصة عندما ينظر الناس الى بعضهم البعض بعيون عشائرية قبلية التي تؤدي في نهاية المطاف الى أضعاف روح المواطنة بينهم كنتيجة كلية نهائية و الله أعلم. ولكن يجب أن نعي التحديات التي تعيشها المجتمعات الديمقراطية الغربية أيضا وخاصة في مسائل التعددية الثقافية و الهجرة… خذ مثلا موضوع المهاجرين و شعورالمواطنة, خاصة لدى أبناء الجيل الثاني و الثالث و ما يواجهونه من أزمة هوية و أنتماء, و كذلك معرفة ما هو المطلوب منهم بالذات: أندماج حقيقي أم ذوبان وأنصهار كامل في بوتقة المجتمع المضيف أو البلد الثاني و كيفية القيام بذلك. بخصوص التعددية الثفافية, أنظر كتابات (مونتسكيو في العصر الحديث, بهيكهو باريخ و كمليكا ),في المعاصر و الحالي.
عودة الى موضوعنا الرئيس, لقد عانى ابن حزم من الاضطهاد السياسي، كما كان متحسراً جداً من الواقع السياسي المتشتت الفاسد المنتشر بين الحكام المسلمين في الأندلس، وخاصة بعد سقوط الحكم الأموي حيث حاول جاهداً تصحيح الوضع السياسي القائم والعودة إلى زمن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الأربعة. ومع ذلك، كانت ردود فعله ومحاولاته هذه عن إحداث تغيير سياسي محتمل قد ذهبت هباءً منثوراً. كان ابن حزم واقعياً في تشخيص المشاكل الاجتماعية والسياسية للمجتمع، وبذل جهداً كبيراً لحل ما يمكن حله. وكان مؤيداً للحكم الأموي في الأندلس ويرى فيه الخلف الصالح لإقامة خلافة إسلامية في الأندلس؛ حيث كان يرى أن ذلك الفساد وتلك الانقسامات قد ساهمت بشكل كبير في إعطاء العدو (الملوك المسيحيين في الشمال) الفرصة لمهاجمة الأندلس. هنا أود الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان، عند دراسة وتحليل الإنتاج الفكري لابن حزم، يجب فهم السياق التاريخي والحالات الشخصية والصعوبات التي واجهها في حياته بطرق عديدة. بعد هذا الاعتبار، نستطيع أن نفهم وأن لا نندهش عند قراءة نصوصه المختلفة لا سيما انتقاداته للجالية اليهودية في الأندلس، وكيف كان لها امتيازات من الحكام الفاسدين بنظره. و في سياق متصل, نفس الكلام تقرييبا نستطيع قوله عن فتاوى ابن تيمية بخصوص الجهاد, لقد كانت معظم فتاويه ضمن سياق تاريخي محدد لمقاومة خطر التتار على الأمة الإسلامية وليس بالضرورة فتاوى ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان حتى لا يفهم بأنه شيخ التزمت فقط.
يمكن للمرء أن يقول إذاً: إن الماوردي في الشرق، وابن حزم في الغرب، قد مثّلا الواقعية السياسية في التفكير اللاهوتي الإسلامي خير تمثيل. الآن، وبهذا الصدد، أود مناقشة الفرق الرئيسي بين الواقعية السياسية في الإسلام والغرب المسيحي في ذلك السياق التاريخي. ونحن جميعاً نعرف إلى حد ما كتاب الأمير لمكيافيلي إذ استند عند كتابة مؤلفه الشهير على التجارب التاريخية الغربية؛ ليقدم بعض النصائح والإرشادات في العمل السياسي الإداري للإمارات الإيطالية عندما كانت مقسمة آنذاك وتغوص في بحور من الفساد السياسي والتفكك. شعوره بإصلاح ما يمكن إصلاحه لم يختلف عن شعور ابن حزم في السياق الأندلسي. لقد أصاب ماكيافيلي عندما اعتمد الواقعية السياسية لإصلاح البيت الإيطالي، ولكنه أخطأ باعتماده واقعية فاقدة للقيمة الأخلاقية. عبارته الشهيرة: الغاية تبررالوسيلة، تعتبر ملغاة من وجهة نظرالأخلاق السياسية الإسلامية.
في الحالة الإسلامية، الواقعية السياسية تستند على المبررات الدينية والأخلاقية. من وجهة نظر الأخلاق الإسلامية، يجب أن تكون الوسيلة نزيهة وأخلاقية بقدرما تكون الغاية نفسها كذلك، وبالتالي المفهوم الميكافيلي مرفوض من زاوية الفكر السياسي الأخلاقي ولكنها ربما تكون مناسبة للسياق التاريخي الإيطالي في ذلك الوقت وهذا ما أشار اليه موسيليني في مقدمته عن كتاب الأمير؛ بل أنه قال أن الأحداث التاريخية البشرية في حركة تاريخية حيوية مستمرة, و بالتالي نصائح كتاب الأمير سارية المفعول للقرن العشرين. الجميع يعلم أن موسيليني كان يتطلع الى أعادة الأمجاد الرومانية, عندما كانت روما تحكم العالم تقريبا وعندما كان البحر الأبيض المتوسط الضخم مجرد بحيرة رومانية. الجانب الآخر الذي أود الحديث عنه بخصوص الفكر السياسي الإسلامي هي المثالية، بداية إن دلّ هذا على شيء, فإنما يدل على ثراء الفكر السياسي الإسلامي ليشمل الجانبين الواقعي والمثالي كما أسلفنا سابقا.
المثالية تجلَّت في الفلسفة الإسلامية من خلال الفارابي الذي يعتبر بحق مؤسس الفلسفة السياسية الإسلامية المثالية، أو بالأحرى الأفتراضية. لقد تأثر الفارابي بأفلاطون كثيراً حتى إنه كتب مدينته (المدينة الفاضلة) على غرار جمهوريته. محور الفلسفة اليونانية القديمة كانت تدور حول سعادة الإنسان بينما الغرض الأساسي للفكر السياسي الإسلامي هو تحقيق العدالة الشاملة من خلال حكومة راشدة .وهذا هو باختصار جوهر الخلاف بين الفكرين السياسي الإسلامي واليوناني في ذلك السياق التاريخي القديم. مثال آخر عن المثالية السياسية الإسلامية يتجلّى في حالة الطرطوسي من خلال كتابه الشهير سراج الملوك .لقد اعتمد الطرطوسي في كتابه هذا على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، بالإضافة إلى تجارب تاريخية من أمم أخرى كالإغريق والفرس والهنود ليقدم بها جملة من النصائح للسلاطين والأمراء في السياسة والتنظيم الإداري للحكومات لتطبيقها في إماراتهم وممالكهم. كتاب سراج الملوك للطرطوسي يمكن مقارنته بكتب التراث السياسي الغربي في فصل مرايا الأمراء. المشكل في منهج الطرطوسي هذا هو أنه يأخذ بتجارب سياسية من سياقات سياسية ودينية وثقافية مختلفة ومتباينة كثيراً وكله ثقة بأن منهجه هذا صالح لكل زمان ومكان دون الأخذ بالاعتبار الخصائص المتميزة التي تميز كل سياق وتجربة عن سابقتها، وبالتالي ليس من الضروري اعتبار أنه كان صالحاً للتجربة الإسلامية الأندلسية. على أية حال، كتاب الطرطوسي لا يزال يملك بعض الصلاحية في مجال المطالعة والمشورة السياسية والاستفادة من دروس الماضي إجمالاً.
وهكذا يكون الفكر السياسي الإسلامي غني عن التعريف بشموليته لأنواع مختلفة من التوجه الفكري ويقدم جوابا عن نظرية الخلافة التي كانت مثار جدل تاريخي مستمر و ما أحدثه من خلاف سياسي بداية ثم تحوله لاحقا الى أختلاف عقائدي مذهبي (على الأقل في الفروع), أدى الى نشوء المذهب الشيعي منذ يوم السقيفة الى يومنا الحالي.
الدكتور: قبات شيخ نواف الجافي
دكتوراه في علوم الأديان. جامعة مدريد – اسبانيا