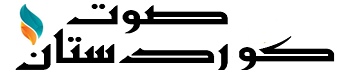إن العمل القضائي إذا كان محدودا وغير كافٍ في تلبية احتياجات المجتمع، فإن المنازعات تتراكم، والمصالح تتعطل، مما يسبب تداعيات خطيرة لها أثرها البالغ في صميم حياة الناس وطمأنينتهم واستقرارهم الاجتماعي وانتظام سائر شؤونهم. ولعل أهم تلك التداعيات:
– تضييع حقوق المتقاضين إذا طال زمن التقاضي، وزيادة معاناتهم وشغلهم عن الاهتمام بأمور حياتهم الأخرى، وزيادة نفقات وتكاليف الحصول على حقوقهم.
– اليأس من الحصول على الحق، وفقدان الثقة في جهاز القضاء وإجراءاته، ومحاولة الحصول على الحق بالقوة الشخصية، أو الاضطرار إلى التصالح بجزء ولو يسير من الحق، أو ترك الحق كله.
– ازدياد حالات الاعتداء واستفحالها نظرا لتأكد المعتدين ومحترفي الإجرام من أن العقوبة لا تطالهم، ويترتب عن كل ذلك الإخلال بالأمن العام واضطراب أوضاع المجتمع (1).
العدالة الجنائية إذا اتصفت بالإنصاف والمسؤولية الأخلاقية والفعالية فإن ذلك يعتبر عاملا هاماً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان. ونجد أن من غايات الأمم المتحدة إنفاذ القانون وإدارة شؤون العدالة بكفاءة وفعالية كبيرتين مع ضرورة إيلاء أكبر عناية لإحترام حقوق الإنسان، لذلك فكل دولة مسؤولة على إقامة نظام للعدالة الجنائية يكون من صفاته الإنصاف والمسؤولية الأخلاقية والكفاءة. و يعتبر قانون الاجراءات الجزائية المعبِّر عن واقع الحرية ومدى احترام حقوق الإنسان في أي بلد، فإذا كان هدف قانون الاجراءات الجزائية البحث عن الحقيقة والكشف عنها تحقيقا لمصلحة الدولة في تطبيق العقوبة مع تغييب الحرية الشخصية للمتهم، فإن الدولة في هذه الحالة تكون متسلطة وهذا الحال في أغلب الأنظمة غير الديمقراطية، أما الأنظمة الديمقراطية فإن أي تنظيم إجرائي فيها مهمته الأساسية هي تحقيق التوازن بين سلطة الدولة ومصلحة الفرد، لأن قانون الاجراءات الجزائية في حقيقته ليس مجرد وسائل فنية بحتة، بل هي أعمال تمس حقوق الإنسان وحرياته الشخصية لا سيما في حالة الشبهة والاتهام، وفي حالة جمع الأدلة، فمن خلال هذه الاجراءات قد تكون حرية الإنسان وحقوقه الأساسية محلا للاعتداء (2). تخصص القاضي ضمان أساسي لاستقلال القضاء فكما يقتضي استقلال القضاء وبعده عن تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في أعماله، فإنه يجب أن يكون غير خاضع في أداء مهامه لغير القانون، وهو ما يحقق للقضاء المعنى الإيجابي لاستقلاله، لكن خضوع القضاء ومن ورائه القاضي لحكم القانون يتطلب تكوينا مهنيا يوفر الكفاءة المهنية اللازمة للقاضي. و تكوين القضاة يمر بثلاثة مراحل، حيث يعتبر التكوين الذي يتلقاه في كلية الحقوق بمثابة التكوين الأساسي والقاعدي، لِيَتبَعَهُ التكوين المتخصص في معاهد ومدارس القضاة، والذي يجب أن يتبعه القاضي بالتكوين المستمر الذي يتم من خلال الاطلاع الدائم والدورات التدريبية، مع ضرورة إلمامه بشتى العلوم القريبة إلى مهنته من طب شرعي وعقلي وعلم الإجرام وكذلك الإلمام بالعلوم التطبيقية، وهو ما يوفر للقاضي القدرة على فهم القانون ومن ثم الحكم به على الواقعة محل النزاع بعد أن تتوفر له القدرة على الاستنباط السليم(3). وهو ما يعرف بمبدأ تخصص القاضي(4). والذي يقصد به قصر العمل القضائي على فئات معينة مؤهلة تأهيلا قانونيا خاصا، ولها من التجربة والخصائص ما يضمن لها أداء مهمة القضاء بكفاءة كبيرة. و إعداد القاضي الجزائي يتطلب توفر مؤهلات تمكنه من أداء دوره في المجتمع ، مع ضرورة تكوينه تكويناً سليماً متناسباً مع إمكانياته و توجهاته و المهمة التي أُعدَّ لها ، و هو ما سيؤدي بلا شك إلى تخريج نخبة من القضاة المتميزين القادرين على تولي مهامهم بكفاءة مما ينعكس إيجاباً على جهاز القضاء وعلى المتقاضين أنفسهم و الذي سيشعرون بالرضا و بعدالة الأحكام الصادرة. ومـما تجدر الإشارة إليه أن التخصص الدقيق في مجال الاختصاص الجنائي أصبح مطلبا لا يمكن التنازل عنه ، فالخبرة المتراكمة من سنوات العمل و التي يسبقها تكوين متخصص ودورات تدريبية أصبح ضرورة لا يمكن التغاضي عنها خاصة في ظل جهود عصرنة قطاع العدالة. ورغم ما تبدو عليه فكرة التخصص القضائي من أهمية إلا أن بعض الفقهاء يرون أن التخصص في هذا المجال تحديدا من شأنه أن يؤدي إلى جمود الذهن البشري و يؤدي إلى امتهانه ، و القضاء عليه و حصره في نطاق من شأنه أن يجمِّد قدرته على البحث ، الابتكار ، و التطور ، و الحركة ، والانزواء داخل محيط التخصص دون النظر إلى ما في باقي المجالات ، أما الذين يدافعون عن التخصص فيرون أنه أصبح ضرورة لا مفر منها في عصرنا الحالي ، عندما كانت هذه المعرفة محدودة ، كما يؤكد أنصار التخصص أنه يساعد على الإنتاج و إتقانه ، و قد أصبحت الحاجة اليوم إلى إجابة مطالب أكبر عدد من أفراد الشعب في الخدمات المختلفة تحتاج إلى تعبئة أعداد أكبر من المتخصصين ، و أصبح التخصص هو السبيل الوحيد الذي يمكن به للدولة أن تُلبي هذه الخدمات ، و مما لا شك فيه أن بعض العلوم تحتاج أكثر من غيرها لعنصر التخصص فلا يمكن لها دوام الاستمرار و التطور بغير تخصص مشتغليها و منفذيها(5). ولا شك أنه لا يكفي لمواجهة الجريمة على نحو فعال أن يتضمن القانون الجنائي نصوصا للتجريم أو يفرض لها عقوبات رادعة، بل ينبغي على المشرع أن يؤازرها بالقواعد الإجرائية اللازمة التي تمكن السلطات المختصة من سرعة الكشف عن الجريمة وضبط الجاني وإدانته في أسرع وقت ممكن (6).
إن مما يزعزع ثقة الناس في العمل القضائي البطء الشديد في معالجة المنازعات. وإن لسرعة التقاضي الأثر الكبير في دعم ثقة المواطن في أجهزة العدالة والحفاظ على الأمن الاجتماعي. ينبغي أن يكون القاضي أكثر اطلاعاً على المجتمع بكل مقوماته، ويُسهم في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية داخل المجتمع، وإدارة حوارات فكرية ومعرفية لتجاوز جميع أشكال الاحتقان والتأزم الذي يؤدي في أغلب الأحوال إلى التشظي وتفتيت مقومات الهوية، وتكريس حالة التشرذم وانعدام الأمن الاجتماعي. إن العمل القضائي إذا كان محدوداً وغير كافٍ في تلبية احتياجات المجتمع، فإنه يؤدي إلى تضييع الحقوق، وتوسيع دائرة النزاع، وازدياد حالات الاعتداء، والإخلال بالأمن الاجتماعي. إن نشر العدل وبث روح الأمن والاستقرار في المجتمع يقتضي ضرورة أن يستقل جهاز القضاء وظيفيا وعضويا، وتعزز مكانته وتصان من كافة أوجه الضغط، أو المساس والخرق، التي قد يتعرض لها كسلطة، أو تنال المشتغلين في نطاقه كأفراد.
لقد أدى التوسع في التجريم إلى الإسراف في استخدام الدعوى الجنائية لتحقيق سلطة الدولة في العقاب، وواكب هذا الإسراف طول الإجراءات الجز ائية من أجل كشف الحقيقة، فأصبحت المعاناة بسبب النظام الجنائي ذات وجهين: وجه عقابي سببه التوسع في التجريم وملامحه تتجلى في العقوبة المقيِّدة للحرية ووجه إجرائي سببه الدعوى الجز ائية بإجراءاتها الطويلة، وملامحها تتجلى في تعريض حرية المتهم للخطر بسبب طول هذه الإجراءات، ومن خلال انتظار المحاكمة الجنائية والفصل فيها(7). كما إن الإسراف في التجريم قد أدى إلى نتائج عكسية، فقد خلق إحساسا اجتماعيا عاما بوطأة تدخل القانون الجنائي في زيادة الأعباء المادية للتجريم، وبعدم الثقة في جدواه، وفشل القضاء الجنائي وحده في مواجهة الظاهرة الإجرامية، وعليه اتجهت السياسة الجنائية إلى ترشيد، أو عدم الإسراف في استخدام قواعد التجريم والعقاب، واتخذ على المستوى الموضوعي شكلين رئيسيين هما الحد من التجريم والحد من العقاب. إن مفهوم العدالة الجنائية مرتبطاً بشكل تقليدي في حالة الاستقرار من جهة، وفي حالة حياد أجهزة الدولة من جهة ثانية، وفي حال ضيق نطاق الجرائم وانحصارها بالأطر الاعتيادية. وهذا يفترض أن تتوفر بيئة آمنة لقيام العدالة الجنائية التقليدية، أي الانطلاق من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يمكن اختصاره تجاوزاً بعبارة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، والاتكاء على استقلال المؤسسة القضائية وحيادها، بما يوفر حماية حقوق الإنسان الأساسية، خصوصا التقاضي على درجات، والاستناد إلى مبدأ البراءة المفترض بالمتهم وضمان حقوقه بالدفاع المقدّس، وإنفاذ الأحكام جبراً بقوّة القانون وأجهزة الدولة، ومبادئ تقليدية أخرى. ومن التحدّيات الهائلة أيضاً عدم إمكانية محاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات، فالمحاكمات تحتاج كوادر قضائية متخصّصة، وتحتاج مرافق لدعم عمليات التقاضي من قاعات محاكم وسجون وجهاز شرطة مؤهل، كما تحتاج أدلّة متوافقة مع المعايير القانونية، وتأخذ المحاكمات أوقاتاً معتبرة من الزمن، وهذا كلّه يحتاج الإعداد والتمويل والتأهيل والتدريب. كذلك فإن الدول الغارقة في أو التي تخرج من النزاعات نادراً ما تتوفر لديها القدرات المحلية أو الموارد الكافية من أجل الاضطلاع بعمليات ملاحقة جنائية معقدة في جرائم دولية. حتى في حال توفر الإرادة السياسية لمحاكمة الجناة في هذه القضايا، فقد يتطلب الأمر تفعيل تشريعات تكون الأساس القانوني للملاحقات الجنائية، مع توفر عامِلين يكلفون ويدربون من أجل الملاحقات الجنائية، وحماية شهود وإجراءات دعم، وجمع أدلة وتحريات. وقد تحتاج الشرطة ونظم السجون أيضاً إلى إصلاحات مؤسسية كبيرة. كما قد يكون صعباً الاضطلاع بمداولات عادلة في هذه القضايا إذا كان نظام العدالة ذاته غير قادر على العمل بشكل ذات صدقية. من ثم فإن الملاحقات الجنائية الفعالة والعادلة على الجرائم الكبرى في القانون الدولي قد تعتمد على قدرات نظام العدالة الجنائية بشكل عام. الحق أن الإصلاحات المطلوبة لعدالة وكفاءة هذه المداولات ستكون ذات آثار كبرى على قطاع العدالة بالكامل ولا يمكن أن يُنظر إليها أو أن يتم التعامل معها بصفتها منعزلة عن الصورة الكبيرة. في فترات ما بعد النزاع، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تلعب دوراً مهماً.
كما أن الجرائم الجسيمة قد تحدث في حال انهيار سيادة القانون أثناء الفترات الانتقالية العنيفة. إن ضمان العدالة الحقيقية والمحايدة في أعقاب الأزمة التي تعقب الحرب إذن أمر لا غنى عنه. في مثل هذه الظروف يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتبوأ مكانة الجهة القضائية المستقلة والمحايدة القادرة على التحقيق، والتي يرجح أن تردع وقوع المزيد من الجرائم الجسيمة، وأن تتعرف على الجناة الرئيسيين وتوجه إليهم الاتهامات بغض النظر عن رأيها في النزاع السياسي. بالإضافة إلى الملاحقات الجنائية في المحكمة الجنائية الدولية ، فإن بعض فئات الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والتعذيب، تخضع إلى “الولاية القضائية العالمية”. يشتمل هذا الأمر على توفر سلطة قانونية لنظم القضاء الوطنية بالتحقيق والملاحقة القضائية في بعض الجرائم، حتى إن لم تكن قد وقعت على أراضي الدولة، أو من قبل رعاياها أو ضد رعاياها. بعض المعاهدات، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب، تُلزم الدول الأطراف بتسليم أو مقاضاة المشتبهين على أراضي الدولة أو الخاضعين لولايتها بشكل آخر.
———————————————
1- د. فتحي السيد لاشين، التأخير في البت في النزاعات وتداعياته الاجتماعية، ضمن كتاب: أبحاث المؤتمر الدولي القضاء والعدالة 1/339 وما بعدها.
2- د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية، ، ص 54..
3- د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية، المرجع السابق، ص 291.
4- هناك فرق بين تخصص القضاء ومبدأ تخصيص القضاء، ذلك أن تخصص القضاء هو عنصر من عناصر استقلال القضاء والذي يعني حصر ولاية الفصل في القضاء برجال مؤهلين قانونا ولهم الكفاءة والقدرة والتفرغ لأداء هذا العمل، أما تخصيص القضاء فيعني تقييد القاضي أو المحكمة بالنظر في نوع معين من القضايا المدنية أو الجزائية أو التجارية، فاروق الكيلاني ، ص 26.
5- أحمد بن عبد االله بن محمد الرضوي ، تخصص القاضي الجنائي و أثره في التفريد القضائي للعقوبة التعزيرية ،رسالة ماجستير في مكافحة الجريمة ، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، 1997 ، ص147-148.
6- عبد الرحمن خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن ,حق المتهم في المحاكمة خلال آجال معقولة، ص98.
7- احمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، ص06.