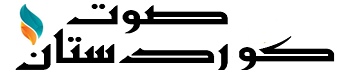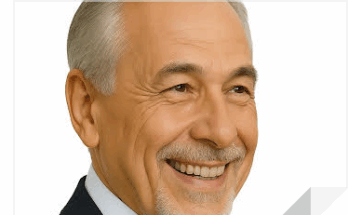الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا, وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصداً يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع. النظرة المتأنية الموضوعية لواقع عالمنا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تؤكد أن معظم شعوب الارض ودوله في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، ما زالت تعيش تحت تأثير صدمة انهيار الثنائية القطبية التي أدت الى انهيار كل أشكال التوازنات الدولية التي سادت إبان المرحلة السابقة من ناحية، وما تلاها من انهيار البنية السياسية/ الاقتصادية في تلك الدول، بعد ان استولت الشرائح البيروقراطية المدنية والعسكرية على مقدراتها الداخلية من ناحية ثانية، وهي تحولات عززت احادية الهيمنة الامريكية / الاوروبية على هذا الكوكب، بعيدا عن ميثاق الامم المتحدة، أو مرحلة الحرب الباردة التي فرضت على الجميع آنذاك الاحتكام الى نصوص وقواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته شعوب العالم كله على أثر الحرب العالمية الثانية ، والذي نص في ديباجته “إن شعوب العالم قد قررت ضرورة إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب ، والعمل على إيجاد نظام أمن جماعي يحفظ السلم العالمي، ويؤسس لتنظيم دولي أكثر إحكاما وأكثر عدالة في المستقبل ، وأن ذلك يتحقق عن طريق تحريم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة” . لقد أدى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة من مضامينه التي أجمعت عليها دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية على أثر هزيمة النازية ، إلى أن أصبحت الأمم المتحدة غير قادرة على ممارسة دورها السابق الذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح الأمريكية ورؤيتها السياسية ، يشهد على ذلك مواقف الامين العام للامم المتحدة ، من معظم القضايا المطروحة في المحافل الدولية، خاصة ما يتعلق بدول العالم الثالث عموما والقضية الفلسطينية والعراق خصوصا، وليس لذلك في تقديرنا سوى تفسير واحد ، هو مدى تحكم الولايات المتحدة في إدارة المنظمة الدولية وأمينها العام من جهة ، ومدى خضوع الانظمة الحاكمة – عبر المصالح الطبقية – للسياسات الامريكية في المشهد العالمي الراهن الذي بات يجسد التعبير الأمثل عن تحول مسار العلاقات الدولية بعيدا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، الى قواعد استخدام القوة العسكرية لتطبيق شروط وسياسات النظام الرأسمالي المعولم ، واستفراده في الظروف والمتغيرات الراهنة ، التي حولت –وستحول- أقاليم عديدة في العالم الى مسارح مضطربة مفتوحة على كل الاحتمالات ، أدخلت العلاقات الدولية في حالة من الفوضى المنظمة ، بحيث أصبحت هذه العلاقات محكومة لظاهرة الهيمنة الأمريكية المعولمة، أو لهذا الفراغ أو الانهيار في التوازن الدولي الذي أدى الى بروز معطيات جديدة في عالمنا المعاصر .لقد شكل مبدأ تحريم استخدام القوة أحد أهم إنجازات القانون الدولي في القرن العشرين ، حسب النص الصريح لميثاق الأمم المتحدة-الفقرة الرابعة من المادة الثانية التي أكدت على “تحريم استخدام القوة، أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”. فمنذ عام 1990 ، شهد العالم متغيرات نوعية متسارعة ، انتقلت البشرية فيها من مرحلة الاستقرار العام المحكوم بقوانين وتوازنات الحرب الباردة ، الى مرحلة جديدة اتسمت بتوسع وانفلات الهيمنة الأمريكية للسيطرة على مقدرات البشرية ، وإخضاع الشعوب الفقيرة منها ، لمزيد من التبعية والحرمان والفقر والتخلف والتهميش، كما جرى في العديد من بلدان اسيا وافريقيا وفي بلدان وطننا العربي عموما والعراق وفلسطين خصوصا ، فقد تم إسقاط العديد من القواعد المستقرة في إدارة العلاقات الدولية ، بدءا من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى ، وصولا الى تفريغ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من مضامينهما الموضوعية الحيادية، يشهد على ذلك عجز “الأمم المتحدة” عن وقف العدوان والتدمير الأمريكي الصهيوني في العراق وفلسطين وسوريا واليمن ، في مقابل تواطؤ وخضوع الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان للهيمنة والتفرد الأمريكي في رسم وإدارة سياسات ومصالح العولمة الرأسمالية في معظم أرجاء العالم ، وفي بلداننا العربية و الشرق ألاوسط خصوصاً، في محاولة يائسة لإعادة ترتيب المنطقة الشرق أوسطية وتفكيكها وإخضاعها بصورة غير مسبوقة للسيطرة الأمريكية، عبر دور متجدد تقوم به دولة العدو الإسرائيلي في محاولتها لضرب وتصفية قوى المقاومة في فلسطين ولبنان بصورة بربرية، لم تستطع معها إسقاط رايات المقاومة التي استطاعت إثبات وجودها وصمودها وتوجيه ضرباتها إلى قلب دولة العدو الإسرائيلي، وتهديد منشآته ومدنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، ما يشير إلى بداية عهد جديد في هذا الصراع عبر متغيرات نوعية في الأوضاع العربية لصالح قوى التغيير الديمقراطي والمقاومة من ناحية، ومتغيرات نوعية بالنسبة لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي الذي تؤكد المعطيات انه صراع وجودي لا تجدي معه مفاوضات أو حلول “سلمية” من ناحية ثانية. المفهوم الحديث لحقوق الإنسان ، ينطلق من فكرة : أن الدولة عليها مسؤوليات إنسانية تتناول توفير التعليم ، وتلبية الحاجات الاقتصادية وحماية حقوق العامل , وتوفير حد أدنى للأجور ، حمايةً للمصلحة العامة من أنانية الأفراد وتعسفهم، فتضع حداً أدنى للأجور. ويعد تدخل الدولة في الاقتصاد تحولاً في الفكر الرأسمالي والفكر الليبرالي الغربي حيث بدأت الدولة تفرض وجودها , وصارت حقوق الإنسان تعني مطالبة الدولة أن تتدخل بعد أن كانت مطالبة الدولة بأن لا تتدخل ! على الصعيد الاقتصادي بعد عام 1918، ثم تأكدت هذه الفكرة.
وبرز مع الديمقراطية أمرا هاما هو حقوق الإنسان الذي تجسّد تطبيقه تطبيقا بشكل حقيقي باحترام الحريات العامة. فحقوق الإنسان مثل الحق في التعبير والفكر والمعتقد والاختيار واحترام كرامته… يدخل في صلب مفهوم الديمقراطية. وتطبيق الديمقراطية هو الذي ارسى بشكل أساسي في تلك الحقوق، وتحويلها إلى قوانين مؤسسية يتمتع بها جميع المواطنين في أي مجتمع ديمقراطي، من خلال تأكيدها وفي باب خاص في جميع الدساتير الديمقراطية التي تنظم المجتمع وتفصل سلطاته وتعطي لكل فرد حقه وكيفية ممارسته وفق القانون ,احتلت النصوص الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية موقع الصدارة فى الإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وأفردت الدساتير فى الدول الديمقراطية نصوصا قاطعة لا تحتمل اللبس أو التأويل لتعريف هذه الحقوق والحريات بمختلف تجلياتها الفردية والإجتماعية. بل إن بعضا من هذه الدساتير أسبغ على هذه النصوص صفة السمو الموضوعى والشكلى معا بترقيتها الى مستوى ” المبادىء فوق الدستورية ” أو الحقوق الأزلية غير القابلة للتصرف ، والتى لا يجوز تعديلها فى أى تشريع دستورى لاحق. أي ان الحرية هي احترام القوانين في الانظمة الديمقراطية .وقد عززت الديمقراطية من دور الفرد في المجتمع الحديث، وأصبح الركيزة التي يقوم عليها وعليها يتم قياس تطوره وتقدمه. حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ماله وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف. هذا، وقد أرست المجتمعات الليبرالية اليوم مجموعة من الحقوق الكونية التي اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة وسطرتها في مواثيق تشريعية مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإنسانية سيدت الإنسان وجعلته فوقكل المصالح، كما دافعت عن كرامته وطبيعته البشرية تشجيع المبادرات الفردية التي فيها مصلحة للجماعة والوطن والأمة، يقول كلاباريد في هذا الصدد:” علينا في المجتمع الديمقراطي السليم أن نفسح أوسع مجال ممكن للمبادرات الفردية، بحيث تبقى وتستمر وحدها، تلك المبادرات التي يثبت بالتجربة أنها نافعة للجماعة. إن أي قيد نقيد به النشاط الفردي الحر يضعف فرص الاكتشاف ,فقد حررت الانسان من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، قد تصل في بعض الأحيان إلى العبودية, وتحرر من السلطة السياسية القمعية التي صادرت حقوق الأفراد في التعبير أو المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وغيرها، ناهيك عن الممارسات التي تمتهن إنسانية الفرد وكرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تتدخل حتى في طريقة تفكيره وتحضر على كل فرد تبني افكار تتعارض مع نهجها ، ولا يستطيع الفكاك منها أو توجيه أي نقد لها.
إن حالة التشوه الفكري في مجتمعنا تتبين من خلال الخلل السائد في العلاقات الإنسانية، و هذا ما ينعكس سلبا على كافة العلاقات القائمة في المجتمع و على جميع الأصعدة. إن الفقر بالمفاهيم الإنسانية و الديمقراطية في إيديولوجيات ثقافتنا و مثقفينا أسهم في القفز فوق الإنسان الفرد “المواطن”، فالخطابات السياسية المعاصرة “كمؤشر” لم تعط هذا الفرد أو تؤمّن له ما قالت أنه يستحق من كرامة و رعاية و احترام، الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح” يجب النظر اليهما كمصطلحات سياسيه منفصله ومتميزه”. بينما تهدف الديمقراطيه الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الانسان الى منح القوة الى الافراد . والمشاركة تدفع في اتجاه تكريس الثقافة والممارسة الديمقراطية التي تبقى بحاجة إلى بناء اجتماعي شامل ومتكامل تمتزج فيه الحركة النقابية والحركات الاجتماعية بالمبادرات الفردية والجماعية المنظمة و الفاعلة، سلوكا وممارسة في الحياة العامة. ونقصد بالمشاركة في الحياة العامة، مساهمة الأفراد في تدبير شؤونهم وإبداء الرأي حولها، والقيام بالمبادرات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة سواءا محليا أووطنيا. وحق المشاركة يندرج ضمن الحريات السياسية الأساسية، غير أن هذا المفهوم، يتجاوز كون أن المشاركة هي مجرد حق، بل هي ممارسة فعلية وثقافة حقيقية في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش المؤديتين إلى عدم الاهتمام بالامور العامة من قبل الافراد، وهو ما يفرض حاجة تثبيتها بكل المجتمعات من خلال تربية النشء على الديمقراطية على أسس التكوين والتأطير والتعبئة والانخراط، باعتبار أن قوة الديمقراطية تكمن في إرادة المواطنين للمساهمة في تدبير الحياة العامة، والمشاركة مع الاخرين في التدبير العمومي، واختيار ممثليهم، وتقييم أدائهم، بل ومحاسبتهم سواء خلال طول مسار الولاية وعلى الخصوص عند انتهائها، إما بتجديد الثقة فيهم أو اختيار ممثلين آخرين مكانهم. وهذا ما يصطلح عليه لدى بعض منظري الديمقراطية (بالذهنية الديمقراطية) المقترنة بالتكوين والممارسة السليمة. جاءت الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها أغلب الدول النامية في عصرنا الحاضر مشوبة بالكثير من أوجه النقص والإختزال والتضييق لمجالات التمتع بالحريات الأساسية والحقوق المدنية ، وقد تجلى ذلك فى إحالة العديد من النصوص المتصلة بها الى المشرّع القانوني بدعوى تحديدها أوتنظيمها ، على الرغم من كونها حقوقا أصلية سامية لا يجوز رهنها بتوجهات السلطتين التشريعية والتنفيذية . كما تجلى ذلك أيضا فى تقييد هذه الحريات والحقوق بإشتراط توافقها مع عبارات من قبيل قيم المجتمع و المصلحة العامة و سلامة البناء الوطنى و الأمن القومي, دون تعريف أو تحديد للمقصود بتلك العبارات المطلقة التى استخدمت فى تبرير الإنتقاص من حرية الإنسان والإفتئات على حقوق المواطنة وفضلا عن ذلك ، فقد تخلّف المشرّع الدستورى عن مواكبة التطور المتلاحق للمبادىء والأحكام والمعايير الدولية المتصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية ، كما تجاهل الكثير من إلتزامات الدولة بموجب المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التى صادقت عليها فى هذا الشأن ، وذلك على الرغم من أن هذه الإلتزامات تعلو على ما عداها فى التشريعات الوطنية.