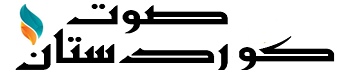في عالمٍ يموج بين أمواج الآمال والظلمات، يقف العرب السُنة اليوم على مفترق طرق تاريخيّ يحمل في طياته مفهومات المسؤولية وجوهر الهوية. إذ تتساءل النفوس: هل ستكون سوريا جنة المواطنة المتساوية أم ميداناً لحروب أهلية لا تنتهي؟ ففي قلب هذا التساؤل تنبعث أنوار براغماتية تعلن رفض الوهم الخادع لإقامة دولة إسلامية، وفي آنٍ واحد تفتح باب السلام لمن لا يرغبون في استنساخ معارك أحمد الشرع ضد الكورد، تلك الحرب التي تُثار مع ظلال نظام قوات سوريا الديمقراطية.
يتجلّى هذا الصراع في فكرة قد تبدو مستحيلة للوهلة الأولى، وهي إقامة حكمٍ لا مركزيّ أثنولوجرافيّ في شمال شرق سوريا، حيث يتسنى للقوات المحلية أن تصبح جزءاً من منظومة دفاعية وطنية تحت إشراف وزارة الدفاع، لتعمل في مناطق طالما شوه فيها مصطلح “فدرالية” بمعانيه البالية. إنها محاولة لإعادة صياغة النظام، بناءً على خبرات عقدٍ من الزمن في معارك الإرهاب ودروس مريرة من تجارب الماضي.
وقد جاءت الزيارات الثنائية التي قام بها أحمد الشرع في جولة متوازية بين الرياض وأنقرة بمثابة رسالة سياسية سامية؛ رسالة تحمل في طياتها إشارة إلى ميله نحو تصحيح أخطاء النظام السابق، واسترجاع الثقة من الحاضنة العربية التي تجسّدها المملكة السعودية.
ففي تلك الزيارات، لم يكن الهدف مجرد تبادل التحيات الرسمية، بل كان بمثابة محاولة لبناء جسر من الدعم العربي، يستند إلى وُعَد الاعانات المالية الكبيرة التي تحتاجها دمشق لتحقيق استقرارٍ اقتصاديّ وسياسيّ في آن واحد. وقد أسهمت مبادرات مصر والإمارات في إظهار مرونة سياسية تضع سوريا في حضن العرب، فيما تبنت أنقرة توجهات تبحث عن وكلاء داخل الأراضي السورية، رغم أن هذه الخطوة جاءت بمزيجٍ من التحفظ والانتقاص من قيم الحرية والعدالة التي يتوق إليها الشعب.
وهنا تتجلى مفارقات النظام الإقليمي الجديد الذي يقوده السعوديون، في مواجهة النظام القديم الذي جسّدته إيران وتركيا، حيث يزداد دور السعودية قوة مع ارتفاع أسهمها في رسم مستقبل سوريا، بينما تواجه أنقرة تحديات عدة في سبيل إيجاد موطئ قدم في المشهد السوري، لا سيما في ظل مشكلات الوجود الكوردي والحقوق التي يطالب بها السكان في الشمال. فتركيا، التي تحاول إعادة رسم حدود النفوذ من بحر المتوسط إلى المالكية (ديركا حمكو Derik)، تفرض شروطاً صارمة رغم تناقض خطابها السياسي الذي يدعو للتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية، فيما تستمر عمليات القصف التي تشوه معالم الحياة اليومية في المناطق المُعذبة.
وفي قلب هذا الانقسام الإقليمي تنبع أسئلة جوهرية حول مشروعية الحكم وسلطة الشرعية، إذ يتردد صدى القول بأن الشرعية ليست هبة تُمنح من الخارج، بل هي مبدأ ينبع من استجابة الشعب لتطلعاته. ومن هنا تبرز ضرورة أن يُعاد بناء الدولة على أسس ديمقراطية حضارية تحترم تنوع المكونات، فسواء كان المطلب إقامة دولة إسلامية أو دستوراً مستنداً إلى الشريعة، يجب أن يكون لكل مواطن نصيب في رسم معالم الهوية الوطنية السورية، التي هي في الأصل فسيفساء عرقية وثقافية تضم مسيحيين ومسلمين ودرزيين وعلويين وأيزيديين، وغيرهم من الطوائف التي لطالما سُخّرت لأهداف ضيقة.
إن الحل السياسي الذي يُرضي جميع مكونات الشعب السوري لا يكمن في فصل الوجوه عن بعضها، بل في الاعتراف المتبادل بتعددية الهوية؛ إذ يجب أن يتم التفاوض على آليات تمكّن المناطق من إدارة شؤونها بقدر من اللامركزية دون أن تتحول إلى مسرح لانسحاب وحدة الوطن، لتعود بذلك سوريا إلى طبيعتها التي هي وطن واحد يتحد في اختلافه. ولعل التجربة التاريخية تثبت أن الأنظمة التي تستند إلى سلطة مطلقة، مهما بدت شرعية على السطح، لا تدوم أمام طموح الشعوب التي ترفض التهميش والاحتكار، كما حدث في تجارب الماضي التي أسقطت الأنظمة الفاسدة.
وبينما يستمر البحث عن صيغةٍ دستورية تجمع كل الأطياف، تبرز الحاجة إلى مؤتمر وطني عام يشكل ورقةً مرجعية تُعيد للسياق السوري بُعده الحقيقي، بعيداً عن فرضيات خارجية لا تعكس الهموم الداخلية للمواطنين الذين ما زالوا يبحثون عن المفقودين في زنزانات القمع وعن العدالة التي خلّفتها المقابر الجماعية لعهد الأسد. إن إجراء إحصاء حقيقي للنسيج الديموغرافي المتشظي هو خطوةٌ أولى نحو إعادة صياغة معادلة الحكم، حيث يكون البرلمان هو مركز السلطة الحقيقي، وليس المساجد أو التجمعات القبلية التي لطالما خدمت مصالح ضيقة.
ولا يغيب عن الأذهان أن التحديات لن تقتصر على الجانب الداخلي فحسب، بل تمتد لتشمل علاقات الجوار الإقليمي؛ إذ يخشى الجوار العربي وإسرائيل من تكرار تجربة الدول التي سقطت نتيجة لتطبيق نماذج دينية جذرية. وهذا هو السبب في ضرورة أن يلتزم القادة بحكمةٍ بالغة في تحقيق التوازن بين مطالب القوى الخارجية ومصالح الشعب السوري الذي طالما رافقته آلام الحرب والمعاناة.
وفي خضمّ هذه التحديات، يظهر أحمد الشرع كرمزٍ للبراغماتية السياسية، رغم اختلافه عن الخطابات القديمة التي كانت تمجد التحدي العسكري والحروب الانتحارية، فقد تحول حديثه إلى الاقتصاد والتعاون، حتى وإن بدا أن الصورة الاقتصادية للنظام لم تزداد وضوحاً، إذ لا تزال معاناة الشعب تعكس واقعاً معقداً يتطلب يد عون خارجية متوازنة. هنا، لا تُعَدّ السعودية سوى اليد الدافئة التي قد تُمكّن النظام من إعادة ضبط إيقاعاته، في حين تظل تركيا تبحث عن خطوط فاصلة بين دعمها للقوات المسلحة التركية ومطالبها الوطنية في حماية حدودها من طموحات كوردية لا تنفصل عن الهوية الإقليمية.
وأخيراً، وفي مواجهة كل هذه التحديات والتناقضات، تظل الدعوة إلى إعادة رسم مستقبل سوريا قائمة على أسس الاعتراف المتبادل والحوار الشامل، بعيداً عن الانقسامات الطائفية والسياسية التي أودت بمصير العديد من الدول في تاريخ الشرق الأوسط. إنّ الحل الحقيقي يكمن في إنشاء دولة مدنية، تُحرر من قيود الحكم العسكري والسلطة المطلقة التي أدت إلى فشل النظام السابق، وتُعيد إلى السوريين حقهم في تقرير مصيرهم في ظل دستور يضمن المساواة والعدالة، دون أن يُفرض عليه نموذجٌ دينيٌ أو نظامٌ فئوي يحصر حرية التعبير والانتماء.
إنّ الخطاب السياسي اليوم، بكل تناقضاته وأبعاده، يدعو إلى وعي جديد لا يستغرق فقط فترة من أربع إلى خمس سنوات، بل يتطلب عملاً طويل الأمد لبناء دولة شاملة تجمع بين أبناء سوريا كافة في إطار واحدٍ متماسكٍ يعيد للدولة مكانتها الحقيقية في تاريخها العريق. وبينما تبقى الرهانات معلقة على مصراعيها، يكون الاختيار بين طريق السلام الشامل وبين مسارات الانقسام المدمر بيد الشعب السوري، الذي يحلم بأن تكون سوريا وطنًا يجمعها تحت مظلة من المساواة والكرامة والعدالة، بعيدًا عن أن تكون ساحة لعب للأجندات الخارجية ومسرحًا للصراعات الأبدية.
بوتان زيباري
السويد
08.02.2025