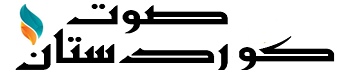في الآونة الأخيرة تزايد الحديث عن أسباب فشل الدولة ككيان مؤسسي وتفتتها الديمغرافية كوضع جغرافي، نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الأمنية في العديد من المناطق والأقاليم. إذن، ما الذي يشير إليه مصطلح “الدولة الفاشلة”؟ وهل المعايير المستخدمة في تحديد درجة فشل دولة معينة فعالة، مقارنة بالعوامل المسببة لهذا الوضع في المقام الأول؟
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية العقد الأخير من القرن الماضي، سادت الفوضى في عدة مناطق من العالم، ردا على انهيار قطب عالمي مقابل صعود آخر في إعادة هيكلة النظام العالمي ما بعد الحرب الباردة، وكانت هناك بعض الدول المعتمدة على الكتلة الشرقية ماديا ودبلوماسيا، فضلا عن العديد من الصراعات التي ظلت عالقة حتى الانهيار والتي أثارت تحركات عسكرية أدت إلى عدم الاستقرار في عدة دول في مناطق مختلفة من العالم.
ومن هنا برز في الأوساط الأكاديمية والسياسية مفهوم “الدولة الفاشلة”، الذي يناقش مدى قدرة الدولة كجسم مؤسسي على القيام بوظائفها الأساسية، مثل: بسط السيطرة على كامل المناطق الجغرافية ضمن سيادتها، تقديم عدد معين من الخدمات لمواطنيها، احتكار وسائل العنف، انسجام المجتمع المكون من شعب هذه الدولة، استقرار وضعها الاقتصادي، وغير ذلك.
وعلى الصعيد الأكاديمي، أشارت الأبحاث التي أجراها ستيفن راتينر وجيرالد هيرمان وويليام زارتمان في تسعينيات القرن الماضي إلى مفهوم الدولة “الفاشلة” أو “المنهارة”، وهو ما أدى إلى نقاش نظري مهم حول مرحلة أو نوع مختلف من الدولة يمكن أن تتعرض له مجتمعات معينة، وهو النقاش الذي يدور اليوم في ظل موجات التوتر العالي التي تشهدها أغلب المناطق الجغرافية في العالم، فضلاً عن الآثار السلبية التي قد تسببها حالات الطوارئ التي قد تسمي الدولة بالفشل، مثل ما نراه من التأثير الهائل الذي خلفه تفشي فيروس كورونا المستجد على أغلب دول العالم.
وفي الممارسة العملية، أطلق «صندوق السلام»، بالشراكة مع مجلة «فورين بوليسي»، في عام 2005 مؤشراً يسعى إلى تصنيف الدول وفق تدرج قياسي من الأكثر فشلاً إلى الأكثر استقراراً، اعتماداً على معايير عدة تحدد موقع الدولة الإجمالي على المؤشر الذي يضم كل دول العالم.
كما هو الحال مع أي ظاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، لا يوجد إجماع حول الأبعاد المفاهيمية لمصطلح “الدولة الفاشلة”، بسبب كثرة الأمثلة التطبيقية والعملية عليه، وتطوره بالتزامن مع الأحداث التي تجري في العديد من البلدان، بالإضافة إلى معالجة المنظرين والمحللين السياسيين لهذا المفهوم من وجهات نظر أيديولوجية وثقافية متباينة، إلا أن البناء المعرفي والتاريخي لمفهوم “الدولة الفاشلة” يركز عموماً على عجز الدولة عن أداء وظيفة أو أكثر من وظائفها تجاه الأدوار العرفية على المستويين الداخلي والخارجي.
إن الدولة، كما هو معروف نظرياً، ترتكز على أربعة عناصر أساسية هي: الأرض، الشعب، السلطة السياسية، والاعتراف الدولي، وإذا أردنا أن ندقق أكثر في العلاقة الجدلية بين هذه العناصر، يمكننا القول إن جوهر الدولة، وشكلها، وعملية بقائها اليومي، وما يرتبط بها من خصائص وسمات تاريخية وبنيوية، كل ذلك يرتكز، إلى حد ما، على تفاعل السلطة السياسية مع العناصر (الركائز) الثلاثة الأخرى.
وبعبارة أخرى، فإن طبيعة العلاقة بين النخبة السياسية وأدواتها المؤسساتية والتيارات الاجتماعية المؤيدة والمعارضة هي التي تضمن أو لا تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهذا ما يشير إلى شرعية النظام السياسي المعني. فوجود إرادة وبرنامج اقتصاديين يؤدي إلى توظيف الإمكانات المادية والمعرفية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد على السطح وفي باطن المنطقة الجغرافية التي تحتضن الدولة، وبالتالي تستطيع الدولة إدارة الملف الاقتصادي وتحديد دور القطاع الخاص فيه. كما أنها السلطة السياسية التي تتعامل مع الشخصيات القانونية على المستوى الدولي (دول، منظمات، أفراد)، كما يعني أن تكون الدولة فاعلاً منفتحاً على جميع الأطراف من خلال الحفاظ على مسافة مماثلة من جميع نظرائها أو أن تكون مؤسساً أو جزءاً من محور له رؤية استراتيجية مختلفة عن الآخر، أو أن تكون معزولة ومنغلقة على نفسها، وتبقي علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية الصالحة في حدها الأدنى.
وبناء على ما تقدم، يمكن التعامل مع “الدول الفاشلة” تقليديا باعتبارها تركز على الدور الوظيفي للسلطة السياسية أكثر من أي عنصر آخر من عناصر الدولة، وذلك من خلال فحص سلوك السلطة تجاه الاستحقاقات المحلية والإقليمية.
وبما أن الدولة جزء من المجتمع الدولي الذي يضم أطرافاً تجمعها مصالح معينة وتفصلها مصالح أخرى، فإن هذه الدولة أو تلك قد تتأثر بحالة الاستقطاب والتجاذبات السياسية التي تشكل سمة عامة تحكم تاريخ العلاقات الدولية منذ تشكل الدول القومية في أوروبا بعد معاهدة “وستفاليا” في منتصف القرن السابع عشر، وهذا قد يدفع الدولة بكل أركانها إلى مواجهة التحديات الخارجية التي قد تترتب عليها بعض التداعيات على مستوى الوضع المحلي، مثل العقوبات الاقتصادية، واستنزاف الموارد، والابتزاز العسكري نتيجة انضمامها إلى محور أو تحالف واحد، سواء اضطرت لذلك أو اختارته بنفسها. وكل هذا يعني أن وظائف القوة السياسية قد تتأثر سلباً بالظروف الخارجية في المقام الأول، مما قد يؤدي بها في نهاية المطاف إلى التحول إلى دولة فاشلة.
كما هو الحال في أي تحليل نظري، هناك بعض الثغرات والتناقضات في مفهوم “الدولة الفاشلة”، ذلك أن المعايير التي تطرحها بعض المؤسسات وبعض المحللين لتصنيف الدول على أنها فاشلة أو مستقرة لا تستند إلى السياق التاريخي الذي تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في ظهور وتطور هذه المعايير، كما أنها لا تفسر لماذا تضم دول العالم الثالث (أفريقيا وأجزاء من أميركا اللاتينية وآسيا) أكبر عدد من الدول الفاشلة، ألا يشير هذا إلى وضع تاريخي مشترك؟
من المهم جداً الحديث عن معايير قياس فشل الدول ضمن مؤشرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية إذا كانت هذه المعايير مبنية على تفسير سببي للأحداث التي تحويها الدول الفردية، حتى وإن كانت تتطلب الإشارة إلى فهم جذور هذه الظاهرة -سلبية كانت أو إيجابية- في الدولة المراد تصنيفها، بما في ذلك مدى التأثير الخارجي على العملية الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير ارتباط النخب السياسية بالجهات الفاعلة الخارجية على الاستقرار السياسي والأمني للمجتمع المعني، فضلاً عن فهم طبيعة العلاقات التجارية والمالية بين الدول، سواء كانت مبنية على أسس المنفعة المتبادلة، أو الاستغلال الأحادي الجانب والتبادل غير المتكافئ.
وهكذا فإن استخدام المعايير ذات المحتوى الكمي (العددي) فقط لن يؤدي إلى توصيف دقيق للدولة المعنية وتصنيفها على جدول الدول الفاشلة، وإنما إلى قراءة تاريخية واجتماعية معمقة لفهم الطبيعة السببية للفشل للتغلب عليه؛ وذلك من خلال آلية توافقية تنشئها المنظمات الدولية ضمن أحكام القانون الدولي.
وفي الختام فإن إدراك الدولة كدولة فاشلة لا يعني بالضرورة أنها تعيش حالة من انعدام الأمن أو الصراع العسكري على شكل حرب أهلية أو حرب بالوكالة أو كليهما، والتي تقوم على الانقسامات العرقية والمناطقية التي تغذيها أطراف إقليمية ودولية، وإن كان هذا هو الإطار العام لوصف الدول في الوقت الحاضر، على الأقل على المستوى الإعلامي، إلا أن هناك معايير أخرى مثل مستويات التنمية الاقتصادية، والتمثيل السياسي والتنظيم، وحجم ومستوى الرفاهة الاجتماعية، وغيرها، وكما ذكرنا آنفاً فإنه من الضروري النظر إلى أسباب هذه المعايير حتى لا يقتصر تعريف الدولة الفاشلة على تعريف فني وإجرائي منفصل عن الواقع.