تأملات في الغياب الإلهي والإنسان المسكون بالمطلق
وكأني أقف إلى جوار الحلاج حين صرخ “أنا الحق” ومزّق الحُجب بين الإنسان والإله، أو كأني أُنصت لابن الراوندي، وهو يُمعن في الشك، لا كمن يهدم، بل كمن يفتّش عن الإله الذي غاب حين حضرت الجريمة، وسكت حين بكت الإنسانية تحت أنقاض المجازر.
أين الله من الدم المسفوك؟ على صفحة كوردستان، وسوريا، والعراق، بل على وجه الشرق الأوسط الجريحة بأسره.
هل خُلق الإنسان ليُلقى في أرضٍ لا تشبه الجنّة إلا في الحكايات؟
أم خُلق ليختبر الحياة في عالمٍ أقرب إلى الجحيم؟
جحيم لا بناره، بل بمآسيه، بأحزانه التي لا تنطفئ، وبمواسم الفقد التي تتكرّر كأنها طقس يومي.
فأي معنى للخلق إذا كانت الأرض التي نُفي إليها تضجّ بالظلم أكثر من الرحمة، وتفيض بالقسوة أكثر من الحنان؟
هل نُسجت فكرة الله على مقاس الخوف، ليَعبد الإنسان ظله المرتجف؟
أم أن الله كما تصوّره العقل البشري، ليس إلا محاولة لتبرير العجز، وتأليه المجهول، وإسقاط الرحمة على وجودٍ غير مُتحقق؟
كما قال دوستويفسكي ذات مرة:
إن لم يكن الله موجودًا، فكل شيء مباح.”
ولكن، إن كان موجودًا، وكل شيء ما يزال مباحًا، فأيُّ صورة هذه عن الله؟ أليس الأسوأ من غيابه هو حضوره بلا فعل؟
إن كان الله عند الإنسان، كاحتمال لا يُطاق، سينطلق السؤال الصارخ:
هل الله جريمة؟
ليست الجريمة في ذاته، بل في صورته التي صاغتها الأديان، حين جعلت منه ديّانًا، ثم صامت حين هُتكت الأعراض، وسُفكت الأرواح، وحُرقت المدن.
الإنسان، في لحظة خوفه القصوى، اخترع الإله، لا ليحب، بل ليخاف، جعل منه قاضيًا، ثم عبد أحكامه، وجعل من الجحيم مرآة لذنوبه، لم يكن الله حضورًا شافيًا، بل رعبًا قادمًا من اللا معلوم.
وها نحن، في هذا العبث، نعيد صياغة الجريمة على هيئة طقس ديني، ونطلب الغفران من غياب لا يستجيب.
إذا كانت قوانين الكون من خلق الله، فهل الجريمة جزء من القانون الإلهي؟
وهل الجريمة مُشفّرة في نسيج الخلق؟
هل الشر ضرورة كونية، أم اختلال في التصميم؟
وإذا كانت “الرحمة” هي صفته الكبرى، فأين تتجلى في طفلة تُذبح، أو أمٍّ تُحتَضَر تحت الأنقاض؟
“إن الشرّ مشكلة منطقية لمن يؤمن بإله كلي القدرة وكلي الرحمة” كما أشار ديفيد هيوم، فكيف تفسر وجود الشر إن لم يكن الله عاجزًا، أو غير مبالٍ، أو أن الصورة التي رسمناها له لا تنتمي للواقع بل للرغبة؟
وحين نسأل، أين الله من كل هذا الدم؟
يجيب المتدين، إنه يختبرنا.
لكن أيُّ إله هذا الذي يختبر أبناءه بالنار؟
وأيّ أبٍ يرضى أن يَشرب أولاده من كأس الموت كي يثبتوا ولاءهم؟
نحن أمام معضلة وجودية أكثر مما هي دينية.
كما قال كامو:
المشكلة الفلسفية الجادة الوحيدة هي الانتحار، الحكم ما إذا كانت الحياة تستحق أن تُعاش أم لا، هو الجواب على الأسئلة الفلسفية.”
وكذلك نقول، المشكلة الإلهية الوحيدة هي العدالة، فإن لم تكن عدالته حاضرة، فما جدوى وجوده؟
نرفع أيدينا نحو السماء، في عالم لا يسمع.
نُصلي لسماءٍ تسبح فيها مجرّات لا تعنينا، وأكوان لا ترى دموعنا.
الله، كما صوّرته الفلسفات، ليس شخصًا في العلو، بل هو سؤال، هو القلق، هو غياب المعنى في مواجهة الألم.
وهنا، تعود الأسئلة القديمة بثياب جديدة:
هل الإله خلقنا أم نحن من خلقنا الإله؟
هل الإيمان به هو خوفنا من العدم؟
هل نعبده لننجو، أم لأننا لا نطيق أن نكون وحدنا في هذا الفراغ المترامي؟
هل الله بريء من الجريمة، أم أنه منطقها الأعلى؟
أم أن الجريمة ليست سوى نتيجة لحرية أُعطيت للإنسان، دون أن تُعطى له أدوات ضبطها؟
في كُنه هذا السؤال، نُدرك حجم المأساة، فإمّا أن الله عاجز، أو أنه لا يبالي، أو أن صورة الله في أذهاننا مشوهة، مفصّلة على مقاس الخوف، وليست انعكاسًا للمطلق.
“السماء لا تهمها دموعنا” كما قال جان بول سارتر، فهل كان على حق حين أعلن:
الإنسان محكوم عليه بالحرية”؟
حرية تؤلمه، لا ترفعه، حرية يصرخ بها وهو يركع لصنم صنعه من رعبه.
ومن على عتبات هذه الحرية أراد الحلاج أن يرى الله في الإنسان، فانتهى على الصليب.
ورأى ابن الراوندي في الله فكرة فاسدة تُستعمل لإرهاب العقل، فصار ملعونًا في كتب التراث.
أما الإنسان المعاصر، فصار بينهما، لا يجرؤ أن يُحب الله كما الحلاج، ولا أن يهدمه كما الراوندي.
وهنا يحضرنا مقولة نيتشه:
لقد مات الله، ونحن من قتلناه.”
لكنه لم يكن احتفالًا، بل رثاءً لعالم فقد حريته ومركزه الأخلاقي، عالم تُرك للضياع دون خريطة.
إننا اليوم نعيش وسط انفجار المعرفة، وانهيار المعنى، لنحكم على سعة وعي الحاضر.
الله لم يمت، بل انسحب، من رؤية منظر شلالات دم الإنسان.
أو ربما تماهى مع صمت الكون، واختبأ في عمق وعينا، في تلك الزاوية حيث لا يدخل الضوء.
لكننا، نحن البشر، لا نزال نحفر في الظلام، نكتب على جدران الكهوف الحديثة أسئلتنا القديمة:
من أنا؟ لماذا أموت؟ وأين هو الله؟”
وكل إجابة محتملة، ليست إلا سؤالًا جديدًا متنكرًا، يوسّع من دوائر الحيرة، ويعمّق ظلال الشك، فكلما اقتربنا من يقينٍ ما، تكشّف عن هشاشته، وكلما نطقنا باسم الله دفاعًا، وجدناه يُستدعى ذريعةً للذبح.
أهي الأسئلة التي تُخطئ؟ أم أن الأجوبة فُصّلت على مقاس القتلة؟
في الشرق الجريح، لا تُطرح الأسئلة بحثًا عن الحقيقة، بل تُكمم حتى لا تُربك الولاءات، وتُدان إن لامست المعنى.
لكن، ماذا لو كان الشك هو بداية الإيمان الحقيقي؟ وماذا لو أن الله، لا يسكن في الفتاوى، بل في صرخة الضحية؟
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
25/3/2025م
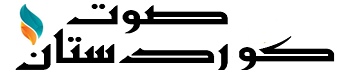

Teve silavên tijî rêz û heskirin ji te ra, mamoste Dr. Mehmûd Abbas
Gotarek pir xweş û rindik e, û tijî pirsên kûr in li ser armanca hebûnê, û deriya tûnebûnê.
Min bi xwe jî pir caran, beşek ji van pirsên jorîn, pirsiye, lê bersivên tekez der-neketin meydanê.
Piştî pejirandina te, mamoste Dr. M. Abbas, ma ez dikanim li bin navî te, vê gotarê û gotarên din yên te .. ?!i
Rêzanê hêja,
Silav û Rîz.
Kêfxweş im ku em li ser van mijarên nakokî li hev dicivin, û em bi hev re li deriyên gumanê bi xwe dixin, cihê ku pirsa rastîn dest pê dike.
Bê şik ti azadi ci gotarên ku li ser rûpela malpera “Dengê Kurdistanê” tê weşandin parve bikin.
Bi hêviyên xweşî û şadî her tim bi were bêt.
D. Mahmud Abbas
اسئلة فلسفية عن الله وعن سلوكه المريب حول صمته إزاء ما يحدث على الأرض من جرائم بحق الإنسانية أعادها الكاتب وكررها في مقالته بصيغ مختلفة، لكنها بقيت تراوح في مكانها ولم تصل بالقاريء إلى نتيجة معينة، وبقي الله في النهاية هو هو ذالك الصامت صمت ابي الهول. ولقد رد الكاتب بنفسه على جميع تلك الأسئلة المتكررة التي اطلقها بصيغ مختلفة بالقول بأن المؤمن بوجود الله قد يرد عليها بعبارة واحدة (ان هذه الحياة ما هي إلا إختبار للانسان). العلم التطبيقي هو وحده قادر على ان يصل بالباحث عن حقيقة، الحقيقة البعيدة عن التهويمات الفلسفة و العاطفية حول وجود الله من عدمه. لا يؤمن بوجود الله الغالبية العظمى من علماء الطبيعة, في فيزياء الكم (quantum physic), علم الاحياء البيولوجي، علم طبقات الأرض، الكيمياء، علم المتحجرات، نظرية النشوء والتطور. العلم الذي يثبت بالأدلة عمر الأرض بانه يعود الى 4600 مليون سنة، وظهرت الحياة عليها بعد 200 مليون سنة من تكوينها، بينما تقول الأديان الابراهيمية ان عمر الأرض مجرد عشرة آلاف سنة منذ خلق ادم، وانها مسطحة، وانها مركز الكون وان الشمس تدور حولها! هل نحتاج بعد معرفتنا هذه الحقائق العلمية ان نلف وندور في حيز فلسفي ضيق عن (الله) الذي اوجدته كهنة الأديان؟
يا د. يا محترم ، دائماً تكتُبْ حَوّلَ التقدم بالعمر و ما غَنمّت من عمرك في هذه الحياة ( وبالطبع كلامك وخبرتك موجهه للجميع ) والآن تكتب حول بعض الأفكار التي تراود المرء خلال اللحظات والأزمات اليومية التي يعيشها ، المُلخص ما أنصحك به ( مع التقدير لك ) بقراءة خطب علي أبن أبي طالب ، أنه يجيب عن كل هذه الأسئلة وغيرها وكتب ( المسيحي بكل فخر ) جورج جرداق ( الله يجازيه خير الجزاء ) وهو أعلم وأرحم الراحمين ، ولاحظ كل من أستندت بأقوالهم ، هم من الأجانب والخواجات وليس من المسلمين وكذلك حتى هولاء من هم فلاسفة ومفكرين كانوا فرداً يكمل فرداً مع غيرهم من الذين تبنوا الأفكار السياسية والأمثلة كثيرة لتضليل الأجيال ( المسلمة ) جيل بعد جيل ……
انتم مرمكم غير ب و عجيب و ما ذنب الله بافعال النسان و لمذا تلومون الله و لمذا لا تلومون المجرمين و الله لم يقل اقتلو البشر لكي يؤمنون بة و الله هو يدافع عن نفسه و هو خقل البشر و الكون و لكن دين الإسلام مشكوك في و كان غزواتهم من أجل المال و هم قامو بغزوات على الشعوب غير عربي و اخذو الموالهم و النساء و الفتيات و دليل موجود في القرآن و الله لم يقل لانبيا اقتلو البشر و لكن العرب فعلو هذا بسم الله و لكم سلام