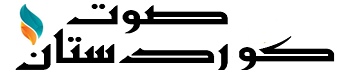لم تكن الثورة السورية مجرّد احتجاج شعبي ضد استبداد عمره عقود، بل كانت انفجاراً سياسياً واجتماعياً لأمة ظلت مقموعة تحت قبضة حكم الفرد الواحد منذ ولادة الدولة الحديثة. فمنذ تأسيس الجمهورية السورية بعد الاستقلال عام 1946، سُلب القرار من يد الشعب وتحوّلت الدولة إلى حلبة صراع بين الانقلابات والنخب العسكرية، قبل أن يستقر الحكم بيد حزب البعث عام 1963، ومن ثمّ يتحول إلى نظام العائلة الأمنية بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970.
خمسون عامًا من الاستبداد السياسي وتكميم الأفواه، أقام خلالها البعث دولة أمنية مغلقة، قائمة على قمع التنوع، واستبعاد كل من لا يدخل في إطار الهوية الرسمية المفروضة. الكرد، السريان، العلويون والدروز كانوا حاضرين في الجغرافيا وغائبين في السياسة، مهمّشين في الثقافة وممنوعين من التعبير، حتى جاءت لحظة 2011، لتفتح جراحًا دفينة وتكشف هشاشة ما سُمّي بالجمهورية السورية.
منذ اندلاع الثورة، دخلت البلاد في فوضى مركبة، تداخل فيها المحلي بالإقليمي، والديني بالسياسي، والدولي بالاقتصادي. تفكّكت مؤسسات الدولة تدريجياً، وانهار الخطاب الوطني الجامع، بينما تقاطرت قوى دولية وإقليمية إلى الساحة السورية: إيران وتركيا وروسيا وأمريكا، وكل منها يحمل مشروعه الخاص ويبحث عن وكلائه المحليين.
هذا التدويل لم يكن فقط سببًا في استمرار الحرب، بل خلق واقعًا جديدًا عنوانه “تقاسم النفوذ”، حيث تحوّلت سوريا إلى أرخبيل من القوى المتضادة. وفِي ظلّ هذا المشهد، تحوّلت دمشق من عاصمة مركزية إلى مجرد طرف ضمن شبكة مصالح إقليمية ودولية، تتنازع على القرار والسيادة والثروات.
ثم جاءت عقوبات “قانون قيصر” لتزيد من خنق الاقتصاد المنهك أصلًا، وتضرب الفئات الأكثر فقرًا وعزلة. الهدف المعلن للعقوبات كان ضرب المنظومة الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالنظام، لكن الواقع أن العقوبات عمّقت الانهيار المالي، وأطلقت موجات جوع وفقر وهجرة، لم يسلم منها أي مكوّن، وجعلت من “الاقتصاد السوري” كيانًا هشًا على حافة الانهيار الدائم، مرتبطًا فقط بشبكات التهريب والمساعدات الدولية.
في ظل هذه الفوضى، شهدت البلاد ما يشبه الزلزال السياسي في ديسمبر 2024، عندما فرّ بشار الأسد إلى خارج البلاد بعد اتفاق غامض، تاركًا خلفه دولة خاوية. صعدت هيئة تحرير الشام إلى واجهة المشهد، واستقرت في دمشق بقوة الأمر الواقع، مدفوعة بتفاهمات إقليمية غير معلنة، وبقايا شبكة النفوذ التي بنتها في شمال غرب البلاد. وهكذا، انتقلنا من حكم الفرد الأمني إلى شبح “الدولة الدينية”، بلباس مختلف وأدوات جديدة، لكن بذات الذهنية الإقصائية.⸻
ما سُمي بـ”الحوار الوطني” الذي أطلقته القيادة الجديدة في دمشق لم يكن إلا تكرارًا لنهج التهميش. إذ تم استبعاد الكرد بشكل مباشر، وكذلك العلويين والدروز والسريان، وكأن النظام الجديد يريد بناء “سوريا سنية محافظة” على أنقاض “سوريا البعث”، متجاهلًا أن التعدد هو جوهر هذه البلاد، وأن أي مشروع إقصائي لا يمكن أن يعيش.
الكرد الذين حملوا على عاتقهم مقاومة داعش، والذين حافظوا على نموذج حكم مدني وديمقراطي في شمال شرق سوريا، لم يُدعوا إلى الطاولة. بل على العكس، جُوبه مشروعهم بالتشكيك والعداء، رغم أن الإدارة الذاتية أثبتت مرونة سياسية نادرة، وقدرة على الصمود رغم الحصار والتهميش.
رسالة عبد الله أوجلان التاريخية التي دعا فيها إلى حل سلمي وديمقراطي، شكلت بوصلة سياسية لهذه المرحلة، فيما أثبتت قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة مظلوم عبدي، أنها القوة الوحيدة التي استطاعت هزيمة الإرهاب دون أن تتحول إلى قوة طائفية أو دينية، بل دافعت عن كل السوريين، بصرف النظر عن الدين أو القومية.
الواقع السوري لا يمكن فصله عن المشهد الدولي المتغيّر. الحرب الروسية الأوكرانية أطلقت سلسلة من التحولات الاقتصادية والسياسية، أدت إلى اضطراب النظام العالمي، ودفعت بموسكو إلى تقليص نفوذها في سوريا. في الوقت نفسه، أدى التصعيد المتواصل في مضيق تايوان إلى تركيز واشنطن على الصين، مما قلّص اهتمامها النسبي بالملف السوري، رغم أن وجودها العسكري ما زال حاضرًا في الشرق.
ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يلوح في الأفق احتمال إعادة ترتيب التحالفات، وتقديم دعم غير مباشر للقوى التي يرى فيها “استقراراً مؤقتًا”، حتى وإن كانت تفتقر للديمقراطية. وهذا يعني أن الكرد قد يجدون أنفسهم من جديد في لحظة اختبار صعبة: إما الصمود كقوة سياسية ذات مشروع وطني واضح، أو العودة إلى حالة الدفاع عن الذات في ظل صفقات الكبار.
في هذا السياق، يواجه العلويون معضلة وجودية، فقد ارتبطت هويتهم السياسية بالنظام السابق، والآن يواجهون فراغًا قاتلًا. هل سيُدمجون في الدولة الدينية الناشئة؟ أم سيُقصون كما أقصي الكرد والسريان؟ أما الدروز، فقلقهم أكبر من مجرد هوية سياسية، بل وجودية، وسط ضغوط متصاعدة من الجنوب، ومشاريع اختراق من قوى خارجية.
والمسيحيون، الذين كانوا في الخطوط الخلفية خلال العقد الأخير، يعودون إلى الواجهة كمكوّن أصيل، يبحث عن ضمانات بعد أن فُقدت كل المرجعيات.
أما إسرائيل، فهي اليوم القوة العسكرية المهيمنة في المنطقة، تنسق مع روسيا وأمريكا، وتضرب في العمق السوري متى شاءت، وتفرض وقائع سياسية بقوة الردع، خاصة في الجنوب والبوكمال. وبينما تنشغل إيران بمواجهة التآكل الداخلي، تتراجع مشاريعها في المنطقة، مما يمنح تل أبيب مجالًا أوسع للحركة.
في خضمّ هذا الركام، تظلّ “روجافا” نموذجًا فريدًا، ليس لأنها بلا أخطاء، بل لأنها الوحيدة التي ما زالت تملك مشروعًا سياسيًا واضحًا، يربط بين الديمقراطية واللامركزية، بين احترام الهوية والانفتاح على الآخر. مشروع قد لا يكون مثاليًا، لكنه قابل للتطور، وقادر على أن يشكل نواة لسوريا جديدة، إذا ما توفرت الإرادة.
المعركة اليوم لم تعد فقط على السلطة، بل على شكل الدولة وهويتها. فهل نعيد إنتاج الاستبداد هذه المرة بلحية وراية دينية؟ أم نكسر الحلقة الجهنمية ونعيد تعريف الوطنية على أساس التعدد والعدالة؟
المستقبل لم يُكتب بعد، لكن المؤشرات واضحة: سوريا إمّا أن تكون وطنًا لكلّ مكوناتها، أو ساحة لصراعات مستمرة بلا أفق. والكرد، كما كانوا دائمًا، ليسوا مجرد ضحية أو حليف، بل طرفٌ محوريّ في إعادة صياغة العقد السوري.
إنها لحظة الحقيقة، وما بين رماد البعث وظلّ العمامة، تلوح فرصة لبناء وطن جديد… إذا ما امتلكنا الجرأة الكافية.
أزاد فتحي خليل
كاتب وباحث سياسي