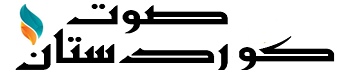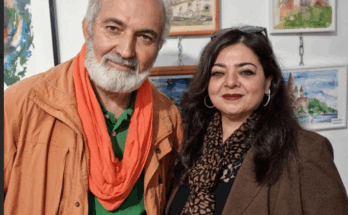“الملائكة لا تحيا طويلاً” لهند البكاي لهبيل… صوت قادم من الموت
لم يكن صدور هذا العمل عن دار ‘الآن ناشرون وموزعون’ في الأردن، بعد أعوام من رحيلها عام 2015 عن عمرٍ ناهز الحادية والثلاثين، مجرد حدثٍ عابر. كانت هذه الولادة المتأخرة لما كتبته هند البكاي لهبيل في لحظات الاحتضار بمثابة وثيقة شخصية وسياسية، وصرخة إنسانية واعية، امتزج فيها صوت الكاتبة بصوت المريضة في لحظة مواجهة حاسمة مع الحياة. جاء هذا الإصدار بتقديم من الباحثة والإعلامية هدى البكاي لهبيل، شقيقة الراحلة، التي جمعت النصوص وقدّمتها بمحبّة ووجعٍ نبيل، وبحسٍّ شعري ينسجم مع نبض النصوص.
وبينما يستحضر العنوان “الملائكة لا تحيا طويلاً”، الذات ككائن هشّ وملائكي في عالم مفترس، فإنه يكشف البعد الرمزي للموت السريع للجمال في هذا العالم، ومن هنا يتحول اللعب على الغياب من البعد الشخصي للمرض الذي هدد جسد هند – البيت الفيزيائي، إلى البعد العام حيث الحب، والجمال، والحياة، وفلسطين بيوت رمزية مهددة دائمًا بالحرب والخذلان. وبالتالي، فهي تكتب الجرح لا عنه، وتجعل من المعاناة الجسدية مرآة للمعاناة الجماعية.
البيت كما تكتبه هند يمثِّل ذاكرة حية وحميمية، ومنفى للذاتين الخاصة والجمعية، وزمن مفقود، والأهم من ذلك، أنه فضاء هجين وأرض للتحولات. وإذ يشكِّل الجسد والوطن والحب بيوتًا هشةً في عالمنا العربي، تتحول اللغة لديها إلى مأوى، والكتابة إلى فضاء للحماية والمواجهة وإعادة الاعتراف.
الحب والحرب: تقاطعات الكتابة والمأساة
تصف هدى البكاي لهبيل، شقيقة الشاعرة، هذا العمل الذي يحمل أكثر من ثلاثين قصيدة، بكونه “خريطة لعالم الشاعرة الداخلي”، وهذا صحيح إلى حد بعيد. لكنه أيضًا خريطة لجغرافيا الألم العربي، لتلك المسافة بين الأرض والجسد، بين فلسطين والمغرب، بين الخيمة والبيت، وبين الحياة والموت.
يتبدى من النصوص التي تتوزع على موضوعات تتعلّق بـالوطن، المرأة، الحب، الحرب، وفلسطين، ذلك الحس العميق بالتشظي، فالذات الكاتبة هنا ليست منعزلة عن عالمها، بل تنغمس في مآسيها، ترفض الصمت أو التواطؤ. ففي قصيدتها “وصية لسكان العراء”، نلمس خطابًا رثائيًا سياسياً حيث تتداخل الأبجدية مع فكرة الغدر الاستعماري، وتتداخل مع مأساة النزوح العربي. تكتب هند: “يا إخوتي يا سكان العراء/ نحن اخترعنا الأبجدية/ ليغتالها القادمون من الشمال/ فلا السين سين سلام/ ولا راء الشرق راء”. توظف هند تفكيك الأبجدية كأداة شعرية فاعلة للتعبير عن انهيار المعاني أمام الفقد، فالحرب لا تقتل الإنسان فقط، بل تقتل اللغة ذاتها، وتقلب حروفها، وتحوّل “السين” من “سلام” إلى “سيف”. هذه المفارقة الدامية بين الحرف كرمز حضاري، وبين انتهاكه، تعكس رؤيتها للكتابة حيث تصبح الكلمة المهددَة وسيلة للدفاع عن الذات، وتكشف عن الوجه الحقيقي للسلام الذي يجتاح وجه العالم لكنه يحمل وجه الحرب، ما يكشف بدوره مشهدية سياسية وديموقراطية مريضة وعولمة وحشية: “يريدون أن يعطوك شبرا من الأرض/ وعلمًا/ ويعلقوا على صدرك شارات السلام”؛ هؤلاء أنفسهم الذين تقول الشاعرة أنهم “صلبوا المسيح مرتين“.
تبني هذه الدوال تناصَّات قوية في ظل حضور القضية الفلسطينية بقوة في قصائد مثل “كلنا ياسر” و “طفل الحجارة”، حيث تمتزج صورة الطفل المقاوم بتمثلات الأمل والموت معًا، ويصبح الطفل الفلسطيني، ليس فقط رمزاً للنضال، بل لحلم الشاعرة الذي لم يكتمل: “يا طفل الحجارة/ يا أمل الضائعين/ يا أمل المُبعثَرين”، ” في يدي حجارة ستحرر البيت، المرافئ/ والمحارة”، حيث تتجلى فلسطين، التي خصصت لها هند القسم الأول، كمرآة للمأساة العربية الكبرى “منذ صرنا وصار الوطن/ حكاية/ خرافة” أسقطت من جيوبها ما علمتنا إياه الأساطير من “أن أجدادنا قالوا شعرهم هنا … / عرفوا الله هنا، عرفوا الحب هنا./ عرفوا الشمس هنا“.
يستشرف هذا العمل المستقبل كما لو كانت غلالة شفافة تفصل هذه الروح الشفافة والعذبة عن القادم: “حينئذ سنغير مناسك الحج/ من طواف/ إلى رقص على إيقاع … فماذا لو علقوا راياتهم على قبر محمد …”. هذه الرؤيوية، التي تنكشف بلا مواربة، ترفع هذه النصوص إلى الوظيفة الأسمى للشعر؛ الكشف؟
البيت كزمن ضائع
تتوزع مفردات الغياب في هذا العمل كخريطة للتظهير والكشف والاستحضار القسري لكل ما يتم محوه، “قبل أن يستسلم نيسان للحزن”، أي قبل أن يتحول البيت الجسد والوطن إلى ماضٍ لا يُستعاد، وإلى نوستالجيا موجعة عبر اللغة، فنحن لا نخسر – حين يُفقد البيت (بالهجرة، الحرب، المرض، الاحتلال، الموت)، المكان فقط، بل جزءً من الذات. وبهذا، يصبح “البيت” يصبح رمزًا للاغتراب، أو رمزًا للجسد حين يمرض، أو للهوية حين تُنتزع. “يا قاتلي أمهلني/ من الوقت القليل/ كي أتذكر وجه أمي وملامح المدينة/ صوتها/ صمتها/ أحلام الأزقة/ أحزان الدروب/ ضجة أطفال يطاردون/ طائرة ورقية/ طائرة وهمية”. فالبيت هنا هو المدينة، الأم، اللغة، الحنين، الطفولة، وكلها خيوط تتقطع حين يُفقد البيت
اللجوء إلى مكان خارج الوطن للعلاج يستحضر رمزيًا المنفى كبيت يحمل شاهدة للموت، ففي المنفى يرفض الآخر الهوية الفلسطينية وينكرها “أزعجه منظري/ عباءتي … عقالي/ والكوفية … لون البشرة الحنطي والملامح الشرقية/ حدق بي مليًا/ ثم رمى بجوازي على الأرض/ وقال أنت لا توجد يا فتي”. هنا توظف الشاعرة الفعل المضارع الإثنيethnographic present بكل حمولته السلطوية والإيديولوجية لإعطاء صفة الاستمرارية والراهنية، وفي جملة تقريرية تفترض امتلاكها وحدها لأبنية الحقيقة، في إشارة إلى استمرار اغتيال فلسطين في الحاضر.
يثبت هذا بدوره مفاهيم التمييز العنصري والتهميش والعنف البنيوي وإبراز الغياب أو الفقدان بشكل معيش وليس كذكرى، حيث تعمل السلطة الرمزية كما يشير هذا الفعل في الحاضر، وليس فقط كذاكرة أو تاريخ، فأنت كفلسطيني، تقول هند، “مذ حملت خيمتك الصغيرة على كتفيك”، يطلب منك باستمرار: “غيِّر وجهتك/ أو/ غيِّر الهوية“.
ورغم ذلك، تُعلي الشاعرة الأمل على الألم، فعلى المستوى الجمعي، تقول: “فهل يحتاج الكنعاني/ إلى جواز سفر أو إثبات هوية”. وعلى المستوى الشخصي، فإن هند وهي تقف في قصائدها على الحافة بين الحياة والموت، تصرّ على الغناء، كما تقول في مقدمة الديوان: “لا أدّعي الشعر، ولكنني مجرّد امرأة تحترف الغناء”. وهنا أيضا، تُعرّي هند مفهوم النخبوية الشعرية، وتعيد للقصيدة كينونتها الطبيعية، كغناء ينقذ الذات من الذوبان ومن الفناء.
الكتابة من الوجه الممحو لمسلة الحياة
في عملها، تدرك هند بقوة معنى خسارة البيت: الجسد والوطن والحلم والانتماء، لذلك تصرخ من أعمق نقطة في ضعفها “سأعود إليّ/ إلى بدني.. إلى وطني/ إلى ليلي.. إلى قمري/ إلى عيني الله الواسعتين”. ومن هذا المنطلق، يشكِّل عملها “الملائكة لا تحيا طويلاً” شهادةً رؤيوية على زمن متشظٍ وحياةٍ معلّقة على مفهوم “البيت” وخسارته، بمعنييه الفيزيائي والرمزي. ففي نصوص المغربية الراحلة هند البكاي لهبيل، يتحول البيت إلى مجاز كثيف يتقاطع فيه الزمن بالمكان، والحميمية بالفقد، ويعكس معانٍ متعددة: الانتماء، الهوية، الذاكرة، المنفى، الجسد، اللغة؛ فالبيت هنا ليس المكان بمعناه المجرد، بل الحامل لرمزية عالية يُعيد الشعر تشكيلها من خلال الانتقال بين الذاتي والعام، واللذان يتحولان بدورهما إلى مرايا لبعضها البعض.
ففي سياق المنفى واللجوء، يحمل البيت رمزية الوطن المستعمَر والهوية المتشظية، وفي سياق المرض والموت، يحمل البيت رمزية الجسد المهدّد، وفي سياق الحرب واللجوء، يحمل البيت رمزية الدمار والخيمة، وفي الحب، يحمل البيت رمزية الحبيب (والخذلان)، وفي اللغة، تحمل القصيدة رمزية البيت كمكان بديل.
وبالمجمل، يحمل البيت في هذه النصوص رمزية الحياة في مدن الرماد حيث نتقاسم “الحب والأمل والضياع“.
شعرية السخرية
في مواجهة المرض لم تسقط قصائد الشاعرة في فخّ الشكوى الذاتية، ولم تكتب عن الجسد كمكان للانكسار، بل كمجال للمقاومة. تمامًا كما تقاوم النساء بالحب رغم أنه “في مدينتا انتحار “،” أحبني حتى أقود انقلابا جديداً”، و”اكتب كتابا مقدسا جديدا/ وأخترع أسماء أخرى/ للأنبياء وأخترع صلوات أخرى/ لجميع آلهة النساء”؛ تمامًا كما تقاوم البلاد والمدن والمخيمات واللاجئون موتهم الرمزي والمادي. وفي ظل الخسارات للجسد وللحب وللوطن، تتحول القصيدة إلى جسد بديل، والسخرية إلى أداة لمواجهة الخذلان. ففي قصيدتها الأخيرة، “قال لها…” تتكئ الشاعرة على السخرية السوداء، فالحب الذي كانت تظنه خلاصًا يتحول إلى خذلان.
تخلق هذه المفارقة كوميديا سوداء تختصر هشاشة الأمل في العلاقات الإنسانية: “قال لها.. أنت ستّ النساء/ أنت كُلُّ النساء/ […] أنت.. آه.. منك أنت/ أنت.. آه.. منك أنت”، ثم “احتسى قهوته/ أطفأ سيجارته/ ثم رحل/ بصمت رجل“.
إن تكرار “أنت” يكشف عن عمق التعلق والانكسار، وتكرار رحل، يكشف عن هشاشة الحُلم حين يصطدم بخسارة البيت/الحب.
اللغة: سلاح الشاعرة وبيتها الأخير
استمرت في الكتابة وهي تتلقى العلاج في مستشفى سان لويس في باريس، وكتبت قصائد مثل “حكمة الأقدار” و”يوم يبعثون”. هذا الاستمرار نفسه، هو فعل مقاومة، كما وصفته شقيقتها في المقدمة: “ظلَّ يلازمها ويسكنها حتى وهي تتلقى العلاج”، فقد واصلت كما تقول شقيقتها هدى: “حربها ضد السرطان بمواصلتها الكتابة، فصار البيت موقعا مزدوجا للهشاشة والقوة “، وشعرها دعاءً خافتًا في عالمٍ صاخب بالحرب والفقد: “حبك كوجه الله/ أينما/ وليت وجهي أراه“.
لو أتيح لهند أن تقوم بتحرير النصوص، ربما كانت ستخفف من تقريرية الجمل وتعمد إلى الاختزال، لكن بالمجمل، تظل نبرة الصدق التي تخترق اللغة علامة مميزة لهذا العمل، فلا زخرفة ولا غنائية، بل تقابلات تبني وتهدم وهذا ما يخفف وطأة المباشرة أحيانا كثيرة. هناك حس شعري صادق، حتى في التواضع الافتتاحي بقولها: “أين أنا من مكانة الشعراء!”. لكن هذا التواضع لا يلغي القوة التعبيرية. وعلى العكس، تتقاطع تجربتها إلى حد كبير مع تجربة الشاعرات المقاومات في العالم العربي، حيث الشعر ليس مهنة، بل خيارًا وجوديًا.
هند البكاي لهبيل لم تكن “امرأة تحترف الغناء” فقط، بل صوتاً نقياً اختار أن يظل يغني حتى الرمق الأخير، لعلّ الشعر، وحده، يخلّد ما لا يستطيع الزمن الاحتفاظ به: الكرامة، الحب، والأمل والبيت.