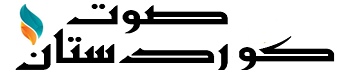في ليل الأرض المدجج بالريح، وعلى أطراف خريطة أكلتها النار ونقشت عليها سكاكين الطامحين وشهوة الغزاة، تمد أمريكا خيوطها كالعنكبوت فوق سوريا المبتورة. قيل: رحلوا، فهتف النائمون في أسرتهم، ثم أفاقوا ليجدوا أن من رحل هو السراب، وأن الأقدام الثقيلة ما تزال تخط على التراب توقيعها الأبدي.
كانت البنادق تسكن تسعمائة كتف، فارتفعت إلى ألفين ومئتين حين دنت أشباح الحدود، ثم خفّ العدد وعاد الهيكل إلى حجمه، لا ضعفاً، بل كما تفعل الأفعى حين تخفف جلدها استعدادًا للانقضاض. قواعد قامت كالحصون، وانتدابات قُرئت على أوراق سرية، بأن يبقى في الميدان من يحرس الأسطورة: أن داعش، هذا الطيف المتمرد، سيظل مبرر الوجود، إلى أن تتعب الآلهة الأرضية من لعبتها الدامية.
ففي السدود وفي مرافئ الشرق الغافي، تترسخ خيام الجنود، بعيداً عن عيون النظام الذي صار كمن يحرس أطلال مملكة غاب ملوكها وبقيت قلاعها خاوية. لو تغيرت الوجوه، قيل، قد تُنصب خيام أخرى، لأن الأرض حين يرحل عنها أهلها تفتح قلبها لأول قادم يحمل سيفًا أو بوصلة.
وعلى الجانب الآخر من النهر، في الخفاء، يجتمع الكورد. يحملون على ظهورهم قرناً من الانكسار، وحفنة من أحلام غُزلت بين الجبال والشتات. هناك، على طاولة لا تزال ترتجف من ثقل الأمل، يحاولون رسم خريطة جديدة، خريطة لا تخون لون دمهم ولا تعب آبائهم.
ليس انفصالاً ولا قفزاً فوق التاريخ، بل محاولة لبعث الحلم بلغة أخرى: أقاليم تتنفس بلغتها، وقوميات تتشارك في الرغيف والمصير. كما رفرف علم كوردستان فوق جبال السليمانية ولم يسقط بغداد، قد ترفرف شمس جديدة فوق الشمال السوري، إن عرفت أن تحت الشمس يسكن عربٌ وكلدان وسريان، وكلهم أولاد التراب ذاته.
غير أن الرياح لا تهب كما يشتهي الزراع. شمال سوريا ليس مرآة صافية، بل فسيفساء من وجوه ولهجات ورايات. والكورد، إن أرادوا أن يكونوا بُناة فجر لا أسرى أطماع، عليهم أن يغزلوا كفن التفرقة بيد المصالحة، وأن يكتبوا على جدران المدن الممزقة قسماً: أن لا ديمقراطية لهم إلا بديمقراطية جيرانهم.
ثم، هناك وجع آخر يُدق على الأبواب: العرب الذين نسوا جيرانهم، الذين تركوا اللغة الكوردية تغترب على ألسنتهم، كما تغترب الأغاني الحزينة في سوقٍ لا يعرفها أحد. كم غريب أن يتعلم العربي لهجة السلاطين من مسلسلات الحب، ويعجز عن التقاط كلمة من لغة الكورد، جيرانه منذ ألف ربيع!
وقد بادر بعض الحكماء في الشمال، ففتحوا نوافذ الحوار، فأطلقوا “شمسًا” تخترق ظلمة الجهل وتُعانق قلوب العرب بخبر الكورد. يا ليت العرب يفهمون أن من لا يتعلم لغة جاره، يبقى أسير جهله حتى لو ملك الأرض بطولها.
وفي ركن آخر من المسرح المنكوب، يتكلم رجل اسمه أحمد الشرع، يتحدث باسم سوريا وكأنّ البلاد لا تزال تحت قدميه، فيما الواقع يصفعه بحقيقة أكثر قسوة: سوريا، كما يعرفها، صارت شظايا. من الفرات حتى الساحل، ومن الجنوب حتى الضفاف البعيدة، تفرقت الدماء، وتبعثرت البيارق.
يتكلم عن وحدة لا يملك مفاتيحها، وعن بناء لا يملك حجارته. وعد، فخانت الأرض وعده. أقسم، فخانته البنادق. وها هو اليوم، ظلٌّ يتحدث تحت شمس لم تعد له، كمن ينادي في وادٍ أجفلت فيه الدواب وهجره البشر.
ثم يأتي من يتكلم عن “بناء جيش”، كأن منبت الشر لم يكن في السلاح ذاته! من أي شجرة خرافية سيقطفون جيشاً نقياً، فيما جذوره مغروسة في أرض النصرة والرايات السوداء؟ كيف يسلم الغرب عتاده لجيش، قادته كانوا بالأمس طلاب مبايعة في مدارس الخراب؟
سوريا لا تحتاج بنادق جديدة، بل تحتاج قلباً لا يخون، وعيناً لا تغمض عن الألم، ولساناً لا يخون الكلمة. تحتاج دستورًا تُكتب سطوره بدم الضمير لا دم الفصائل.
وهكذا، بين وهم الانسحاب وأحلام الفيدراليات، بين الوعود العرجاء والمفاوضات العقيمة، تئنّ سوريا. على جسدها الممزق تتسابق الأيادي، وكل يدٍ تدّعي أنها المخلّص، وما يدري الحالمون أن الإنقاذ لا يأتي من الخارج، بل يولد من داخل الرماد.
وسلام، على أرضٍ تعلّمت أن تحيا رغم أنف الخرائط، وتغني للتراب الذي لا يخون.
بوتان زيباري
السويد
26.04.2025