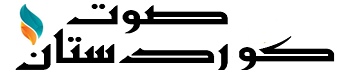كان الوقت يتلاشى مثل رذاذ الماء على صفحة ساخنة، والساعات تتحوّل إلى غبار يتراقص في ضوء الشمس المائل، هناك، على رصيفٍ صدئ من زمنٍ مهجور، التقى ظلان، كأن الكون تعمّد أن يجمع بين روحين متناقضتين، لا يجمعهما نورٌ ولا وضوح، بل انجذاب غامض، كما تنجذب النجوم المتناثرة في الفضاء البعيد إلى بعضها، قبل أن تتحوّل إلى مجرّة من الحب والوعود.. كانا ظلَّيْ رجلٍ وامرأة يتشاركان خيوط القدر المتشابكة، بحب يشبه المتاهة: معقّد، غامض، وبلا نهاية واضحة، ولم تكن علاقتهما كما يُصوّرها الشعراء في دواوينهم، بل كانت أشبه بلوحة سريالية تتقاطع فيها خطوط الواقع مع تعرّجات الخيال.. هو بقلبه المُتخم بالأمل، وهي بروحها المتمرّدة على كل قيد، وبشممٍ يشبه جمر الروح، كانا يصنعان عالماً هشّاً من الوعود المعلّقة على حبال الغد.
كانا يعرفان الكثير عن الحياة، عن كيفية تذوّق نبيذ فاخر دون كسر الطقوس، وكيفية التحليق فوق الواقع المرير بأجنحة من الكلمات المنتقاة والضحكات المدروسة، أرادا أن يبنيا شيئا يشبه القصيدة، يشبه البيت، الحلم، المستقبل.. قصرا من الاحتمالات والممكنات، ورسما خططا لا تشيخ ولا تموت، حيث كانا يلتقيان هناك، في ذلك الركن المهجور من مدينة منسية، حيث لا صوت يعلو فوق صمت الحوائط الصدئة التي شهدت على أجيال من الوداع واللقاء، في عينيه، كانت تتراقص شظايا الأمل والخوف معاً، كأنها معركة داخلية لا تنتهي بين ما يرغب به وما يخاف أن يخسره. هو، الذي اعتاد أن يكون صلبا كالصخرة، يجد في حضورها لغزا يذيب كل جبروته، وينسج من ضعفها قصيدة لا تشبهه.. أما هي، فكانت ترتدي تمردها كدرع، وتخفي خلفه شمم الروح، كما تخفي وراء ضحكتها المدروسة آلاما عميقة وأحلاما محطمة، كانت تعرف أن حبها له ليس فقط رحلة إلى الفرح، بل نزيف يتلوه شفاء مؤلم، وأحيانا خوف من أن ينكسر العالم الذي بنياه معا إذا ما سقطت قطعة واحدة منه، رغم ذلك، كانت الكلمات التي تتبادلانها بين الحين والآخر تحمل في طياتها وعودا لا يمكن نطقها صراحة، واعترافات مبطنة بأن هذا الحب المتاهة لا يخلو من أبواب مغلقة ونوافذ تطل على هواجس المستقبل المجهول.
– “سأبني لكِ قصراً من الكلمات.” همس لها ذات ليلة، وعيناه تعكسان نجوم سماء لم تُخلق بعد.
ضحكت بنعومة: “وماذا سأفعل بقصر لا أستطيع أن أسكنه؟”
كانت تلك أول مرة تُخطئ بحقه، حين شككت في قدرة حلمهما على التحول إلى حقيقة ملموسة، فهي، ولسببٍ لا يفهمه إلا من خاض غمار الحب وأدرك أن الخوف منه أقوى من الخوف من العدم، كانت تخطئ، لم تكن أخطاؤها كبيرة، بل صغيرة وناعمة، كندوبٍ خفيّة على بشرة مرآة، لا تُرى إلا حين يسطع الضوء عليها، كانت تختفي فجأة، تقفل هاتفها، تتجاهل رسائله، ثم تعود بلا تفسير، كطائر مهاجر يعود إلى عشه حين يحلو له، دون اعتذار أو تبرير، وهو، كان يسامح، كان يتجاوز في كل مرة، لا حبا في الغفران، بل لأنه كان يؤمن أن من نحبهم لا نُدينهم، بل ننتظرهم.. ننتظر أن يدركوا أن الحب ليس رفاهية، بل ضرورة، كالهواء تماما.
– “سنتجاوز هذه المرة أيضا.” كان يهمس لنفسه في كل مرة، وهو يراقب ترميم جدران قلبه المتصدعة، حيث كانت هناك معركة صامتة، بين الإصرار على الأمل والرغبة المتزايدة في الهروب، كان يشعر بثقل المسؤولية التي فرضها على نفسه، ذلك العبء الخفي الذي جعله يتردد في التعبير عن ضعفه، كل كلمة تنطق بها، وكل صمت يطول بينهما، كان يشكل له جرحا جديدا، لكنه يخفيه خلف ابتساماته المدروسة، كما لو أن العالم لن يرى سقوطه إذا لم يظهر ضعفه، فكان يعاني من الخوف المموه، خوف أن يكون هذا الحب الذي طالما حلم به، مجرد وهم جميل قد يتحطم بمجرد أن يحاول الإمساك به، كان يخشى أن تبتعد روحه عنه، أن تختفي تلك اللحظات النادرة من السكينة التي يجدها فقط في حضورها.
أما هي، فكانت تغوص في عوالمها الخاصة، مليئة بالتناقضات، كانت تسير بين الأمل واليأس كراقصة على حافة هاوية، في أعماقها، كانت تدرك أن تمردها ليس مجرد رفض للقيود، بل صرخة أخيرة لمحاولة البقاء على قيد الحياة في عالم لا يرحم، كل مرة تضحك، كانت تضغط على جزء من ألمها، تحاول أن تخفي الضعف خلف الجدران التي بنتها بحذر، فكانت تخشى أن يفهمها حقا، أن يقترب من زوايا روحها المظلمة، حيث تكمن الحكايات التي لم تجرؤ على سردها لأحد، لكن في الوقت ذاته، كانت تتوق لأن يُرى ذلك الجانب منها، أن يكون هو الملاذ الذي لا يُخاف فيه من أن تُفقد السيطرة.
في تلك اللحظات، بين الحضور والغياب، بين الكلمات التي لم تُقال والاحتياجات المكبوتة، كانا يعيشان حوارا صامتا يتخطى الزمان والمكان، كانا يتشاركان الخوف ذاته: هل هذا الحب قادر على تجاوز الجدران التي بنياها حول أنفسهما؟ أم أن الصمت هو الحاجز الأخير الذي لن يتمكن أحد من كسره؟
مرّت الأيام، وتحولت إلى شهور، وأصبحت الأخطاء تتسلل بينهما مثل قطرات المطر في ليلة عاصفة، بطيئة في البداية، ثم متسارعة، حتى غدت سيلا جارفا، لكنهما كانا يتجاوزان كل عاصفة، يُلملمان ما تبقّى من أحلامهما، ويعيدان بناء ما هدمته الكلمات الحادة والصمت الثقيل.
في عوالمهما الموازية، كانت القطط تحلم بالطيران، والعصافير تخشى السقوط، وفي عالمهما، كانا يتعثّران، ينهضان، ويستمران كما لو أن الألم مجرّد وهم عابر، وكانت أخطاؤها تتراكم كأوراق الخريف: مرة حين أغلقت الهاتف بوجهه، ومرة حين قرأت رسائله دون أن ترد، ومرة حين شككت بوفائه، كان يغفر، لا لأنه ضعيف، بل لأن روحها كانت تسكن في تفاصيله.
– “الحُب يشبه الموت.” قالت له ذات مرة وهي تتأمل انعكاس وجهها في فنجان قهوة بارد: “كلاهما يأتي دون استئذان، ويترك خلفه فراغاً لا تملؤه الكلمات.”
نظر إليها وقال بصوت هادئ: “بل الحُب يشبه الحياة، مليء بالتناقضات والألغاز والأسئلة التي لا تنتهي.”
وهذه المرة، كان الخطأ من نصيبه، حين ظن أن الحب يمكن تفسيره بالمنطق، وفي كل مرة، كان القدر يراقبهما بابتسامة ساخرة، ويهمس لنفسه: “سأمنحهما فرصة أخرى، فقط لأرى كيف سيفسدانها.”
لكن في المرة الأخيرة، لم تكن هناك عاصفة، بل صمت مطبق، حين تكسّرت اللغة، واختنق الصمت والكلام معا، خلاف بسيط تحوّل إلى جدار سميك من الصمت، حاول أن يصل إليها، ليكتشف أن رقمه قد أُدرج رسميا على “قائمة المحظورين”، وكأنها تضع قلبها في صندوق مغلق وتُلقي به في أعماق المحيط، ليس لأنها أرادت ذلك، بل لأن عنادها كان أقوى من حكمتها، والقدر، بسخريته السوداء، قرر أن يلعب لعبة أخرى.
مرّت الساعة الأولى كصفعة على وجهه، الثانية كطعنة في كبريائه، وفي السابعة، شعر أنه بدأ يتحوّل إلى تمثال ملقى في متحف مهجور لا يزوره أحد، ثم مرت بقية الساعات، واحدة تلو الأخرى، بطيئة كقطرات المطر المتسلّلة من سقفٍ متهالك، الرجل الذي طالما كان يبحث عن طرقٍ للوصول إليها، وجد نفسه هذه المرة يتأمل هاتفا صامتا، وقلبا يتشقّق ببطء، أما هي، فكانت تنظر إلى هاتفها كل دقيقة، تتوقع أن يجد طريقة للاتصال بها، ألم يكن دائما يجد طريقا إليها، مهما وضعت من حواجز؟.. لكن الهاتف بقي صامتا، كقلبها الذي بدأ يفقد إيقاعه المعتاد، وفي تمام الساعة الرابعة والعشرين، كانت الأرض قد أكملت دورة كاملة حول نفسها، دورة من التجاهل والنسيان، ليجلس أمام نافذته يتأمل السماء التي بدت أكثر اتساعا من أي وقت مضى، فكّر في طريقة للاتصال بها، ثم تذكّر أن كرامته، وشمم روحه، أغلى من أن تُهان مرة أخرى: “الحبيبة التي تستطيع أن تترك حبيبها أربعا وعشرين ساعة، لا تستحق أن تكون حبيبة”، همس لنفسه، والسماء تتنهّد موافقة.
أربع وعشرون ساعة، يوم كامل، ألف وأربعمائة وأربعون دقيقة من الانتظار، وفي كل دقيقة، كانت الحقيقة تتضح أمامه، كما تتضح الصورة في غرفة مظلمة: الحبيبة التي تستطيع أن تترك حبيبها يغرق في بحر الصمت ليومٍ كامل، لا يمكنها أن تكون حبيبة حقيقية، الحبيبة التي تستطيع أن تنام بهدوء، تأكل بشهية، تضع أحمر شفاهها بدقة، وتمارس حياتها اليومية دون أن يقلقها قلبك المنتظر، ليست حبيبة، بل مُشاهدة عابرة في مسرحية حياته، قررت الانسحاب قبل الفصل الأخير.
في تلك اللحظة، قرر ألا يتصالح معها، لا انتقاما ولا كبرياءً، بل لأنه أدرك أخيرا أن بعض أنواع الحب تشبه الأشجار الميتة: تظل واقفة، لكنها في الحقيقة فقدت روحها منذ زمن، فلم يغضب، ولم يبكِ، ولم يكتب رسالة وداع مليئة بالعتاب، بل فقط، أغلق الباب بينه وبين الفكرة، بعد أن أدرك أن الحب، ذلك الكائن الهش، لا يموت حين نصرخ، بل حين نصمت طويلا، وننتظر اتصالاً لا يأتي.. في قلبه، بقي شمم الروح صامدا، كصخرة تواجه المد، لا عنادا، بل وفاءً لما تبقّى فيه من ذاته التي رفضت أن تُختزل في لحظة خذلان.. تذكّر كم مرة قيل له إن الصمت أبلغ من الكلام، لكنه لم يتذكّر أن أحدا قال له من قبل إن صمت أربعٍ وعشرين ساعة كفيلٌ بقتل قصة حب كاملة، كما يقتل الصقيع وردة متفتحة، لتتجلى سخرية القدر، حين نمتلك كل شيء، ونمتلك القدرة على بناء مستقبل مشترك، لكننا نفتقر أحيانا لأبسط الأشياء: القدرة على الغفران في الوقت المناسب.
فكّر مع نفسه: “ماذا لو كتبت له: اشتقت؟”.. كلمة واحدة، قصيرة، لكنها تأخرت، فالاشتياق بعد أربعٍ وعشرين ساعة من الخذلان، يشبه إشعال شمعة على قبرٍ لم يعد يتذكرك، فكم هو ساخر هذا القدر، في تلك اللحظة، فهم أن بعض الأشياء، حتى لو عادت، لا تعود كما كانت، فالماء المسكوب لا يعود إلى الكأس، والوقت الضائع لا يعود إلى الساعة، والقلب المخذول لا يعود إلى النبض، فالذي ينتظر أربعا وعشرين ساعة ليتذكر أنه يحب.. لا يعرف معنى الحب.
في مكانٍ ما، في متاهات الزمن، كان هناك كونٌ موازٍ يعيش فيه ذات الرجل وذات المرأة، لكن هناك، كان أحدهما قد أرسل رسالة، والآخر قد رد، وفي ذلك الكون، كانت قصتهما مختلفة تماما، لكن في هذا الكون، كان الصمت أبلغ من الكلام، القدر، بحسّه الساخر المرير، يمنحنا أشخاصا نحلم أن نكبر معهم، ثم يضعهم على قوائم الحظر، بحجّة أن التوقيت ليس مناسبا، أما الحب؟ فهو لا يموت حين نصرخ، بل حين نصمت طويلا، وننتظر اتصالاً لا يأتي، وتلك هي المفارقة السوداء: أن أكثر ما نخشاه ليس الموت، بل أن نعيش في عالمٍ موازٍ مليء بالـ “ماذا لو”، وأن نكتشف أن أرواحنا المتعبة قد أضاعت فرصتها في اللقاء مع نصفها الآخر، لمجرد خطأ في التوقيت، أو لحظة غضبٍ عابرة.
وهكذا، انفصلا.. لا بصخبٍ أو ضجيج، بل بصمتٍ عميق يشبه ثقوب الفضاء السوداء، يبتلع كل شيء، حتى الضوء، وفي غرابة الأقدار، ظلّا يتقاطعان في الأمكنة، وفي قلب كل منهما سؤال مؤجَّل إلى الأبد: هل كان يمكن أن تكون النهاية مختلفة، لو أن أحدنا تجاوز كبرياءه وأرسل رسالة واحدة؟
لكن القدر، بحسّه الفكاهي القاتم، لا يترك مجالا للتساؤلات، فهو يعلم أن البشر يعيشون على أمل “غدٍ”، بينما الحقيقة هي أن “اليوم” هو كل ما نملك، وأن الانتظار هو أكثر أشكال الموت قسوة ووحشية.
لحظة واحدة كانت كفيلة بإنقاذ كل شيء، لكن لا بأس، فالحب ليس معادلة رياضية، ولا قانونا فيزيائيا، إنه نكتة سوداء من الكون، يضحك فيها عليك.. ثم يمضي، دون أن يعتذر، وربما.. كان الخطأ خطأه منذ البداية، حين ظن أن الظلال يمكن أن تلتقي دون ضوءٍ بينهما، أو ربما.. كان الحياة تعلمه درسا: أن القدر، رغم سخريته، يمنح فرصا ثانية للذين يجرؤون على تجاوز كبريائهم، والاعتراف بأن الحب، في النهاية، أقوى من كل الحواجز، وأن البناء مع الآخرين لا يحتاج إلى كلماتٍ عظيمة، بل إلى حضور، ووجود، واستمرارية.. ففي النهاية، كانت قصتهما مجرد سطرٍ في رواية الحياة الطويلة: “كانا يمكن أن يكونا كل شيء، لكنهما اختارا أن يكونا.. لا شيء.”