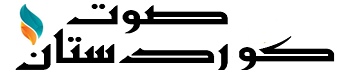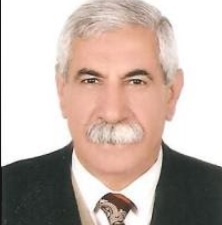ما الإصلاح الذي ننشده؟ هل الإصلاح منهج ودراسة لتحقيق حال أفضل للمجتمع، أم دعوات شخصية وأهواء حسب الرغبة وانتقاء للحالات؟ كيف يجب أن يكون شكل النهج الإصلاحي؟ هل هو رأي يتصوره البعض بأنه صحيح وأن في غير ذلك الرأي كل التخلّف والجمود والسلفية؟ هل هو صراع بين فكر مجموعتين؟ أم يجب أن يكون الهدف هو تكوين محصلة لآراء وأفكار ومناقشات من خلال لجان والاستماع إلى الآراء بمختلف توجهاتها؟ هل من المعقول أن تنقاد النُخَب من قِبَل، وعلى هوى مجموعات تريد العيش خارج حدود القيم وتعليمات الدين لتلبية شهواتهم ومن ثم جَر الآخرين للحاق بهم؟ أليس من الأخلاق دراسة الدعوات إلى الإصلاح بما تستحق قبل النطق بالنتائج النهائية؟ كيف يمكن أن نبدأ بمناقشة حالة لم تتم جمع معلومات حقيقية عن الأسباب والمسببات وتقييمها، أو عقد ندوات أو جلسات نقاشية تضم مختلف الشرائح المعنية للخروج بوضع الاستنتاجات والاقتراحات في محلها، ومن ثم التفتيش عن أهم وأفضل الحلول الواقعية؟
أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة عليها قبل عقد المؤتمرات، لأن المؤتمرات تنعقد عندما تختمر الأفكار وتتشبع بالمناقشات لتنطق بما تم التوصل إليه ومتابعة تطبيقه على الواقع. فجميع الأيزيديين مع الإصلاحات، ولكن على أية أرضية يجب أن تستند تلك الإصلاحات؟ هذا هو الإصلاح الذي يريده وينشده جميع الأيزيديين بمختلف توجهاتهم الفكرية. أنا أتفهم الظرف الذي أنعقد فيه الكونفرانس بتاريخ 23و24/6/2012 في مدينة بيليفيلد الألمانية وفي النهاية يبدو بأن الاتجاه تغير بشكل ما رغماً عن كل شيء.
أذن جميع الأيزيديين مع الإصلاحات، ولكن على أية أرضية يجب أن تستند تلك الإصلاحات؟ فالإصلاح في اللغةَ هو نقيض الإفساد، ومفهوم هذا الاصطلاح هو مفهوم فلسفي يمتلك دلالته الخاصة لكل شريحة من شرائح المجتمع. فما يسميه البعض إصلاحاً هو عند الآخرين يعتبر تقهقراً، وآخرين يسمونه ثورة على الواقع، حيث لكل فئة رؤيتها في التعامل مع مفهوم المصطلح. والاصطلاح قد يعني التغيير الإيجابي في مجموعة من الأعراف والعادات والأفكار والتقاليد السائدة التي لم تعد تقاوم الواقع وتسايره، وكذلك هو الإرادة الباحثة عن تقويم الاعوجاج وينشد معالجة الخلل في قواعد النظام المجتمعي التي من شانها إعاقة التنمية والنهوض بالمجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية. وهو بذلك عمل حضاري شامل ومستمر مع تطور المجتمعات.
ولكي نقيّم عملية الإصلاح، يجب علينا الوقوف عند الثوابت (النصوص والقواعد والفرائض) وتشخيص الحدود والمفاهيم بينها وبين المتغيرات (القيم والعادات والتقاليد)، ومن ثم الفصل بينهما بحدود واضحة كيلا يشوه أحدهما من الآخر، كما هو الحال مع الاختلاط الحاصل فيما بين السياسة والدين وفصلهما عن البعض ليؤدي كل منهما دوره المنفصل. فمن واجب النخب التي تريد الإصلاح الحقيقي أن تشخص بدقة ماهي تلك الثوابت، وتمييزها عن المتغيرات لكي يتم التعامل مع كل فئة على ذلك الأساس، وبالتالي فإن ذلك سيسِّهل كثيراً من قبول التغيير الإيجابي في أي مفصل تريده النخب، وسيسهل قبوله من المجتمع أيضاً. وحسب قناعتنا فإنه فيما عدا ذلك سيؤدي إلى الانهيار بدلاً من المعالجة. فمشكلة الشعب الأيزيدي الفاقد للقيادة الآن هي أن الأفعال وردود الأفعال هي التي تقوده وليست الأفكار، وبذلك فإن أصحاب تلك الأفعال تعمل على خلط الثوابت بالمتغيرات والإصرار على تركيع المجتمع بقبول الأمر الواقع، وبالتالي فإن المجتمع سيفقد توازنه ولن يبقَ له أية أصالة يركن إليها. وحتى إن وجدت الأفكار بهدف الإصلاح، فإنها هي الأخرى مشتتة بين اتجاهات مختلفة لا يجمعها قاسم مشترك بسبب المصلحة الذاتية والارتباط السياسي وعدم الجلوس لمناقشة بعضها البعض بشكل حضاري. وإنما فإن كل فئة ترى في نفسها بأنها محور القضية وأنها أحق من الأخرى بالقيادة وتنظر إلى غيرها بتعالي، وبالتالي تُقسِّم المجتمع إلى (محافظين وإصلاحيين) مع الأسف. وفي رأي المتواضع فإن الجميع إصلاحيون ولكن لكل منهم طريقته وفهمه للواقع وبالتالي لا يجوز استثناء أية جهة من المشاركة في مناقشة المشروع الإصلاحي. بحيث يجلس الجميع ويتباحثون في جذور المشاكل ثم يرتبوها حسب أولوياتها كدراسة أسباب ظاهرة الانتحار التي انتشرت كالسرطان في الجسد الأيزيدي مثلاً والوقوف على الوضع السياسي وتوحيد خطابه، والسعي نحو تطوير الواقع الخدمي في مناطق الأيزيدية، وبيان الموقف حول مسألة الهجرة والمهاجرين والشباب منهم بشكل خاص، قراءة الوضع القانوني بمعرفة حقوقيين وخبراء في ميدان الحقوق، لاسيما ما يتعلق منه بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة والتبني، والنظر إلى توريث المرأة بعيون منصفة وحسم مسألة الزواج خارج الدين، وتثبيت نظام الإمارة وعلاقته مع المجلس الروحاني وفق قواعد متفق عليها، وذلك من اجل إنهاء العشوائية والمزاجية والانتقائية والمصلحية السائدة في اختيار الأمير، وتنظيم واردات لالش والسناجق، وتفعيل مسألة الفتاوى في الحالات التي تستوجب، والعمل على آلية تفعيل لوبي إيزيدي فعّال في أوربا لإيصال معاناتهم للرأي العام العالمي، المطالبة بمستحقات وممتلكات الأيزيدية في تركيا والعراق وسوريا وغيرها. فنعلم بأن الذي كان يجري في السابق لم يعد يتعايش في جبّة الحاضر بشكله الضيق، ونعلم كذلك وجوب التفكير بما هو متماشي مع العصرنة بالحفاظ على الثوابت (الثوابت التي تعزز من الهوية). فليس كل تغيير هو إيجابي، وليس كل تجديد يجب قبوله على علاته، وليس من المعقول أيضاً بأن تنقاد الصفوات من قبل عامة الناس.
لا نستطيع أن نضع قانونا خاصا يصلح لكل زمان، بل يجب أن نفكر بتوجيه طاقاتنا لحلول ما في زماننا وما يتطلبه من الإصلاحات، ونترك الباقي للأجيال لتعالج مشاكلها بنفسها لأنهم الأدري بواقعهم وفي زمانهم. حيث لا يمكننا تحديد ما سيحصل في المستقبل لان الأفكار الحالية قد لا تعالج الإصلاحات في الأجيال المقبلة بسبب التطور المدني والتقدم التكنولوجي. فعلينا قراءة تاريخنا بعناية ونستلهم من مراحله العِبَر والفحوى وكيف ولماذا تطورت بتلك الأشكال والتقنيات. فالنسبة لنا وبسبب الجمود الفكري السائد وعدم تطور التكنولوجيا وقتذاك، انحصرت مفاهيم التاريخ في ترديد عدد الإبادات التي مرت على شعبنا دون أن نأخذ من محتواها ما يعنّا على معالجتها إن حدثت في المستقبل، وهو بحد ذاته إرتداد إلى الوراء واجترار الماضي بعكس ما يحصل الآن من تفاعل آني مع الأحداث.
يمكن الاستنتاج من هذا أن الأيزيديين ما بعد غزوة عناصر دولة الخلافة الاسامية (داعش) في 3/8/2014، ليسوا كما هم قبل تلك الغزوة بسبب الهزة العنيفة التي تعرضوا لها- ليس لأنها أقوى من سابقاتها ـ وإنما بسبب اختلاف الزمن والتطور التقني وسرعة التواصل والتفاعل عبر إمكانيات التطور التكنولوجي. ففي أول بادرة في تاريخ الأيزيديين تم قبول الناجيات والناجين من (داعش) ضمن الشعب الأيزيدي على الرغم من المعرفة المسبقة بالانتهاكات الجسيمة التي حصلت لهم ولهن من التغيير العقائدي والاغتصاب وغسل الأدمغة. ليس هذا فقط وإنما قبولهن من قبل عوائلهن وتهافت الشباب بالزواج منهن. وهو بذلك فتح الباب أمام واسعاً بقبول الإصلاحات المشروعة بكل رحابة صدر في الوقت الذي كان من المستحيل الحديث عنها في السابق. هذا لأننا مرتبطين بالزمان الذي نحن فيه وعلينا أن نؤمن ونتقيد بالتغيير المنضبط وأن نحسن طريقة نظرتنا لتاريخنا وتجليات الأحداث التي مرت بأن نعالج الاصطلاحات المطلوبة لوقتنا الحاضر. فالمطلوب إذن هو التقيد بالانتقال من المرحلة مع دراسة العوامل والعمليات التي تقود إلى الإصلاح الصحيح بالآلية الصحيحة على اختلاف الآراء وكالآتي:
أ ـ ما الذي يجب إصلاحه؟
الأديان جميعها عبارة عن قيم روحية تعنى بتنظيم حياة الإنسان، وفي نفس الوقت لا توجد ديانة خالية من التطرف.
في فترات متتالية تداخلت بعض المفاهيم والعادات والتقاليد بالتعليمات الدينية وترسخت بحيث أصبحت تنحسب عليها، ويجب أن يحصل فيها إصلاح. أما أن يشمل الإصلاح أصل المعتقد، فهذا هو الذي علينا التوقف عنده والحديث عنه لكيلا تعامل الثوابت بنفس معيار ومعاملة المتغيرات. وإذا كنا نقارن أنفسنا بغيرنا من الديانات من حيث الإمكانات، فسنقع في خطا جسيم لأنه ليست لنا قدرات ومؤهلات وبرامج مستقلة يمكن تطبيقها كما هو الحال مع شعوب الديانات الأخرى. فالآخرين يمتلكون الجوامع والكنائس والمؤسسات والكتب والشرع والقضاء والمدارس والمناهج وما إلى غير ذلك. أي أن مجموعة القيم والأعراف التي تحدثنا عنها بالنسبة لهم واضحة بضوابط محددة، ولكن هل نمتلك نحن برامج التربية والمناهج الدراسية ودور العبادة والمدارس والإعلام والصحافة لكي نصحح كل شيء في وقته وبما يلائم وضعنا، أو نقول لنتساير مع الواقع؟ الجواب كلا. لذلك علينا كشعب إيزيدي أن نبدأ قدر الإمكان بالاستفادة من إمكانيات الشخصيات التربوية والحقوقية والتاريخية والثقافية والتنظيمات والجمعيات ومن الدروس المستنبطة من الإبادات، وكذلك من الأحزاب الأيزيدية لكي تقوم هي بدور التوعية والتربية الأخلاقية والدينية، إضافة لما يتعلمه الإنسان في المدرسة والشارع والمجتمع. فإننا اليوم نعيش في مجتمع مفتوح على كل الاحتمالات القيمية بشقيها السلبي والإيجابي. وأن المجتمع المفتوح فيه من المخاطر ما يجب الوقوف عليها وبخطوات منتظمة ومحسوبة ومدروسة بمستوى التحديات، وليس الإصلاح الفوقي الذي يهدد بالانهيار في حال تطبيقه بدون دراسة معمقة من مختلف الجوانب النفسية والأخلاقية والاقتصادية والدينية والقانونية على مستوى القاعدة. فنعلم باليقين بأنه يجب إيجاد مساحة مشتركة فيما بين الجيل الجديد الذي يتعامل مع الثقافة المفتوحة والشارع الأوربي بشكل خاص، وسهولة أمكانية الارتباط بمن هم من غير ديانتهم، أو من خلال التعامل مع الثقافة الأوربية في وقت تتغيب عنه قيمه الدينية وثقافته الشرقية التي لم تعد تصمد أمام الكم الهائل من مغريات العصر، وبين الجيل الذي لا يزال يعيش روحياً في الوطن بالرغم من وجوده المادي في أوربا. فالحال في الواقع الأيزيدي ليس بالسهل الذي نتوقعه وذلك لأن جميع معتنقيه يتعايشون في أو مع الوسط الإسلامي والمسيحي، بما لهما من تأثيرات سلبية أو إيجابية وكذلك لصعوبة التعامل مع واقع يخلط بين عدة توجهات وممارسات متناقضة ذاتية وموضوعية في آنٍ معاً.
فالمؤسسة الدينية هي ليست بمستوى الوعي الذي يمكنه أن يدير شعباً يحمل كل هذه التناقضات. وفي ذات الوقت تكون ممثلة لديانة ومجتمع من هذا الطراز. وهي بذلك أخلّت بالنظام العام وفتحت الباب أمام الداعين إلى الإصلاح على مصراعيه، لأنها لم تؤدِ واجباتها الأساسية، وكذلك ليست بمستوى الوعي المتطور مع الحداثة. وعليه، فإنه لا يعني ذلك بأن الخلل في الدين وتعليماته لكي نأتي ونضرب أصل وأسس وقواعد الدين ونهدمه بجريرة عدم وعي رجال الدين من الأميين، وإنما علينا كمتعلمين أن نفرق بين الإصلاح والهدم. وأن ننقذ الواقع من هذا الخلل بإيجاد الوسيلة الصحيحة بدلا من أن نضرب الدين في أعماق أصوله. فالمجلس الروحاني من جانبه أيضاً قد أحتكر لنفسه كل شيء، ولكنه هو الآخر لم يفعل ما مطلوب منه. وهو بذلك جعل الشعب الأيزيدي أسير هذه الزوابع التي تعصف به في هذا الوقت حيث مواقع التواصل الاجتماعي وحرية الكتابة والرأي والمجال المفتوح أمام الجميع للإدلاء بأحقية المطالبة بتغيير الواقع الأيزيدي نحو الأفضل دون أن يقدموا الدليل أو الاقتراحات المطلوبة بهدف الإصلاح بشكله المنضبط. (يتبع الجزء الرابع)