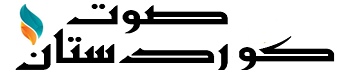في مسرح الظلال السوري، حيث تتقاذف الأطيافُ السياسيةُ جمرَ السلطة، تطلّ علينا دورةٌ وجوديةٌ جديدةٌ للطغيان، تتنكر بثوب المُخلّص وتتوسل بلغة القداسة. إنها حكايةُ النظام الذي لا يموت، بل يتناسخ في قوالب لفظية جديدة، كالثعبان الذي ينسلخ عن جلده ليحتفظ بسمومه ذاتها. نظام أحمد الشرع، الذي صعد إلى السلطة ملوحًا بإعادة البناء من أنقاض الحرب، سرعان ما كشف عن هيكله العظمي: استبدادٌ قديمٌ يرقص على أنغامٍ دينيةٍ بدلَ النشيد القومي.
ليست الثيابُ الدينيةُ سوى مرآةٍ معتمةٍ تعكس وجهاً آخرَ للشمولية البعثية، كالوجهين المتضادين لعملةٍ واحدةٍ تسكّها آلةُ القمع منذ عقود. فكما حوّل الأسدُ الأبُ العروبةَ إلى سيفٍ مسلطٍ على رقاب المختلفين، يصوغ الشرعُ اليومَ خطاباً دينياً يتحول إلى محرابٍ تُذبح عليه التعدديةُ قرابينَ وهمية. إنها لعبةُ المرايا الملتوية: فتحت مسمى “حماية الثوابت” تُختنق الأصواتُ الناقدةُ، وباسم “الردةِ الفكريةِ” تُسحقُ أحلامُ التغيير، تماماً كما جرى تحت راية “الوطنية” و”المقاومة”. هنا، لا فرقَ بين استغلال المقدسِ والدنيوي إلا كالفرق بين السكينِ والمِقصلةِ في النهاية.
تشي هذه التحولاتُ بمبدأٍ جوهريٍ في فلسفة السلطة: الاستبدادُ كائنٌ متعددُ الأوجهِ، قادرٌ على استعارةِ أقنعةِ العصرِ وإخفاءِ وجهه الحقيقي. فالنظامُ الجديدُ، رغم تبنيه لغةَ “الدولة الراشدة”، يعيد إنتاجَ آليةِ التفكير الأحادي عبر أدواتٍ أكثرَ دهاءً. الإعلامُ الذي كان يُهلهلُ سرديةَ “القائد الملهم” صارَ يُقدسُ “المرجعيةَ الفقهيةَ”، والمدارسُ التي كانت تُغذي عقولَ الناشئةِ بشعاراتِ البعثِ تحوّلت إلى منابرَ لترسيخِ تفسيرٍ واحدٍ للدينِ. حتى المثقفون، أولئك الذين ناضلوا ضدَ طغيانِ الأمسِ، وجدوا أنفسَهم أمامَ سجانٍ جديدٍ يخنقُ أفكارَهم بلجامِ “الانحرافِ العقدي”، وكأنما التاريخُ يعيدُ نفسَه بلغةٍ أكثرَ سوداوية.
وفي قلبِ هذه المعادلةِ المُعقدةِ، يطفو سؤالٌ وجوديٌ: هل يمكنُ للاستبدادِ أن يولدَ من رحمِ الثورةِ ذاتها؟ لقد جاء الشرعُ على أكتافِ حراكٍ شعبيٍ طالبَ بالحريةِ، لكنه سرعانَ ما أدارَ ظهرَه لأحلامِ المشاركةِ، مكرساً نموذجَ الدولةِ الأمنيةِ تحتَ غطاءِ “الأخلاقِ العامةِ”. المجالسُ المدنيةُ المستقلةُ تُوصمُ بالانفصاليةِ، والمبادراتُ الثقافيةُ تُحاصرُ بتهمةِ “التغريبِ”، في مشهدٍ يُذكرنا بمصيرِ “اللجانِ الثوريةِ” في عهدِ الأسدِ، حينَ كانت كلُ جماعةٍ خارجَ الحزبِ تُعتبرُ خليةً نائمةً. إنه الخوفُ الأبديُ من التنوعِ، ذلكَ الشبحُ الذي يطاردُ كلَ نظامٍ شموليٍ، فيحوله إلى وحشٍ يلتهمُ أبناءَه خشيةَ أن ينقلبوا عليه.
اللافتُ في هذهِ المسرحيةِ المأساويةِ هو افتقارُ النظامِ الجديدِ لرؤيةٍ سياسيةٍ تتجاوزُ شعاراتِ الهويةِ المُطلقةِ. فبينما تتهاوى المدنُ تحت وطأةِ الدمارِ الاقتصادي، يُقدّمُ الحاكمُ خطاباً أخلاقياً كمسكّنٍ لأوجاعِ الشعبِ، كالطبيبِ الذي يعالجُ سرطاناً بالأسبرينِ. لا خطةَ لإعادةِ الإعمارِ سوى إعادةِ بناءِ السجونِ، ولا عدالةَ انتقاليةً إلا عدالةَ المنتصرِ التي تُعاد كتابتُها على منابرِ الجمعةِ. إنها “النهضةُ” المزعومةُ التي لا تختلفُ عن سابقتها إلا كاختلافِ القيدِ الحديديِ عن القيدِ الخشبيِ.
ولا يخفى على المُتمعنِ التشابهُ البنيويُ في توظيفِ العاطفةِ الجمعيةِ. فكما استثمرَ الأسدُ في جرحِ القوميةِ العربيةِ المُهانةِ، يراهنُ الشرعُ اليومَ على غريزةِ الخوفِ من “الآخرِ” الطائفيِ، مُحولاً الدينَ من رابطٍ روحيٍ إلى سلاحٍ سياسيٍ. الخطابُ الرسميُ يغذي نزعةَ الاستعلاءِ المقدسِ، كأنما الأمةَ سفينةٌ نوحٌ لا يُسمحُ بدخولِها إلا لمن يحملُ بطاقةَ طائفةٍ معينةٍ. هذهِ الاستراتيجيةُ لا تُذكي نارَ الفرقةِ فحسب، بل تحولُ الوطنَ إلى ساحةِ حربٍ هوياتيةٍ دائمةٍ، حيثُ الولاءُ للزعيمِ يصيرُ امتداداً للولاءِ للإلهِ.
أما أخطرُ وجوهِ هذهِ الاستمراريةِ المُقنعةِ فهو تحويلُ العنفِ إلى طقسٍ شرعيٍ. فبينما كان النظامُ البعثيُ يُغلفُ جرائمَه بلغةِ “حمايةِ الحدودِ”، يبررُ خلفاؤُه الجددُ القتلَ الجماعيَ بـ”غضبِ الشارعِ المؤمنِ”، وكأنما الدماءَ تُسفكُ بإرادةٍ شعبيةٍ لا بأوامرَ مخابراتيةٍ. إنها لعبةُ التنظيرِ للهمجيةِ، حيثُ تُلبسُ الفوضى المُنظمةُ ثوبَ “الثأرِ المقدسِ”، في مشهدٍ يُعيدُ إلى الأذهانِ محاكمَ التفتيشِ التي كانت تُحرقُ المُخالفينَ باسمِ الربِ.
في الختام، ليست سوريا الجديدةُ سوى مرآةٍ مشروخةٍ تعكسُ وجهَ الاستبدادِ القديمِ بمكياجٍ حديثٍ. النظامُ الذي يتنفسُ اليومَ برئةٍ دينيةٍ هو ذاكَ التنينُ البعثيُ الذي تعلمَ فنونَ التنكرِ. التغييرُ في القشرةِ لا في الجوهرِ، والتحولُ في الخطابِ لا في الممارسةِ. فكما قال ابن خلدون ذاتَ يوم: “الغلبةُ للبسِ الحديدِ”، لكنْ في دمشقَ اليومَ، يُستبدلُ الحديدُ بسياطٍ من حريرِ الخطابِ الدينيِ، بينما الجرحُ الوطنيُ ينزفُ نفسَ الدمِ القديمِ.
بوتان زيباري
السويد
21.05.2025