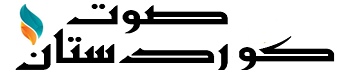التغيرات الثورية التي شهدها العالم العربي مؤخراً الجدل حول قدرة العلوم السياسية على التنبؤ بالمستقبل. وينطبق هذا بشكل خاص على التنبؤ بالاتجاهات والأحداث المعقدة في بلدان الجنوب، والتي تزايدت أهميتها بالنسبة للسياسة العالمية وبالتالي بالنسبة لألمانيا وأوروبا بشكل كبير في العقد الماضي. ومن الواضح أن العلوم السياسية لم تكن على قدر المهمة المتمثلة في التنبؤ بحركات الاحتجاج والديمقراطية في العالم العربي. ويبدو أن قدرة علماء السياسة على التنبؤ بدقة، إن لم يكن بالأحداث الفردية، أو بالاتجاهات الناشئة أو عكسها، كانت ضعيفة في الماضي. إن انهيار النظام الشيوعي في أواخر ثمانينيات القرن العشرين يعتبر مثالاً بارزاً على ذلك، ولكنه ليس سوى مثال واحد من أمثلة عديدة: ففي منتصف سبعينيات القرن العشرين كانت البرازيل تُـشار إليها باعتبارها إحدى القوى العالمية المستقبلية. وبعد فترة وجيزة انزلقت البرازيل إلى أزمة ديون كان تأثيرها يحد بشدة من حيز المناورة الدولي للبلاد على مدى العشرين عاماً التالية. وفي أواخر ثمانينيات القرن العشرين أُعلِنت اليابان باعتبارها القوة العالمية الجديدة، ولكن نقاط ضعفها السياسية والاقتصادية البنيوية جعلتها تستلزم تعديل هذه الفرضية بعد فترة وجيزة. وفي أوائل تسعينيات القرن العشرين، وعلى خلفية انهيار الكتلة الشرقية، أعلن فرانسيس فوكوياما بنشوة نهاية التاريخ أو الانتصار الحتمي للديمقراطية. ولكن سرعان ما أعقب ذلك فترة من خيبة الأمل في ضوء استمرار الهياكل الاستبدادية في العديد من بلدان أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. فهل فشلت العلوم السياسية إذن في تطوير توقعات قابلة للتطبيق للمستقبل من خلال النتائج التي توصلت إليها من أحداث الماضي؟ هناك عدد من الحجج التي يمكن طرحها لدحض هذا التعميم الشامل: أولاً، في بعض مجالات تحليل السياسات الوطنية ـ وخاصة البحوث الانتخابية ـ طورت العلوم السياسية إمكانات كبيرة في مجال التنبؤ. وثانياً، لا يمكن التنبؤ بدقة بموعد وقوع أحداث بالغة التعقيد مثل الحركات الديمقراطية والثورات والحروب الأهلية. وفي أفضل الأحوال، من الممكن إصدار بيانات احتمالية، أي بيانات حول مستوى معين من احتمالات تغير الهياكل السياسية أو بقائها. وفي الوقت نفسه، لا يزال علماء السياسة يختلفون على نطاق واسع في آرائهم حول العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل مؤشرات ذات صلة بمثل هذه الظواهر، وكيف ينبغي ترجيح العوامل الفردية ضد بعضها البعض. ولكن هذا ليس خاصاً بالعلوم السياسية. ففي الاقتصاد الحديث أيضاً، لا تزال أسباب الظواهر الاقتصادية المعقدة ـ مثل الديون أو الأزمات النقدية ـ موضع نزاع، ونتيجة لهذا فإن أغلب التوقعات التي تنشرها المجالس الاستشارية الاقتصادية أو اللجان الاقتصادية تُصاغ بعبارات عامة للغاية ومتنوعة للغاية في دقتها. ولكن من الصحيح أن العلوم السياسية تواجه تحديات خاصة ناجمة في المقام الأول عن غياب فهم موحد لماهيتها. ففي ألمانيا على الأقل، لا يوجد إجماع على المهام التي تقوم بها، والمهارات التي تسعى إلى اكتسابها، والأساليب التي ينبغي لها أن تستخدمها. وما زال التركيز على شرح أو وصف أو موازنة النقد المعياري بالمواقف السياسية يشكل قضية مثيرة للجدال بين مدارس الفكر المختلفة. وينطبق هذا بشكل خاص على دراسة البلدان والمناطق النامية، حيث يتنافس ممثلو الفروع الحديثة للعلوم الاجتماعية، التي تركز بشكل أكبر على تفسير الظواهر السياسية، مع ممثلي المناهج التاريخية الوصفية والمدارس النقدية المعيارية ذات الأصول الماركسية الجديدة. إن هذا الافتقار إلى الاتفاق على أهداف العلوم السياسية يشكل عقبة ليس فقط أمام عملية تراكمية للتعرف على أسباب الظواهر والاتجاهات السياسية الماضية، بل وأيضاً أمام السبل الكفيلة بتحويل النتائج القابلة للتطبيق حول العلاقات السببية إلى تنبؤات بالتطورات المستقبلية. ورغم أن الاقتصاد أيضاً يشهد مناقشات حول النظريات والأساليب، فإن هناك إجماعاً أساسياً على أن النظريات والأساليب لابد وأن تقاس بقدرتها على تفسير الظواهر الاقتصادية، وهو ما يسهل إلى حد كبير عملية تحويل هذه النظريات والأساليب إلى تنبؤات علمية. وبطبيعة الحال، تسعى هذه النظريات والأساليب إلى استخلاص استنتاجات من العوامل التي تفسر الأحداث الماضية من أجل استخلاص بيانات حول احتمالات الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية. فضلاً عن ذلك فإن عمل علماء السياسة في مجال التنبؤات غالباً ما يُنظَر إليه باعتباره عملاً أدنى شأناً من الناحية العلمية. وهذا يؤدي إلى تقليل التركيز بشكل عام على أساليب التنبؤ مثل تقنيات المحاكاة وتحليل السيناريوهات في المناهج الدراسية لدورات العلوم السياسية. كما أن القرب المحتمل بين دراسات التنبؤ والسياسات العملية والمشورة السياسية يشكل عقبة في ألمانيا، وذلك بسبب الخوف (المتبادل) من الاتصال بين السياسة والعلوم السياسية. ومن المخاوف التي يشعر بها علماء السياسة في هذا السياق في كثير من الأحيان أن دورهم قد يقتصر، في تصور الجمهور على الأقل، على المراقبة وتقديم المشورة بشأن السياسة. ومن ناحية أخرى، لا ينبغي قياس قيمة العلوم الاجتماعية فقط بالإشارة إلى قدرتها على إصدار بيانات موثوقة حول احتمالات الأحداث والاتجاهات المستقبلية باستخدام الأساليب العلمية. بل ينبغي للعلوم السياسية أن تكون أكثر نشاطاً من أي وقت مضى في مواجهة هذا التحدي، مع مراعاة التطورات خارج وداخل عالم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فرغم تباين مجالات الموضوع التي يتناولها، فإنه يتمتع بالأسس العلمية اللازمة لهذا الغرض، وقد يعمل بالتالي، إلى حد ما على الأقل، كعامل موازنة للتقييمات الخام التي يجريها العديد من الخبراء الذين يسمون أنفسهم خبراء، والتي غالبا ما يشكل الجمهور من خلالها صورته عن العمليات السياسية في البلدان البعيدة.