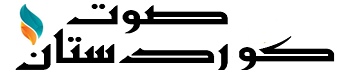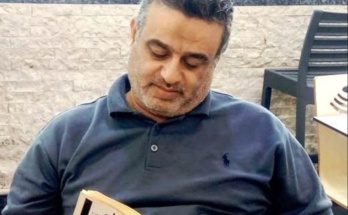بدءا وجب علينا ان نبارك السيد محمد شياع السوداني رئيس الحكومة على الخطوات الايجابية المتخذة حيال التنمية الاقتصادية في العراق. حيث جاءت في اكثر توجهاتها ضمن تصوراتنا وطموح الشعب. وهنا لابد من الاشارة الى ان الارادة السياسية لكل حاكم صاحب القرار السياسي هي اهم الاداوات الفاعلة لتحقيق مضامين البرنامج الحكومة واهدافها قصيرة كانت ام على المدى الطويل. فرغم ايجابية التوجه الحكومي في اطارها الاقتصادي ـ الاجتماعي علينا تقديم بعض تصوراتنا التي من شأنها دعم وتطوير الحراك الحكومي صوب تحقيق الاهداف المرجوة والواردة في البرنامج الذي طرحه السيد السوداني. فعليه:
اولا: لاشك من أن معيار الشرعية السياسية ومصداقية فعل القوى الوطنية يقاس بحجم المنافع الاقتصادية وما يتحقق من مكاسب على مستوى الفرد الواحد في إطار التنمية المستدامة لعموم المجتمع. ومن الناحية الثانية يجب الأخذ بنظر الاعتبار الجانب السياسي المتمثل بحجم الحريات العامة (الايجابية) التي يمكن للشعب أن يتمتع بها، والاخذ بنظر الاعتبار مكانة البلاد اللائقة في إطار العلاقات الدولية قياساً إلى ما عليه من سمعة لدى المجتمع الدولي.
ثانيا: أن مثل هذا القول يقودنا إلى التأكيد على أهمية الربط بين الاقتصـاد والسياسة وبين شرعية العمل السياسي. فلو أخذنا تجارب الدول الصناعية المتطـورة ذات الطابع الديمقراطي كمثال على ترابط وتكامل هذين الجانبين وأهمية ذلك في خلق المناخ الملائم للتطور الاقتصادي – الاجتماعي، لوجـدنا أن الأحزاب والقوى السياسية في مجتمعاتها تتنافس على السلطة من خلال ما تقدمه على مدى فترات زمنية ليست بالقصيرة من عطاء مادي ملموس للفرد والمجتمع.
ثالثا: تعتبر السياسة الاقتصادية لأية دولة بمثابة الاستراتيجية العامــة للتطور الاقتصادي – الاجتماعي اللاحق للبلاد من حيث الزمان والمكان، وتكون خاضعة للظروف الموضوعية، منها تلك المتعلقة بالسمات الاجتماعية كالعادات والأعراف والتباين في المستوى الاقتصادي للمناطق والأقاليم، وهذه أما أن تكون مساعدة أو عائقة.
رابعا: أن توفر مستلزمات وشروط النمو الاقتصادي والتي تكمن في حجم الموارد المادية – الطبيعية والبشرية – التقنية ومستوى التعليم والخدمات العامة، كل ذاك من شأنه تحديد الإطار العام للسياسة الاقتصادية. ومن جهة ثانيــة يجب الأخذ بنظر الاعتبار العامل الخارجي كالمتغيرات السياسية في العلاقات الدوليـة وموقف الدولة من الأحداث العالمية والتأقلم مع الظواهر الاقتصادية الحديثة كالتكتلات والإندماجات القائمة والمستمرة بين الشركات الكبرى (عبر القارات – فوق القومية) في إطار ما يسمى بالعولمة ومدى الاستفادة الإيجابية من هذه المتغيرات.
بعد اكثر من عشرين عاماً – عقب الاحتلال الامريكي عام 2003 – وفيما يخص التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وانطلاقاً من هذه المقدمة، علينا قبل كل شيء فهم الواقع السياسي الذي سيكون عليه العراق. ونقصد هنا الطبيعة السياسية للنظام والقــوى التي يمكن لها كسب مثل هذه الشرعية والمصداقية لقيادة دفة الحكم وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها ومنها معدلات النمو الاقتصـادي وزيادة إجمالي الناتج المحلي بشقيه الاجتماعي العام، أي القياسي، والفردي الخاص، أي النسبي. أذن فالتنميـة الاقتصادية لا يمكن لها أن تتحقق من دون ديمقراطية حقيقية لقوى الشعب الفاعلة المؤمنة بالتغييربغض النظر عن انتماءاتها الفكرية أو القومية أو الدينية. فبعد تحديد طبيعة النظام السياسية والتعرف على ماهية السلطة واتجاهاتها الفلسفية في حقلي الاقتصاد والسياسة والاجتماع علينا التأكد من إيجابية (أو سلبية) آليات تطبيقها على الساحتين الداخلية والخارجيـــة. وفي ضوء هذا الطرح يمكن لنا من وضع السياسة الاقتصـادية المطلوبة طبقاً للنموذج السياسي وطموحاته.
في هذا البحث لن نتعرض إلى الواقع الاقتصادي العراقي وخاصة خلال العقدين الأخيرين لرسم صورته التفصيلية بسبب ندرة الإحصاءات الدقيقة والمتعلقة بالتطور (أو الانكماش) الحاصل في القطاعات الاقتصادية كحجم الناتج المحلي ونسبة التضخم وحجم البطالة ومؤشرات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وإن وجدت فهي مقتصرة على العموميات التي يطرحها هذا الجانب أو ذاك أو أن مصدر توفرها هو النظام لأسباب تتعلق بتلميع صورته وتحديداعلى مستوى الإعلام، والسبب الثاني يكمن في صعوبة تحديد حجم الدمار الهائل الذي لحق بالاقتصاد العراقي جراء الحرب ضد قوى الظلام الداعشية وباقي القوى المعادية للنظام السياسي الجديد ومؤامراتها داخليا وخارجيا. فعليه نحن أمام معضـلة ملموسة – افتقادنا الى نظام احصائي فاعل ذو طابع فني – وبمجرد القيام بمسح شامل ودقيق للقطاعات الاقتصـادية من قبل اللجان المتخصصة يمكن لنا من تحديد الخطوات الضرورية لرسم الإطار العام للمستقبل الاقتصادي ما بعد صدام.
نرى أنه من المفيد التذكير بأنه عند دمج الأرقام الخاصة بالكارثة الاقتصادية التي لحقت بالعراق جراء قرار شيطاني واحد لتنفيذ قادسية ” القائد المهندس” كلف أكثر من 450 مليار دولار. علماً أن هذا القرار كلف إيران أيضا ما يقرب من 650مليار دولار، أي ما يعادل عائدات إنتاج نفط البلدين منذ عام 1930لغاية 1988. فعلى سبيل المثال:
– قدرت كلفة تواجد القوات العراقية في الكويت بأكثر من مليون دولار يومياً، وتقدر خسائر العراق قبل تجميد الأرصدة بحوالي 5 مليارات دولار وخسائره بسبب إيقاف تصدير النفط بحوالي مليار دولار يومياً.
– حجم الذهب والأموال الموجودة في البنك المركزي الكويتي والبنوك الأخرى قبل الاحتلال قدرت بـ 4 مليارات دولار.
– فاتورة القوات المشتركة في السعودية فقد بلغت اكثر من 24 مليون دولار يومياً.
نفهم من ذلك ان كلفة قرارين فقط من قبل صـدام حسين الأول في عام 1980 والثاني في عام 1990، أي خلال 10 أعوام ما يعادل 000 000 000 2 (ألفا مليار دولار أمريكي!!).
فضلا عما تقدم (كلفة الحرب ضد داعش وتفشي الفساد وادارة حكومية فاشلة في تقديم الخدمات طيلة عشرين سنة) هو صورة عامة للدمار الذي لحق بالعراق وما يعانيه الاقتصاد العراقي، وهي الصورة غير متكاملة الأبعاد في إطارها الأكاديمي لغياب الإحصائيات المطلوبة على وجه الدقة، ولكنها صورة تقرب المعنيين من رسم الملامح العامة للمستقبل الاقتصادي الذي نحاول الخروج به.
السياسات الاقتصادية المطلوبة
تشير المفاهيم الاقتصادية المعاصرة إلى الكثير من الخلط والالتباس عند تداول النظريات الاقتصادية وخاصة عند الممارسة الميدانية لتحقيق معدلات نمو اقتصادية كفيلة بسد حاجات الفرد المتنوعة، حيث تختلف طريقة الأخذ بهذا أو ذاك من أسلوب الإنتاج من قبل نظام سياسي معين إلى آخر. فكثيراً ما حاولت الدول ومنها العـــراق تطبيق الكثير من النماذج الاقتصادية وبالتالي الركون إلى أسلوب اقتصادي مشوه واهمـة نفسها بأن ما توصلت إليه هو قمة الإبداع والخلق في عالم الاقتصاد والإدارة تعكس عبقرية غير مسبوقة، وكثيراً ما نجـد حول هذا ” الإنجـاز- على مدى عشرين سنة – هالة من النصر الكاذب والثورية الخادعة والوطنية الزائفة تعكسها وسائل الإعلام التابعة للحكومة نفسها او الخاضعة للاجندات الاقليمية او الدولية.
لماذا السياسة الاقتصادية … ؟
لأن الاقتصاد المعاصر علم يبحث قبل كل شيء عن المصادر والثروات الطبيعية والطاقات البشرية وصولاً إلى الاستغلال المناسب لسد حاجات المجتمع، ولأن التنمية المستديمة هي من العمليات المعقدة والحساسة، حيث تشمل مجموعتين أساسيتين هما عماد علم الاقتصاد لم يراعهما النظام السياسي في العراق ما بعد صدام ولغاية اليوم:
الأولى: تشمل المايكرو (الاقتصاد الكلي) هو ذلك الجانب الحيوي في علم الاقتصاد، في ضوء مؤشراته العامة تتحدد السياسة الاقتصادية للدولة، مثل الإنتـاج ـ التشغيل – معدلات الأسعار (التضخم) ـ العلاقات التجارية الخارجية.
الثانية: تشمل الميكرو ( العـرض والطلب العامين ) أي سلوك الأفراد والمؤسسات أثناء عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك العام – الداخلي- والعلاقة المتبادلة فيما بينها وأخيراً نفقات الإنتاج ـ الدخل ـ الأجور ـ الأرباح.
فالسياسة الاقتصادية واضحة المعالم (السياسة الاقتصادية في العراق مشوهة) أذن هي الأداة الرئيسية للدولة وعن طريقها تتحكم بالحياة الاقتصادية وتضع الضوابط للتأثير على التطور الاقتصادي اللاحق للبلاد، وهذه الأداة تشمل كل من السياسة النقدية والمالية وتحديد الإطار العام للأنشطة الاقتصادية (قوانين ـ تشريعات ـ قواعد)، كما يمكن للدولة عن طريق السياسة الاقتصادية وضع السقف الأعلى للتضخم ومراقبة دورة الأزمات الاقتصادية وخاصة في مجال البطالة وحدودها المقبولة. كما أن السياسة الاقتصادية تعني أيضاً بتوزيع الواردات المالية وتوزيعها – الدخل الوطني – بالشكل الذي يحد من خطورة الإخفاق الاقتصادي نتيجـة الاعتماد الكلي على آلية السوق (اقتصاد السوق) أو الركون إلى النظام المركزي المفرط في الإدارة الاقتصادية. كما ينبغي بهذا الخصوص التذكير بأن مفهوم السياسة الاقتصادية تتشابك مع مفهوم تدخل الدولة أو فيما نسميه برأسمالية الدولة وتختلف كلياً عن الأسلوب الاشتراكي في الإنتاج المعتمد على مركزية التخطيط والقرار. سنعود لاحقا الى موضوعة اقتصاد السوق من خلال بحثنا في مفهوم الخصخصة.
يتميز الاقتصاد العراقي في كثير من مكوناتها التنموية عن باقي اقتصادات البلدان الأخرى، فالمكونات هذه تختلف حسب حجم وفاعلية الأداء الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية وكذلك الخدمية، كما تختلف في درجة الأولويات والأهمية الاقتصــادية من فرع إلى آخر وكذلك بالنسبة إلى توفر الموارد الطبيعية (الخامات والمعادن) والطاقات البشرية. لقد سبق وأن تم تصنيف الدول اقتصاديا (classification) من قبل هيئة الأمم المتحدة إلى دول نامية ودول متطورة صناعياً وحسب هذا التصنيف يعد العراق من الدول النامية. وحسب خبرتنا المتواضعة كأستاذ للاقتصاد الدولي تجدني على خلاف مع مثل هذا التصنيف، لذا اعتبر التصنيف المذكور أدناه هو الأقرب إلى الواقع الاقتصـــادي لدول العالم من حيث مستوى الدخل الفردي أو القومي كمجموعات اقتصادية:
– مجموعة الدول البترولية والدول الآسيوية حديثة التصنيع
– مجموعة الدول ما بعد الاشتراكية
– مجموعة دول أوربا الصناعية المتطورة وأمريكا
– مجموعة الدول الأخرى وهي باقي بلدان العالم العربي وبلدان القارة الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية
أما أوجه الاختلاف Economy Characteristics of Iraqi في طبيعة وميزة الاقتصاد العراقي عن اقتصاديات هذه المجموعات وخاصة الثلاث الأولى (عدا أمريكا) هي كالآتي:
- لدى العــراق طاقات زراعية هائلة ولكنها غير مستغلة بالشكل التناغمي مع باقي القطاعات الإنتاجية متمثلة بسعة الأراضي الصالحة لزراعـة مختلف المحاصيل الزراعية. كما تتوفر مستلزمات التطوير الزراعي وهي لم تكن في الواقع مؤهلـــة للاستخدام التام (سوء الإدارة الحكومية) حيث يعتبر العراق بالأساس بلداً زراعياً قبل الاستكشافات النفطية.
- في العراق طاقات بشرية وقدرات علميـة – فنية على مستوى عالي من المهارة والخبرة كما أثبتت الوقائع وهي تضاهي في كفاءتها الطاقات البشرية الموجودة في الكثير من البلدان المتطورة، ويجــدر ذكره أن هذه الطاقات لم تستغل إلا بشكلها النسبي وحسب حاجات النظام الأمنيـة ونظرية التوسع العسكري الأفقي دون الأخذ بنظر الاعتبار التنمية المستديمة الشاملة.
- البنية الارتكازية للقطاع الصناعي في العراق لا تزال على درجة من التأهيل بحيث يمكن أن يكون الإنتاج الصنـاعي على مستوى تنافسي مع الصناعات الأجنبية. وهنا يمكن القول أن الكثير من الصناعات العراقية بدأت تدخل الأسواق الخارجية وخاصة السوق العربيـة، ألا أن سياسة الحروب والطاقات الصناعية التي تم الهدر بها – تلكؤ المئات من المصانع والمعامل والمنشأت الانتاجية – كان من شأنه الرجوع بالعراق إلى عهد التخلف.
- الحجم الهائل للواردات المالية جراء التطور الذي حصل على إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. فالنفط هو القطاع الحيوي والديناميكي المؤهل كي يلعب الدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية حاضراً ومستقبلاً.
- البنية التحتية في الاقتصاد العراقي رغم الدمار الذي حصل خلال عقدين من الزمن، قادرة على تلبيـــة الاحتياجات التنموية وبعد تأهيلها بالكامل ستكون العنصر البارز في تطوير سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- للعراق إمكانية خلق صناعة سياحية متطورة كفيلة بدعم الاقتصاد الوطني، فالطبيعة في العــراق والمواقع التاريخية والجبال والوديان والسهول وتناوب الفصول في شماله وجنوبه، إضافة إلى العتبات المقدسـة التي اجتذبت ويمكن أن تجتذب الملايين من مسلمي إيران وباكستان والهند ومن باقي الدول العربية والأفريقية.
إن ما تم ذكره هو بعض من السمات الاقتصادية العامة التي يتميز بها العراق عن باقي بلدان المجموعات التي تم ذكرها كي يتبوأ مكانة مرموقة في إطار العولمـة الاقتصادية، ونظراً لهذه الإمكانات والقدرات الاقتصـــادية يتوقع أن يكون العراق النمر الاسيوي رقم واحد في السنوات القادمة. ونعتقد ان توجهات السيد السوداني الايجابية الحالية هي ضمانة لتحقيق طموحات العراق في بناء اقتصاد ناهض.
اعتمد الكاتب في بحثه هذا إلى التنظير التالي. بعيداً عن النظريات الاقتصادية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية، أو الليبرالية والنيوليبرالية، وبعد فشل التطبيق في النظرية المركزية في الإدارة الاقتصادية، أي النظام الاشتراكي ومن ثم انهيار الاشتراكية برمتها، كما يجدر الإشارة إلى عدم قدرة نظام اقتصاد السوق في معالجة أهم المعضلات الاقتصادية كالتضخم والبطالة ومعدلات النمو الاقتصادية المتدنية في أكثر بلدان العالم الصناعي المتطور وما الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والمزمنة للنظام الاقتصادي الحر خاصـة في جنوب شرق آسيا والمكسيك واوروبا والولايات المتحدة الامريكية (فيما يتعلق بأسواق الرأسمال والأوراق المالية)، إلا تأكيد على إخفاق النظريات الاقتصادية التقليدية وبالتحديد بعد انفجار ثورة المعلوماتية والاتصالات.
هذه الحقيقة الملموسة تجرنا إلى البحث عن أطر حديثـة ومفاهيم غير تقليدية لخلق اقتصاد متين مبني على قيم اجتماعية أكثر ميلاً للإقناع الإنساني دون الحد من توسيع قاعدة القيم الربحيـة أي المادية، فالمعادلة الاقتصادية تكون متوازنة عند توازن القيم المادية والاجتماعيـة، ولحين البت في تثبيت المفاهيم الجديدة سنكون قد تجاوزنا مرحلة ليست هي بالضائعـة لتعويض ما تم دماره في البنية التحتية للاقتصاد العراقي ومن ثم تأهيل القطاعات الإنتاجية والخدمية بالشكل الذي يتيح الفرصة من جديد لخلق اقتصاد منتعش ومزدهر. فعليه نرى أن التنمية الاقتصادية في العراق يجب أن تكون مبنية على أسس حديثة مع مراعاة القوانين الاقتصــادية الكلاسيكية والليبراليـــة في حدودها الإيجابية.
مراحل التنمية الاقتصادية
بعد مقدمة تنظيرية مضغوطة ولتحقيق تنمية اقتصادية ذات أبعاد متوازنة (سياسية – اجتماعية) يتطلب منا التركيز على مراحل أربع محددة كإطار منهجي عام لتحديد المستقبل الاقتصادي :
المرحلة الأولى: ضرورة أعادة الهيكلة الارتكـازية للقطاعات الاقتصادية مع توزيع نوعي للكوادر الفنية وتأهيلهم بشكل يتناسب مع الخطوات اللاحقة في عملية الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات التحول الاجتماعي. وبخط متوازي مع تنفيذ هذه المرحلة يجب إقامة الأسس الاقتصادية والتنظيمات الاجتماعية ذات العلاقة، بهدف الإسراع في تنفيذ المرحلة.
المرحلة الثانية: أهمية توسيع قاعدة البنية التحتية infrastructure ويتم عبر عملية تركيز الاستثمارات المختلفة في إطار راس المال الاجتماعي للإسراع في إنشاء شبكة واسعة من المواصلات بكل أشكالها لربط المحافظات بالقرى والأرياف، مضاعفة بناء محطات توليد الطاقة، بناء جسور إضافية في العاصمة وباقي المحافظات وليس أخيراً الإكثار من محطات الري والسدود. ونقصد هنا ربط القرى والارياف بشبكة مواصلات واسعة بالمدن ذات الطابع الانتاجي صناعيا زراعيا وخدميا لتحقيق تكامل اقتصادي يشمل العراق باكمله، من شأن ذلك القضاء على البطالة وزيادة في الانتاجية وتعشيق الصناعات الهندسية والتعدينية والتكنولوجية بالتنمية الزراعية، وليس اخيرا زيادة في حجم الدخل الوطني بعيدا عن الاقتصاد الريعي.
المرحلة الثالثة: استغلال مكثف للمصادر الطبيعيـة المتوفرة وتسخيرها في خدمة القطاع الزراعي والصناعي، مع الاهتمام المضاعف في تنمية الزراعة لتوفير وسد حاجات السكان من الغذاء وخلق فرص جديدة لتطوير الفروع الصناعية المعتمدة على مستخرجات القطاع الزراعي (الصناعات الغذائية).
المرحلة الرابعة: عند بلوغ مرحلة النمو الاقتصادي وتصاعد معدلات نمو القطاع الصناعي والزراعي، على الدولة وضع خطط محددة لتطوير قطاع التصدير مع دعم متكامل لتشجيع القطاع الخاص لتصدير منتجاته والمنافسة مع الأسواق الأجنبية للحصول على المزيد من العملات الصعبة المستخدمة في شراء التكنولوجيا الحديثة أو الحصول على المواد الخام اللازمة لتطوير بعض الصناعات أو الخدمات الضرورية وذلك لخلق نقلة نوعية شاملة في كل مناحي الحياة. مثل هذه المراحل تم تحقيقها في عهد بسمارك الالماني في القرن التاسع عشر ليجعل المانيا دولة متطورة صناعيا ومنطلقا للهمنية الاقتصادية في مجمل اوربا.
أن مثل هذه السياسة الاقتصادية من شانها تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة معتمدة بذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة وصولاً إلى:
- إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع.
- التخلص من التبعية الاقتصادية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبياً و الاستغناء عن الكثير من السلع والخدمات الأجنبيـــة التي تزيد من مديونية الدولة الخارجية والعمل بقدر المستطاع إحلال المنتجات الوطنية محلها .
- تلافي التشوهات الحاصلة في الهياكل الإنتاجية وصولاً إلى التنويع الاقتصادي.
- عدم الاعتماد على تصدير المواد الأولية (الخام) ونقصد هنا تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من الاستخراجية للحصول على القيمة المضافة والتخلص من التبعية الاقتصادية.
- عدم الاعتماد على النفط كعنصر رئيسي في عمليـــة التنمية لفتح آفاق جديدة لتصنيع منتجات جانبية تكون ضرورية لصناعة منافسة.
الخصخصة والانفتاح الاقتصادي
بعد انهيار النظام الدولي المتعدد القطبية (انهيار الاتحاد السوفيتي كقطب منافس لأمريكا) تشهد البشرية حالياً ظاهرة جديدة في علاقاتها الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتبادل التجاري، وهي ظاهرة العولمة. وبما أن العراق لا يمكن له أن يكون بمعزل عن المجتمع الدولي بل يمكن القول بأن للعراق دوراً متميزاً في التأثيـــر على الأحداث السياسية والتطورات التي قد تستجد في منطقتنا أوفي العالم ككل.
فعلا يتجه العالم الى الاقرار بنظام عالمي جديد … نظام عالمي متعدد الاقطاب
لسنا هنا بصدد الدخول في تحديد أو تعريف مفهوم هذه الظاهرة، بل المطلوب منا كيف يمكن التعامل معها وهل يمكن استغلالها لجهة مصالحنا الاقتصادية والسياسية. لسنا من المعارضين لفكرة الانفتاح الاقتصادي أو تطبيق الخصخصة، ولكن هناك من التحفظات ما يكفي لنتخذ موقفاُ فيه الكثير من الندية وخاصة التطبيق الحرفي لشروط وأملاءات صندوق النقـد الدولي والبنك الدولي وهما الأداة الرئيسية التي تدير دفة العولمة. فالعولمة اليوم بمثابة تيار يسود العالم من دون أن يكون هناك مجال لأية قوة أخرى في تحديد مسارها غير الشركات العالمية الكبرى (عبر القارات). ولكن … بظهور الصين كقوة اقتصادية وعسكرية ايضا اضافة الى قوة روسيا الاتحادية العسكرية قد نشهد تقزيم دور امريكا في الهيمنة على العالم وفرض املاءاتها في نهب ثروات الدول.
وكي لا نضيع هنا في متاهات العولمــة، علينا أن نحدد الاستراتيجية الاقتصادية المطلوبة عند بدء العمل بالخصخصة والقبول بالانفتاح الاقتصادي. نرى من الضروري أن نشير إلى وجود ما نسميه بالخصخصة “السلبية” والخصخصة “الإيجابية” وكي نتجنب أخطاء كبرى حصلت لدول كثيرة أقدمت على تطبيق مبدأ الانفتاح الاقتصادي وسرعتها في تحقيق الخصخصة، يجب أن تكون خطواتنا في هذا السياق متأنية ومدروسة نابعة من الاعتبارات الاجتماعية والسياسية وكذلك الاقتصادية. أن تطبيق الخصخصة يتطلب فهما دقيقا للمتغيرات الاقتصــادية الإقليمية والدولية ولا يمكن السير بخطوات جادة في هذا الاتجاه إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار التدرج الشمولي في الإجراءات والتشريعات القانونية والاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي وذلك عبر مراحل:
المرحلة الأولى على المدى القصير
هنا يجب وضع الاستراتيجية الاقتصـادية بالشكل الذي تمكن من تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 12ــ15% مع الأخذ بعين الاعتبار دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي بنسب لا تتجاوز 75% لتحريك الاستثمارات في المشروعات القائمة في مختلف الأنشطة والقطاعات السلعية والخدمية. الارتفاع بكفاءة تشغيل المشروعات القائمة والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة في المشروعات الإنتاجية بالمشاركة مع القطاع الخاص. أما النسبة المتبقية فتكون للرأس المال الخاص كي يمارس دوره في عملية الإصلاح الاقتصادي. تعتمد الفترة الزمنية لكل مرحلة على ما تحقق من أهداف. أي أن نسبة خصخصة المشاريع المملوكة للدولة يجب أن تكون بحدود 25%
المرحلة الثانية على المدى المتوسط
في هذه المرحلة تكون الاستراتيجية الاقتصادية قد حددت معدلات نمو اقتصــادية تتراوح بين 8% و 12% على أن يتم في الوقت نفسه تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث لا يتجاوز نسبة 40% ومن ثم العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة المشاريع القائمة. أما النسبة المتبقية فتكون من حصة القطاع الخاص لمزاولة نشاطه والمساهمة في تكوين أجمالي الناتج المحلي، وتكون نسبة خصخصة المشاريع المملوكة للدولة بحدود 50%.
المرحلة الثالثة على المدى البعيد
تتمثل هذه المرحلة بمعدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5% إلى 8% وهنا يجب تقليص دور الدولة إلى أقصى حد ممكن لغاية 10% والتي تتعلق بالصناعات الاستراتيجيــة مع الحفاظ على الخدمات كالتعليم والطب والنقل والمواصلات التي يمكن للقطـاع الخاص على مراحل لاحقة من منافسة الدولة في مجال نشاطها. تكون نسبة خصخصة مؤسسات ومشاريع الدولة قد جاوزت الـ 90%.
المرحلة الأخيرة
أي الوصول بالاقتصــــــــــاد الوطني إلى مرحلة تحسين معامل راس المـــال الإنتاجي (Capital Output Ratio) أي حدوث توسع ملموس في الطاقة الاستيعابية لتشغيل أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة وتحقيق قدر من إعادة التوزيع للدخل القومي وزيادته بشكل ملحوظ وتحقيق تغييرات إيجابية في تركيبة الطلب الكلي نوعاً وكماً وأخيراً تحقيق التوسع الأفقي و
ثم العمودي المنشود.
أن تحقيق مثل هذه المراحل وهي في حقيقة الأمر مراحل الانتقال من رأسمالية وهيمنة الدولة على مجمل النشاط الاقتصادي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لجهة اقتصاد السوق أي اعتماد قضايا المتعلقة بالخصخصة الإيجابيـة بالشكل الذي لا يتيح مجالاً للثغرات والهفوات التي رافقت عمليات الإصلاح الاقتصادي وخاصة تلك المتعلقة بالخصخصة التي فتحت آفاقاً كبيرة للثراء والجريمة الاقتصادية في بلدان ما بعد الاشتراكيـة ومنها الجمهورية التشيكية المتطورة أصلاً قياساً بباقي البلدان الاشتراكيــة الأخرى سابقاً، مما أدى إلى خلق إختناقات اقتصـــادية كبيرة وبالتالي إلى إخفاق في مجمل السياسة الاقتصادية التي تبنت اقتصاد السوق والليبراليــــة الشاملة (وصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 10% وهبوط تام في معدلات الإنتــــاج في القطـاع الصناعي وتدهور كبير في مستوى الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الفساد الإداري وعمليات النصب والاحتيال وتفاقم ظاهرة الرشوة وتصاعد في معدلات الجريمة العادية والمنظمة).
أذن يمكن القول أن هدف الخصخصة والانفتاح الاقتصادي يكمن في قضية تصحيح المسار الاقتصادي، وحماية المال العام من الهدر باستمرار تراكم الخسائر لمؤسسات ومشاريع الدولة (التخلص من المشروعات الحكومية الخاسرة) رفع الكفاءة الاقتصادية، توسيع قاعدة الملكية، وزيادة الإنتاجية، وزيادة الربحية، وزيادة القدرة التصديرية. في هذا السياق يجب اتخاذ الحيطة والحذر من مساهمة الاستثمارات الأجنبية في مزاولة النشاط الاقتصادي وذلك من منطلق الاستثمار الإنتاجي غير الخدمي. في كثير من الأحيان نجد أن الاستثمارات الأجنبيـة يمكن أن تلعب دوراً إيجابيا إن كانت موجهة صوب الصناعات التحويلية ذات الطابع التكنولوجي العالي ويمكن القبول بهذه الاستثمارات في حقول الاستخراج بقدر مساهمتها الفعالة في زيادة إجمالي الناتج الوطنـي وبقدر ما يخدم قضيـــة نقل التكنولوجيا المتطورة ومن ثم خلق الفرص لاستثمارات مستحدثة.
أن بلداً كالعـراق وما يملكه من قدرات مادية وطاقات إنتاجية وثروات طبيعية لا يفترض أن يكون اقتصاده ذو طابع انفتاحي مطلق، بل اقتصاده يجب أن يكون مرناً مع سوق راس المال الوطني وتشجيع القطاع الخاص في خلق قيمة مضافة تستخدم لغايات التنمية الشاملة. ويمكن الاستفادة في هذا المجال من التجربة المصرية في عملية الخصخصة والتي يمكن اعتبارها ناجحة نسبياً بالقياس مع الأردن أو الدول الشرقية السابقة.
كان بودنا سرد وقائع رقمية عن الاقتصاد الوطني لبلادنا ولكننا على قناعة تامة بان مصادر كافة الإحصاءات المتوفرة متأتية من خلال الصحافة أو التصريحات التي يدلي بها هذا أو ذاك من المسؤولين في العراق أو من قبل معارضتنا الوطنية كما أسلفنا. ولكن رغم هـذه الحقيقة المرة لابد من التأكيد على جانب وهو الأهم في موضوع السياسة الاقتصادية والموقف من عمليات الخصخصة مفادها أن مثل هذه الأرقام عن الاقتصاد المشلول الذي هو عليه عراق اليوم لا يمكن أن يكون مرجعاً لدراسة علمية، بل هو منطلق لإعادة النظر في مجمل النشاط الاقتصادي وإعادة النظر في دور كل من القطاع الخاص ودور الدولة المركزي. وبصدد وضع الآليـة القادرة على تحقيق الأهداف، تحضرنا الذاكرة أن للعراق وعلى مدى الأربعين عام مجلسا للتخطيط وضع السياسة الاقتصادية للبلاد ظل بمثـابة كتلة جليد لا يراد لها أن تذوب، بعكس مجلس الأعمار في العهد الملكي، رغم شح الموارد المالية، أتسم بالحيوية والديناميكية، وتمكن خلال فترة قصيرة جداً من وضع سياسية اقتصادية مباركة مع جدول زمني لتنفيـــذ العشرات من المشاريع الصناعية والزراعية والسدود والإسكان والمستشفيات، تم تنفيذ قسم منها والباقي تعطل بسبب انقلاب تموز. لذا نرى أن الضرورة تقتضي اعتماد حكومة يتم اختيارها على أسس تكنوقراطية بحتة (غير مسيسة) لتنفيذ سياسة اقتصادية ناجعة.
وفي الختام أقترح أن يتضمن البرنامج الاقتصادي للعراق كل القضايا التي تم طرحها وذلك من خلال فرق عمل:
أولاً :
فريق عمل متخصص بالسياسة الاقتصادية لوضع الإطار العام للنظام الاقتصادي المنشود ضمن اللجان التالية:
– لجنة لإعادة الهيكلية في القطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي.
– لجنة متخصصة بالسياسة المالية والنقدية.
– هيئة للتطوير الصناعي وإعادة هيكليته.
– هيئة التطوير الزراعي.
– لجنة الطاقة والصناعة النفطية ،،، وهنا نقترح دمج وزارتي الطاقة والكهرباء – عادة ما شكت وزارة الكهرباء عن عدم تزويد وزارة الطاقة بالوقود لتحسين الوضع الكهربائي للمواطن وللمشاريع الحكومية المتلكئة اساسا.
– لجنة خاصة بالصناعة السياحية.
– لجنة نقل التكنولوجيا.
–
ثانياً:
فريق عمل خاص بعملية الخصخصة ضمن اللجان التالية:
– اللجنة الصناعية – اللجنة الزراعية – لجنة الخدمات (البنية التحتية) – لجنة المصارف والبنوك – لجنة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
[1] . استاذ لمادة الاقتصاد الدولي والنظريات الاقتصادية (1976-2014). رئيس لجنة المشاريع الصناعية في وزارة الصناعات الخفيفة (1980-1985). مدير مركز الدراسات الدولية في الاردن (1995). مستشار في الخارجية التشيكية لشؤون الشرق الاوسط (2004-2011). دبلوماسي وممثلا للحكومة التشيكية في العراق والجزائر ومالي (2006-2011). استاذ في الجامعة المستنصرية ومدير مركز الدراسات الدولية والعربية في الجامعة المستنصرية (2011-2014) . سجين سياسي (1990-1993) وله ستة اشقاء تم اعدامهم من قبل نظام صدام حسين (1980-1981).