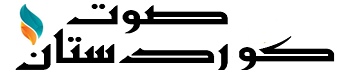في خضم هذا العصر المضطرب، حيث تتداخل الخطوط بين السيادة والخضوع، وبين الاستقلال والتبعية، تطفو على السطح أسئلة وجودية تُقلب موازين السياسة وتكشف عن تناقضاتها. فهل يمكن لدولة أن تحافظ على قرارها السيادي بين فكي كماشة القوى العظمى؟ وهل تُصنع القرارات في العواصم الصاعدة أم تُفرض من مراكز النفوذ العالمية؟ هذه التساؤلات ليست مجرد تنظير فلسفي، بل هي جوهر الصراع الذي تعيشه تركيا اليوم، حيث تُختزل إرادة الشعوب في معادلات المصالح، وتُسحق المبادئ تحت أقدام البراغماتية.
السيادة المُسْتَباحة: بين التبعية ووهم الاستقلال
يُثار الآن جدلٌ محتدم حول طبيعة العلاقة بين أنقرة وواشنطن، خاصة بعد التصريحات المثيرة لـ “أوزغور أوزيل”، التي تتهم النظام التركي بالخضوع لإملاءات ترامب في قضية اعتقال “إكرام إمام أوغلو”. لكن الوزير التركي يرد بحدة: “من السخف الظن أننا نحتاج إذنًا من أي طرف لاتخاذ قراراتنا!” إلا أن هذه الكلمات، رغم بلاغتها، تتحول إلى سراب عندما نرى كيف تُدار الخيوط في الخفاء. فالقوة لا تعترف بالخطابات، بل بالوقائع، والحقيقة أن تركيا، كغيرها من الدول الواقعة في فلك النفوذ الأمريكي، تتحرك ضمن مساحات مُحددة سلفًا، حتى لو تظاهرت بالتمرد.
إن ادعاء أن الاعتقالات السياسية تتم بتنسيق مباشر مع البيت الأبيض قد يكون مبالغًا فيه، لكنه ليس بعيدًا عن روح العصر. فالدول الكبرى لا تحتاج إلى إعطاء أوامر صريحة، بل تكفي إشارات ضمنية، أو صمتٌ مُطبق، لتمرير ما تريد. وعندما يُعلن المتحدث الأمريكي أن بلاده “لا تتدخل في الشؤون الداخلية”، فهذا لا يعني الحياد، بل يعني القبول الواضح بما يجري، شرط ألا يتعارض مع المصالح الأمريكية. وهنا تكمن المفارقة: فبينما تُصور تركيا نفسها كقوة إقليمية مستقلة، فإنها في الحقيقة ترقص على إيقاع العولمة، حيث تُباع المبادئ وتُشترى الولاءات.
المعارضة وخطيئة التبسيط: عندما يتحول الحليف إلى خصم
تقع المعارضة التركية في فخ التبسيط السطحي حينما تحوّل ترامب إلى شيطانٍ مسؤول عن كل انتهاكات النظام. فهذا الخطاب العاطفي، رغم مشروعيته الأخلاقية، يخالف قواعد اللعبة الدبلوماسية. فبدلًا من اتهام واشنطن مباشرةً بالتواطؤ، كان الأجدى بها كشف التناقض الأمريكي: كيف يتغاضى ترامب عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بينما يرفع شعار الديمقراطية في أماكن أخرى؟ كيف يُطلق سراح القس “برانسون” تحت التهديد بالعقوبات، بينما يُترك إمام أوغلو رهينة الصفقات؟
إن السياسة لا تعترف بالعواطف، بل بالتحالفات المرحلية. فلو أن المعارضة ركزت على فضح ازدواجية المعايير الأمريكية، بدلًا من تحويل ترامب إلى عدو، لربما كسبت تعاطفًا دوليًا أوسع. لكن الخطاب الثوري الأجوف، دون فهمٍ لمعادلات القوة، يُحوّل الحلفاء المحتملين إلى خصوم، ويُغلق الأبواب قبل فتحها.
القس برانسون: درس في فن الابتزاز الدبلوماسي
عندما قال ترامب إنه “استعاد القس برانسون بسهولة لأن علاقته بأردوغان جيدة”، كان يختزل قصةً أكثر تعقيدًا. فالحقيقة أن الإفراج عن برانسون لم يكن ثمرةً للحب، بل للتهديد الصريح. فتصريح نائب الرئيس الأمريكي آنذاك، مايك بنس، كان واضحًا: “العقوبات ستُفرض على عائلة أردوغان وشركاته إن لم يطلقوا سراحه!” هذه هي لغة القوة التي لا تعترف بالمجاملة.
لكن الأهم من ذلك هو ما يكشفه هذا الموقف عن طبيعة العلاقة بين الدول: فالقوي لا يطلب، بل يُملي. والضعيف لا يُقاوم، بل يتنازل. وإذا كانت تركيا قد أفرجت عن برانسون خوفًا من العقوبات، فما الذي يضمن أنها لن تفعل المثل في قضايا أخرى؟ أين تكمن السيادة الحقيقية في ظل هذا النموذج من العلاقات غير المتكافئة؟
سوريا وغزة: المسرح الذي تُقاس فيه المصالح
في كلمته الأخيرة، كشف ترامب النقاب عن جزءٍ من الصفقة: فتركيا، عبر وكلائها في سوريا، تُشكل ورقة ضغط في يد واشنطن. لكن أردوغان، خوفًا من المحاسبة، ينكر ذلك أمام الملأ. وفي المقابل، يُصرّ نتنياهو على منع الوجود التركي في سوريا، باعتباره تهديدًا لأمن إسرائيل. وهنا نرى المشهد بكامل بشاعته: فبينما تُخطط إسرائيل لتهجير ملايين الفلسطينيين من غزة، تقف تركيا موقف المتفرج، وكأنها تكتفي بالخطابات الرنانة دون فعلٍ حقيقي.
إنها معادلة مُعقدة: فتركيا تتلقى صفعات الدبلوماسية صامتةً في سوريا، وتتنازل عن دورها في فلسطين، كل ذلك في سبيل الحفاظ على شراكتها الواهية مع واشنطن. لكن إلى متى يمكن لهذا المسرح الهش أن يستمر؟
الانهيار الاقتصادي: عندما يُسحق القانون، تتدمر الثروات
بينما تنشغل النخبة التركية بصراعاتها السياسية، ينزف الاقتصاد. فخسارة 40 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي في أشهر قليلة ليست مجرد رقم، بل هي صرخة مدوية تُعلن انهيار الثقة. فعندما يُهان القضاء، وتُلغى الضوابط، لا ينهار فقط حكم القانون، بل ينهار معه الاستقرار المالي. والآن، تُحاول السلطات كبح جماح الدولار بحرق الاحتياطيات، لكن هذه سياسةٌ أشبه بإطفاء حريقٍ بالبنزين. فالثمن سيدفعه الشعب، كما هو الحال دائمًا، بينما تتنعم النخب بثمار الفساد.
الخلاصة: هل من مخرج؟
على المعارضة أن تتعلم من دروس التاريخ. فبدلًا من الانخراط في خطاب التهريج العاطفي، عليها أن تتبنى لغة السياسة الواقعية:
فضح الصفقات الخفية بين أردوغان وترامب، وكيف تُباع السيادة الوطنية في سوق المساومات.
كشف التناقض الأمريكي بين شعارات الديمقراطية ودعم الأنظمة الاستبدادية.
بناء تحالفات دولية ذكية، بعيدًا عن الخطابات العدائية غير المجدية.
ففي النهاية، السياسة ليست معركة مبادئ فحسب، بل هي أيضًا معركة مصالح. ومن لا يفهم قواعد اللعبة، سيُدفع ثمن جهله، وستدفعه الأجيال القادمة من بعده.
بوتان زيباري
السويد
09.04.2025