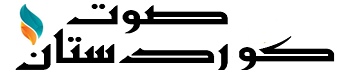إنما يبدأ المشهد حين تتراقص الخطابات على أنغام العواصف، ويخرج العقل والفؤاد حائرين بين وجع الواقع وشجن الرجاء، كأنه شاعٍ يلقى على شفتيه ضوء القمر وضباب الغموض معًا؛ فلا نملك إلا أن نتساءل: هل نحن من يرسم خارطة الصراع، أم أن الصراع هو من يرسم خارائطنا؟ (حقًا، يبدو أن زحام الأحداث أعقد من قوائم التسوق الأسبوعية!).
في قلب هذه اللوحة المشتعلة، تلمع إيران كشهابٍ مترددٍ بين صهيل الجيوش وظلال المفاوضات النووية؛ لقاء عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي في مسقط كساعةٍ ذهبيّةٍ قصيرة العمر، قالوا عنها “إيجابية” و”معتدلة”، إلا أن سكون الكلمات لا يعزف مقطوعة الأمان. لقد تعلم الإيرانيون الدرس مرّاتٍ؛ حيث يعلم المرء أن العافية لا تولد من تسليم السلاح؛ وإنّ خامنئي الذي حثّ على اليقظة العسكرية، قد يكون أدرى منّا بأنّ الابتسامات الدبلوماسية أحيانًا لا تغني عن برميل ماء عندما تشتعل الأعيرة (وهي ليست نكتة، فبرميل الماء في هذا الجوّ ذهب!).
أما العراق، فقد صار رقعة الشطرنج القادمة في لعبة نفوذٍ ضخم؛ بعد تآكل قوة “حزب الله” في لبنان وتراجع حليف دمشق، وجد الإيرانيّ صندوق مصالحه يئن تحت وطأة الواقع العراقي. زيارة السوداني لأربيل لم تكن جولة سياحية، بل فصل احتفالي من مسرح التوازن بين بغداد وأربيل، وكأنه يحاول أن يربط حبلًا مشدودًا بين قطبين متصارعين دون أن يفلت طرفاه (أتعلمون؟ أشعر أحيانًا أن المشهد العراقي يذكرني بمحاولة ربط حذاء في عاصفة رملية!).
وعندما نتأمل ملفّ النفط، تتعالى الأصوات كأنها جوقةٌ متنافرة الألحان: بغداد التي تصرّ على “حصرية التوقيع”، وإقليم كوردستان المنتشي بأحلامه الفيدرالية، وشركات النفط الأجنبية التي اختارت الانسحاب كمن يهرب من جلسة امتحان صعبة. أما الموظفون الوهميون في صفوف البيشمركة، فيظهرون كطيفٍ كوميديٍّ مريرٍ؛ يتقاضون رواتبٍ متعددةً دون أن يعرف أحدٌ إن كانوا يقاتلون داعش حقًّا أم يلوّنون الأرقام في تقاريرهم!
ولا تنتهي الأنية السياسية العراقية عند النفط، بل تمدّ إلى تراب كركوك المتنازع عليه: تلك القطعة الدافئة التي تمتلك الحصّة الأكبر من الدموع والدهاء، كل طرفٍ يلوّح بالمادة 140 وكأنها عصا سحرية، فتقرأ النزاعات بين بغداد وأربيل كأنها رواية لا تنتهي فصولها، ولا تقتصر على النفط وحسب، بل تتجاوزه إلى الرواتب والموارد والهوية، وكأنّ لكلّ صخرةٍ في التلال كاتبًا سياسيًا ينتظر نشر مذكراته (لكنني أعترف، أنا أيضًا أود قراءة تلك المذكرات!).
وفي سوريّا، حيث العتمة أحيانًا أشدّ ظلمةً من غياب الكهرباء نفسها، تنضج المعادلات في منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، فيما أحمد أشارى يتلقّى العناق الدافئ من تركيا لأجل صورٍ تقليديةٍ لم تخلُ من الرسائل: “من يصافح تركيا يصافح السلطة”، كأنها قصيدةٌ صامتة، ورؤيةٌ مضمخةٌ بالرياء الدبلوماسي، فقد أرادت أمريكا أن تلوّح بباطنها الإنساني، لكنها نسيت أن بعض الأقنعة لا تخفي سوى إرهاصات التدخل والاستعمار الحديث (ولا بأس، فربما لو أن الألقاب بدلًا من الانحناءات!).
ولا يغيب عن المشهد قطاع الخلافات الخليجية، حيث تتنقل قطر بين الخط الأمريكي والغاز العربي، وتلوّح الإمارات بدفئ إسرائيل كقربانٍ سياسيٍّ، فيما السعودية تسير بحذرٍ بين ضفاف المصالح، فتقدّم خمسة عشر مليون دولار للمونديال السوري الإعمار، وكأنها تضع ضغطة قلب على صدرٍ غارقٍ في الأزمات، محاولةً أن توازن بين النجاة والإفلات من قبضتيّ إيران وتركيا (صحيح، قد يبدو الأمر أشبه بلعبة شدّ الحبل، لكن من قال إن السياسة لعبة ربيعية؟).
أما في شمال شرق سوريا، فتلوح شبح الفيدرالية التي قيل أنها قريبةٌ؛ نشرت رويترز خبراً عن إعلان قادم، لكنّ الحقيقة أن خطوات القوم تحتاج موافقة أنقرة أولاً، ورضى القوات شبه الذاتية ثانيًا؛ فقد صار الميدان السياسي هناك أشبه بفصلٍ في كتابٍ لم يكتبه أبطاله بعد، ولا ندري إن كانوا سيدقّون أبواب الرياض أم واشنطن أو موسكو قبل كتبته الأخيرة!
وعندما نلتفت إلى لبنان، نرى حياةً نصفها أشباح وذكريات؛ الذكرى الخمسون للحرب الأهلية لا تزال حيةً في جدران بيروت المتشققة، وحين نتحدّث عن تسليم سلاح حزب الله، يبدو الأمر أشبه بمحاولة إزالة وشمٍ عميق لا تزيله إلا جراحةٌ سياسيةٌ مؤلمة. أما الجيش اللبناني، فيحاول التمهّد خطوةً هنا وأخرى هناك، كراقصٍ محترفٍ يتفادى عيدان الموسيقى المتكسرة (حقًا، لبنان مسرحٌ يحتاج لاعبي أغرابٍ محترفين!).
وفي قطاع غزة، ترتفع أعداد القتلى إلى نحو إحدى وخمسين ألفًا منذ ثامن أكتوبر، حيث لم يعرف الدم معنى الرحمة، وأضحى الأطفال والنساء سجّادًا للمدافع، وفي ظل فشل مباحثات القاهرة، تستمر الأمل والدموع يدًا بيد كالرقص الأخير في مقهى خالٍ من الدخان (يا له من خيالٍ قاتمٍ! لكن ربما لا بدّ من لحظةٍ للتبسم وسط الحزن!).
ثم ينفتح الباب أمام الضفة الغربية، حيث تُلاحق إسرائيل أي نفسٍ محملقٍ بالأمل، فتزيد هجماتها، والمقاومة الفلسطينية تحاول تأرجح الموازين بينما محمود عباس البالغ تسعين ربيعًا يُغيّر الضباط بأخرى تحمل صورة شبابه القديم، كأنما يقول: “لا تتركوني وشأني في هذا المسرح الهزلي!”– ونحن نجيب: لا تقلق، سيبقى الكرسي لك حتى ينهار المسرح وحده.
وأخيرًا، تعلو الأسئلة في لحظةٍ أخيرةٍ من جمهورٍ متلهفٍ، عن احتمالات اعتداء أمريكي–إسرائيلي على إيران، وعن الدور القادم للعراق، وعن لجنة مكافحة داعش المشتركة، فتأتي الإجابة وكأنها تمتمةٌ فلكلوريةٌ تئنّ تحت وطأة عدم اليقين: “كل شيء ممكن، وكل شيء مرهونٌ بوميض القرار وحراك الأقدام، فلننتظر الفصول القادمة من هذا الكتاب المفتوح…” وكأن الحاضر يختبئ في زاوية الغياب، والقرار يوشك أن يولد في بطن الانكسار.
في ختام هذه السمفونية المتنافرة الأوتار، يلوح الأمل كشمعةٍ خافتةٍ في باحةٍ مظلمةٍ، صار للناس فيها ألف وجهٍ ووجه، وكلٌ يقرأ خريطة العالم من نافذة دربه، متيقنين أن الحكمة لا تكمن في مراكمة الأقوال وحدها، بل في تناغم الفعل مع استحضار مآلاته، وحتى نضحك من القلب قليلًا، فلنذكر أن اللعبة الكبرى قد تكون في طريقة جلوسنا على الكراسي، ومحاولة الالتفاف على جاذبيةٍ لا ترحم الكبار قبل الصغار!
بوتان زيباري
السويد
17.04.2025