في مشهدٍ سياسيٍّ تتداخل فيه أطياف الرغبة بالخلاص مع أشباح الخوف من الانقسام، تبرز مجددًا قضية “الحل السياسي في تركيا”، لا كمجرد نقاشٍ محليٍّ داخلي، بل كحلقةٍ في سلسلة متشابكة من صراعات الشرق الأوسط التي تعزف على أوتار الطائفية والقومية والتدخلات الخارجية. تلك القضية التي لطالما نُوقشت من زوايا متفرقة، تستوجب اليوم قراءة أكثر عمقًا، تستحضر روح اللحظة التاريخية، وتستنطق طبقات المعنى بين سطور التصريحات وتحركات اللاعبين على رقعة الشطرنج الإقليمي.
ليس غريبًا أن يتجدد الجدل بين رؤيتين متناقضتين، لكنهما تشتركان في الذعر ذاته؛ الأولى ترى أن مسار الحل السياسي سيقود إلى تفكيك الدولة، متكئةً على تاريخ طويل من الهواجس القومية ونظريات المؤامرة، تغذيها نخب إعلامية تُمثل بقايا الدولة العميقة، تلك التي لطالما اعتبرت التعددية تهديدًا لا ثراءً. أما الثانية، فتتمسك بعكس ذلك: إن لم يُكتب للحل أن يسير، فالانقسام قادم لا محالة. هنا ندخل مدار السخرية السوداء: هل البلاد تُهدد بالتقسيم إن حلت مشكلتها أم إن تجاهلتها؟!
وسط هذا الضجيج، يطل نُعمان كورتولموش، رئيس البرلمان التركي، في خطابٍ يضرب على وتر المصير. يصوّر الرجل اللحظة وكأنها مفترق طرق لا ثالث لهما: إما أن يُترك الشعب ينتظر مصيره المحتوم كما تُرك “الثور الأصفر” في المثل الشعبي ليكون الضحية القادمة، أو أن يتكاتف الأتراك والكورد ليشقوا طريقًا موحدًا نحو “تركيا قوية”. الطرح بحد ذاته ليس جديدًا، لكن اللافت هو أن يصدر من أحد أعمدة السلطة، رجلٌ ينهل من بئر الإسلام السياسي، ويتربع في قلب منظومة الحكم، لا على هامشها.
خطورة ما قاله كورتولموش لا تكمن في نبرته العاطفية، بل في استدعائه لأمثلة مريرة من الجوار: العراق الذي انقسم شارعًا بعد شارع منذ الاجتياح الأميركي، وسوريا التي تمزقت طائفيًا وعرقيًا تحت سكاكين الخارج والداخل معًا. يلوّح كورتولموش بشبح هذين المثالين وكأن تركيا على أعتاب المصير ذاته، إن لم تتدارك نفسها. لكنه، دون أن يدري ربما، يفتح نافذة نحو مفارقة تاريخية، إذ إن الجهات التي ساهمت في تمزيق الجوار هي نفسها التي استعانت بها أنقرة في يومٍ ما: دعمت، سلّحت، مرّرت قوافل السلاح، وساهمت – طوعًا أو جهلًا – في تفكيك سوريا تحت شعارات الحرية حينًا، والمصالح الاستراتيجية حينًا آخر.
وهنا تكمن النكتة السوداء في قلب الخطاب السياسي. كأن من أشعل النار بالأمس، يطل اليوم على الرماد ليتحسر على فقدان الظلال. من درّب جماعاتٍ باسم “الجيش الحر”، ومن فتح الطرق أمام عربات الموت، يطالب اليوم بالحكمة، وكأن التاريخ لا يملك ذاكرة، وكأن الخرائط لا تنزف.
فإذا كانت السلطة تقول الآن بلسانٍ رسمي: “إن لم نجد حلاً، ستنقسم البلاد”، فإن هذا التصريح يكشف – لا عن شجاعة – بل عن إدراكٍ متأخرٍ بأن السياسات السابقة وصلت إلى طريقٍ مسدود. تصريحٌ كهذا لا يمكن فهمه إلا كتسليم، ولو غير مباشر، بأن الدولة باتت في مفترقٍ لا يحتمل التردد. فإما مراجعة جذرية تُفضي إلى شراكة تاريخية بين الكورد والأتراك، أو استمرار في المراوغة سيقود، ولو بعد حين، إلى انهيار البنيان من الداخل.
وليس سراً أن ما يُدار الآن خلف الكواليس لا يخرج عن سياق ضغوط خارجية تمارسها قوى دولية كأميركا وبريطانيا، التي تدفع بوضوح نحو أحد خيارين: إما التفاهم مع الداخل الكوردي، أو التشرذم والانقسام، وربما زوال السلطة. هذا ليس حبًا في الكورد، ولا حرصًا على ديمقراطية مزعومة، بل لأن ميزان المصالح اقتضى هذا الاتجاه، تمامًا كما اقتضى تمزيق العراق وسوريا من قبل.
من هنا نفهم لماذا تُستأنف المحادثات مع عبد الله أوجلان بعد جفاءٍ دام أكثر من عام. لا من باب القناعة، بل من باب الضرورة. وشتان بين من يسعى نحو التفاهم انطلاقًا من إيمانٍ بالعدالة، وبين من يجره الواقع جراً نحو طاولةٍ لم يكن يومًا راغبًا في الجلوس عليها.
وإذا كانت القوى الكوردية – لا سيما قاعدة DEM – تستعد للانخراط في لجنةٍ برلمانية جديدة تُعنى بالمسألة، فإننا أمام مشهد برلماني يبدو، في ظاهره، تعدديًا، لكنه في جوهره محكومٌ بحسابات الأكثرية والاصطفافات. فحتى إن امتنعت أحزاب كـ”الجيد” أو “الرفاه” عن المشاركة، فإن ثقل التحالف الحاكم، بمساندة من DEM، كفيل بتمرير ما يشاء، ما دامت الحسابات الرقمية تسبق الرؤى الأخلاقية.
أما المعارضة التقليدية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، فقد أدركت أخيرًا أن تجاهل التحولات الجارية ليس سوى انتحار سياسي. فالصعود الأخير للشعبوية الإسلامية القومية لم يكن نتاج فراغ، بل ثمرة سنوات من التعامي عن الواقع. واليوم، حين تستفيق “الكمالية” على وقع الخسارات، تتلمس طريق العودة من خلال انخراطها في المسار الجديد، لا حبًا في الكورد أو اعترافًا بوجعهم، بل خشية من أن تُترك خارج قطار التحولات القادمة.
في حين تتباين مواقف الأحزاب الصغرى، بين من يرى في المشاركة مجرد ديكور لا يقدم ولا يؤخر، ومن ينتظر أن يُطرق بابه من قِبل الدولة ليمنحه شعورًا زائفًا بالندية، فإن السؤال الحقيقي يظل: هل ما يُبنى الآن مشروع حقيقي لتعايشٍ سياسي؟ أم مجرد مخرج تكتيكي لنظامٍ مأزوم يبحث عن بقاء مؤقت في ظل أعاصير تتشكل شرقًا وغربًا؟
لعلنا نعيش الآن فصلًا جديدًا من فصول “الاضطرار السياسي”، حيث يتحول العناد إلى مرونة، والتجاهل إلى اعتراف، لا حبًا في الديمقراطية، بل استجابة لمعادلات دولية تعيد رسم خرائط النفوذ بخطوط غير مرئية. في هذا السياق، لا بد للكورد أن يدركوا جيدًا أن ما يُقدّم اليوم ليس منحة، بل فرصة، وأن القبول بالمشاركة لا يعني الارتهان، بل الاشتباك الواعي مع مشروعٍ مفتوح على كل الاحتمالات.
إننا أمام لحظةٍ مفصلية تتشابك فيها حسابات الداخل بجراح الجوار، وتتكشف فيها نوايا اللاعبين على رقعة الشرق الأوسط، من واشنطن إلى أنقرة، ومن أربيل إلى دمشق. لحظة تقتضي حذرًا في الخطاب، وجرأة في الفعل، وذاكرةً لا تخون.
وفي النهاية، حين يصبح الصمت تواطؤًا، والكلام مجرد غبار، يبقى وحده التاريخ من يملك رفاهية الحكم: من اختار الوحدة بعقل، ومن لوّح بها كحبل نجاة بعد أن غرقت السفينة.
بوتان زيباري
السويد
26.05.2025
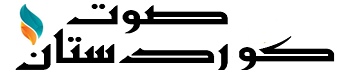




العبارة “إما أن يُترك الشعب ينتظر مصيره المحتوم كما تُرك ‘الثور الأصفر’ في المثل الشعبي” تستخدم استعارة مستمدة من مثل شعبي مشهور في بعض الثقافات، لا سيما في البيئات التي تأثرت بالأمثال المتوارثة عن القصص الحيوانية الرمزية.
أصل المثل:المثل الذي يُستند إليه هنا هو مثل الثيران الثلاثة، والذي يروى كالتالي:
كان هناك ثلاثة ثيران: أبيض وأسود وأصفر (أو أحمر في بعض الروايات)، وكان هناك أسد يريد أن يفترسهم، لكنه لم يكن يستطيع عليهم مجتمعين. فذهب إلى الثور الأسود أو الأصفر وقال له: “دعني آكل الثور الأبيض، فهو لا يشبهك، وسأتركك وشأنك”، فوافق. ثم عاد بعد فترة وطلب من الآخر أن يسمح له بأكل الثور الثاني، فوافق أيضًا. وعندما لم يبقَ إلا ثور واحد، أكله الأسد بسهولة، بعد أن تخلّى عنه رفاقه.
وفي بعض الصيغ يُقال إن الثور الأصفر أو الأسود قال في النهاية: “أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثور الأبيض”، أي أن مصيره المحتوم كان قد بدأ لحظة قبوله بالتخلي عن رفيقه.
معنى العبارة:الكاتب هنا يقارن وضع الشعب بـالثور الأصفر الذي تُرك لمصيره بعد أن تم التواطؤ على رفاقه. فالشعب في هذا السياق يُصوَّر على أنه مهدد بخطر داهم، وقد تُرك لمصيره من قبل الآخرين (ربما النخب، أو القوى الكبرى، أو حتى حلفاء سابقين)، تمامًا كما تُرك الثور الأصفر يواجه مصيره بمفرده، بعد أن تم التواطؤ أو الصمت على افتراس الثور الأبيض.
المعنى العميق:
هذا التعبير يختزن تحذيرًا أخلاقيًا وسياسيًا: أن الصمت عن الظلم حين يقع على غيرنا، أو التخلي عن رفاق الطريق، سيؤدي حتمًا إلى أن يأتي الدور علينا، وحينها لن نجد من يقف معنا. فالانتظار السلبي لمصير محتوم، دون مقاومة أو تضامن، هو بمثابة توقيع على حكم الإعدام المؤجل.
وفي الختام، العبارة مشحونة برمزية قاتمة، لكنها تسائل ضمير الجماعة: هل سننتظر أن نُؤكَل كما أُكِلَ الثور الأبيض، أم سنقف معًا قبل أن تُفترَس البقية؟