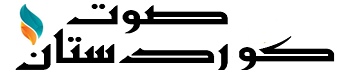-
يقولُ أدونيس إنَّ الشعرَ ليس مجردَ تعبيرٍ عَنْ الانفعالاتِ وَحدها، إنَّمَا هو رؤية متكاملة للإنسانِ وَالعَالم وَالأشياء، وَكُلُّ شاعرٍ كبير هو مفكرٌ كبير. وَلا أخفي سراً أَنَّ تمعّني فِي الرؤيةِ المذكورةِ آنفاً، كان مِنْ بَيْنِ أهمِ الأسباب المَوْضُوعِيَّة الَّتِي حفزتني للخوضِ فِي غمارٍ – مَا أتيح لي – مِنْ تجربةِ الشاعر الكبير يحيى السماوي بأبعادِها الإنسانيَّة، بعد أنْ تيقنتُ مِنْ سموِ منجزه الشعري المغمس بثراءٍ فكري وَحس وَطني وَوَعى عقلاني يعبرُ عَنْ إيمانٍ بسلامةِ الخطى وَوضوح الرؤية، فلا غرابةَ فِي أنْ يكونَ للإنسانِ وَالحبِ والجمالِ حضورٌ وجدانيٌّ فِي مَا تباينَ مِنْ أجناسِ نصوصِه الشعريةِ الرشيقةِ الأنيقة، والمؤطرةِ بذوقٍ عالٍ وحسٍ مرهف، بالإضافةِ إلى توشيمِ بعض فضاءات نصوصه الشعرية بمفرداتٍ منتخبةٍ بعنايةٍ وَدرايةٍ مِنْ مَوْرُوثنا الثَّقَافِيّ والاجْتِمَاعِيّ؛ مُوظِفاً مَا تكتنزه ذاكرته المتقدة المتوهجة مِنْ صورٍ مَا بَيْنَ طياتها، وَالَّتِي ظلت ملتصقة بوجدانِه وَلَمْ تفارقه، فثمَّةَ مفردات مِن التراثِ الشَعْبِيِّ مَا يَزال لها صدى فِي بعضِ نتاجاته الشعريَّة.
أَمْرٌ مُسَلَّمٌ بِهِ أنَّ المَوْهَبَةَ تُعَدُّ نعمةً مِنْ الباري – عزَّ وجلَّ – يَهبُهَا لمَنْ يشاء، إلا أَنَّها تبقى رهينة الرعاية وَالمتابعة كالنبتة الغضة الَّتِي تلزم مَنْ يعمل برعايتِها التعهد بسقايتِها وَبذل مَا يتوجب مِنْ جهودٍ أخرى؛ لأجلِ ضمان الاستفادة مِنْ ثمرِها أو التمتع بعطرِها وَجمال لون أزاهيرها. وَبحسبِ علماء التَّرْبِيَة وَعلم النفس يُعَدُّ اكتشاف مواهب الأبناء وَالطلاب مَن المهماتِ يسيرة الآليات بالنسبةِ إلى الآباءِ وَالمعلمين الحاذقين؛ بالنظرِ لظهورِ آثارها عَلَيهم سواءً فِي المنزلِ أو فِي المدرسة، مَنْ خلالِ قدراتهم الحركيَّة وَالانفعالية وَالتعبيرية، فضلاً عَنْ ردودِ أفعالهم وَاستجاباتهم مَعَ والديهم وَمعلميهم. وَليسَ خافياً أنَّ الموهوبينَ يشكلون الثروة الواعدة للأمة، وَمستقبل ازدهارها وَتفوقها إذا مَا أحسنت القيادات الإدارية رعايتهم، وسَعَتْ الإدارات المعنية – بجديةٍ وَدأب – إلى تبني مَا يفضي إلى تطويرِ ملكاتهم، وَلاسيَّما مَا يتعلق مِنها بمسألةِ توفير مَا يتطلب مِنْ رِّعايةٍ نَفْسِيَّة وَاجْتِماعِيَّة وَصِحِّيَّة، فضلاً عَنْ وضعِ البرامج الإرشادية الضامنة للنُمُوِّ النفسيِّ والعقليّ وَالاجْتِمَاعِيّ المتكامل.
المثيرُ للاهتمامِ أَنَّ للفقر بحسبِ المُتَخَصِّصين انعكاسات كبيرة عَلَى تمكينِ الأطفال مِنْ المُسْتَقْبَل بسببِ خطورة مَا يخلفه مِنْ آثارٍ سلبية عَلَى الأجيالِ الواعدة فِي الْمُجْتَمَعَاتِ النامية وَالفقيرة؛ بالنظرِ لسعةِ تأثيره فِي طبيعةِ المسارات الخاصة بعمليةِ إنضاج ذكاء الطفل، فضلاً عَنْ تحديدِ قدرته عَلَى الابتكارِ وَالتطوير فِي المُسْتَقْبَل، وَهو الأمر الَّذِي يقود إلى التوافقِ مع الرؤى الَّتِي تنحى باتجاه القول إنَّ الفقرَ يُعَدُّ حاجزًا أمام الأطفال وَأسرهم بفعلِ افتقارهم إلى فرصةِ الانخراط داخل الْمُجْتَمَع وَالاندماج بفضاءاتِه الَّتِي تتيح للأطفالِ إمكانية استغلال مَا متاح مِنْ القنواتِ الَّتِي بوسعِها تقديم خدمة تبادل العلم وَالمعرفة، فمَا أظننا نغلو فِي القولِ أنَّ الكثيرَ مِن الأطفال – الَّذين كانوا بحاجةٍ إلى تنميةِ ذكائهم الفطري المتقد وَإثرائه بالعلم – خضعوا لقسوةِ الخيارات القسرية المتمثلة باضطرارِ أسرهم لإبعادِهم عَنْ المدارس؛ بالنظرِ لإخفاقِهم فِي تدبيرِ موارد الإنفاق عَلَى مراحلِ التَّعْلِيم المختلفة، فلا غرابَة فِي ركونِ هؤلاء الأطفال إلى أعمالٍ لا تساعد عَلَى الابتكار، أو حتى المساهمة فِي تعلمِ مهنة، أو حرفة بعينها.
فِي السياقِ ذاته، يشير خبراء فِي بعضِ المنظمات الأممية إلى خطورةِ انعكاسات ظاهرةِ الفقر عَلَى الأطفال، وَأَدْهَى مِنْ ذلك تأكيدهم عَلَى أنَّ اتساعَ دائرة الفقر فِي الدولِ النامية يفضي إلى إفرازِ آثارٍ تفوق بشدتِها مَا عرف مِنْ آثارِه الاقْتِصَادِيَة والاجْتِماعِيَّة، بالإضافةِ إلى غيرِها مِن التأثيراتِ الأخرى الَّتِي تعانيها الْمُجْتَمَعَات الفقيرة؛ إذ أَنَّ تَّرْبِيَةَ الأطفال فِي أحضانِ الفقر تُعَدُّ مِنْ بَيْنَ جملة العوامل المهمة الَّتِي مِنْ شأنِها المساهمة فِي ضياعِ مستقبل الأمم. وَمِنْ هُنَا فإننَا لا نبعد عَنْ الحقيقةِ إذا مَا قلنا إنَّ القياداتِ الإدارية فِي البلدانِ النامية ملزمةٌ بالسعي الحثيث مِنْ أجلِ إيجادِ السُّبُل الكفيلة فِي توجيه الأطفال؛ إذ أَنَّ ركونَ الْمُجْتَمَع إلى جعلِ الشعور بضعفِ الإمكانيات – بوصفِه مجتمعاً فقيراً – تبريراً لتركِ الأطفال مِنْ دُونِ توعيةٍ وَمَعْرِفة وَتَّعْلِيم، يُعَدُّ مِنْ أكبرِ الأخطاءِ الاستراتيجية، وَالَّتِي يترتب عَلَيها بلا ريب انغماس الحكومات بإغفال طاقاتِ أجيالٍ واعدة بوسعِها – فيما لو تيسرت لها ظروف التنشئة الصحيحة – المُسَاهَمَة فِي بناءِ مُسْتَقْبَل بلدانها، وَهو الأمر الَّذِي يفرض عَلَى حكوماتِ البلدان الفقيرة الحرص عَلَى جعلِ الأطفال نواةً لتطويرِ مُجْتَمَعاتها وَنهضةِ بلدانها مِنْ خلالِ تكريسِ كُلِّ جهودها قصد حمايتهم وَالسعي لإنتاجِ جيلٍ متعلم قادر عَلَى الابتكارِ والإبداع؛ إذ أَنَّ الدَّوْلَةَ ملزمةُ بضمانِ حقوق الأطفال المفروضة عَليها، وَالَّتِي يشكل الحق فِي الَتَّعْلِيمِ وَتبادل المعرفة أدنى حدودها.
إنَّ جُلَّ ما يهمنا مما ضمناه فِي السطورِ آنفاً هو محاولة سبر أغوار الظاهرة الإبداعية المائزة للشاعرِ يحيى السَمَاوي، وَالَّتِي كانت لَبنتها الأساسية مُكَّبَلة – مِنْ دُونِ أدنى شك – بتأثيرِ معاناته فِي طفولته مِنْ عاملِ الفقر الَّذِي كان يخيم عَلَى أجواءِ بلاده، بفعلِ استئثار الاقطاعيين وَقلة مِن الناس غيرهم بما تباين مِنْ ضخامةِ الثرواتِ الَّتِي حبا بها الخالق تبارك وتعالى أرض الرافدين، وَالَّذين كانت السادية تفرض عَلَيهم التلذذ بقهرِ الشرائح الاجْتِماعِيَّة المقهورة وَتعذيبها وَالسعي لترويضِها عَلَى العيشِ فِي الهامش، فضلاً عَنْ تفننِهم في محاولةِ جعل طبقة الفقراء والمعوزين تستجدي البسيط وَالمتواضع جداً مِنْ حقوقِها؛ نتيجة وقوعِ تلك المافيات الارستقراطية تحت نزعة التسلط وَهوس العظمة الَّتِي طغت عَلَى عقولِهم وَأعمت قلوبهم، فلا عجب أنْ تكون سماء البلاد ملبدة بغيومِ الظلم وَالاستبداد وَالاستلاب، وَالَّتِي كان مِنْ بَيْنَ كارثية آثارها تسيّد الجهل وَرداءة الخدمات الصحيةَ الَّتِي يمكن الاستدلال عَليها مِنْ خلالِ مَا حملته الوثائق التاريخية مِنْ معلوماتٍ تؤكد شيوع مَا تباين مِن الأمراضِ فِي الأوساطِ الشعبية، وَلاسيَّما مرض البلهارسيا الَّذِي أودى بحياةِ الآلاف مِنْ الأهالي فِي أريافِ البلاد، فضلاً عَنْ قلةِ المدارس. وكمثال عَلَى النهجِ الاستبدادي للإقطاع، كانت بعضِ مناطق البلاد الريفية حينئذ، وَلاسيَّما فِي لواءِ العمارة – محافظة ميسان حالياً – تعيش تحت وطأة قساوة الحياة بفعلِ أسلوب الضمان المعتمد فِي الزراعة، وَالَّذِي تقوم آلياته عَلَى عرضِ ” الشيخ ” الأرض – الَّتِي ضمنها مِن الدولةِ – على الفلاحين مقابل حصوله فِي موسمِ الحصاد عَلَى محصولٍ يقدر وزنه بالأطنان حتى فِي حال تعرض الفلاح إلى الخسارة بفعلِ مختلف العوامل، مَا يعني تسبب هذه السياسة فِي ظلمِ الفلاحين واستلاب حقوقهم.
آخـرُ مـا اكـتـشـفـتُ فـي
مـتـاهـةِ الـحـيـاهْ :
أنَّ الأسـى يُـمـكِـنُ أنْ يُـصـبـحَ نُـعـمـى
والـلـظـى مِـيـاهْ
فـكـلـمـا حـاصَـرَنـي الـحزنُ
وسَــدَّتْ بـابَ كـهـفـي صـخـرةُ الـيـأسِ
وشَــبَّ فـي حـشـاشـتـي لـهـيـبُ الـ ” آهْ “
يـصـيـرُ كـهـفـي روضـةً
والـلـيـلُ يـغـدو مُـشـمِـسـاً كـأنـهُ الـنـهـارُ فـي ضُـحـاهْ
حـيـن أصـيـحُ مـلءَ نـبـضـي :
يـاحـبـيـبـي الـلـهْ
***
كـلَّ يـومٍ
ألـتـقـي فـوقَ بـسـاطِ الـصَّـلـواتْ
بـحـبـيـبـي خـمـسَ مـرّاتٍ
ألا يـكـفـيـكِ يـا قـلـبـي ؟
عـلامَ الـعَـبَـراتْ !
***
الْمُلْفِتُ أَنَّ خطورةَ تداعيات الفقر، لَمْ يكن بوسعِها إعاقة مَا كان يطمح له السَماوي، حيث تدل معطيات مراحل رحلته الإبداعية عَلَى احتفاظِ موهبته بتوهجِها الَّذِي ساهم فِي جعلِه بفضلِ قيمة نتاجه الشعري منارة إنسانيَّة فِي المشهدِين المَحَلّيّ وَالعربي، لا تساوم عَلَى مَا حملت مِنْ مبادئ قصد كسب رضا السلطة الحاكمة، حيث ساهم – وَهو ينبض بالعطاءِ إلى يومِنا الحالي – فِي إثراءِ الحركة الأدبية العربية وَالإنسانيَّة مِنْ خلالِ مسيرةٍ طويلة حافلة بالجهدِ وَالتميزِ وَالنجاح، وَهو الأمر الَّذِي أهله لاحتلالِ مكانة بارزة ومرموقة فِي الوجدانِ العربي وَتسجيل بصمة بارزة فِي تاريخه وَفِي سفرِ الأدبِ الإنْسَانيّ. وَلا نبعد عَنْ الصَوَابِ إذا قُلْنَا إنَّ دعواتِ والدته وَتشجيع والده – طيب الله ثراهما – وَحفنة مِن المؤلفاتِ الَّتِي وجدت لها مستقراً فِي زاويةٍ مِنْ حجرةِ والده الطينية، فضلاً عَنْ موهبته وَشغفه بالقراءةِ كانت تمثل بمجملِها السبيل الَّذِي فتح لَه آفاقاً واسعة للاطلاع، وَالتعرف عَلَى ثراءِ المعرفة فِي بطونِ الكتب، حتى أصبحت المكتبة ملاذه الآمن الَّذِي نهل مِنْ بَيْن موجوداته المعرفة بأسرارِ اللغة ومَا أتيح له مِنْ بقية المعارف وَالعلوم، وَلاسيَّما مَا ينحى مِنها صوب التاريخ والموروثات الوطنية، فكان أن جعلت مِنه تلك العوامل – منذ أنْ أدرك الحياة – مناضلاً صلباً يرفض إفساد خصوبة أرض السواد بكثرةِ المقابر، وَيأبى الركون إلى مَا مِنْ شأنِه تكييف شعبه لاستعطافِ مَنْ يشفق لحالِه. وَقد أثمرت مساعي السماوي الذاتية ومحاولاته المصحوبة بقوةِ الإرادة عَنْ ولادةٍ مبكرة لشاعرٍ مقتدر تواصل عطاؤه – ومَا يزال – محققاً فِي مرحلةِ النضج مِما تباين مِنْ أجناسِ الشعرِ وَضروبه أبجديته الأدبية الَّتِي صاغ مِنْ قصيدِها بوحاً عبّر بلا رَيْبَ عما يعتلج في صدور الفقراء والمعوزين، حتى أصبح نتاجِه الأدبي الملامس لوجدانِ الإنْسَان وَهمومه يدخل النفس وَيخلق الدهشة وَالرضى لدى المتلقي، عَلَى الرغمِ مِنْ كثرةِ التحدياتِ الَّتِي واجهته في مسيرةِ حياته المليئة بخطورةِ مواقفِه الرافضة للانكفاءِ نحو المهادنة، والتجرد مِن القيمِ الَّتِي جبل عَلَيها ومَا آمن بِه مِنْ مبادئ إنسانيَّة تقوم عَلَى تحريرِ البشرِ والجهد مِنْ أجلِ إسعاده. وَلعلَّ خيرَ مصداقٍ عَلَى مَا تقدم هو مَا ورد فِي توطئةِ الشاعر والناقد هاتف بشبوش عند افتتاحه أمسية شعرية اقامها في نهاية عام 2017م بيت النخلة – تيار الديمقراطيين العراقيين – في مدينةِ كوبنهاكن الدنماركية احتفاءً بالشاعرِ يحيى السماوي، وَالَّتِي قال فِيها ” إنّ الشاعرَ يحيى السماوي يساري وَمناضل ينتمي لطبقةِ البسطاء وَالكادحين، عانى الكثير زمن البعث الفاشي فِي أقبيةِ السجون، وحُكم عليه بالموت، لكنّ الله مَنّ عليه بعمرٍ طويل وَنجا مِنْ حبلِ المشنقة ليُحبّ الناس أكثر وَأكثر “. وَفِي الأمسيةِ الشعرية ذاتها، كان مِنْ بَيْنَ جمهور الحاضرين صديقه القديم – المغترب فِي الدنمارك – القاص وَالروائي سلام إبراهيم، وَالَّذِي سعد بعناقه بعد فراق مَا يزيد عَلَى أربعةِ عقودٍ مِنْ الزمان، ثم مَا لبثَ أنْ كتبَ فِي صفحتِه عَلَى قناةِ التواصل الاجْتِمَاعِيّ حديثاً طويلاً عَنْ يحيى السَماوي بصيغةِ سرد تقريري، نقتطف مِنه مَا يشكل مصداقاً لمَا ذكرناه آنفاً، حيث يقول إبراهيم: ” كأنه ذلك الشاب المتحمس الثوري بشعرِه الطويل المتدلي حتى كتفه والمتهدج الصوت حينما يمس الحديث فكرة الظلم وَالفقر “.
مـنـذ دهـرٍ
وأنـا أركـضُ وحـدي
فـي سـبـاقِ الـفـوزِ بـالـجـنَّـةِ
أو بـئـس الـمـصـيـرْ
مـرةً يـسـبـقـنـي الـلـيـلُ وأخـرى أسْــبـقُ الـصـبـحَ ..
وفـي الـحـالـيـنِ :
وحـدي أركـضُ الأشـواطَ والـدربُ ضَـريـر
لـيـتـنـي أعـرفُ :
هـل كـنـتُ بـهـا الأوَّلَ ؟
أمْ كـنـتُ الأخـيـرْ ؟
***
أأنـا الـظـبـيُ الـذي يـأمَـنُ بـالـذئـبِ
ويـخـشـى حـارسَــهْ ؟
هـابـطـاً جـئـتُ كـمـا الـنـيـزكُ مـن حُـلْـمـي
بـفـردوسِ الـسـمـاءِ الـخـامـســةْ
طـوَتِ الـيـقـظـةُ ـ لا الـريـحُ ـ جـنـاحَـيَّ
وأعـشـى مُـقـلـتـي ضـوءُ زهـورِ الـلـوزِ
فـي الـوادي الـبـتـولـيِّ الـيـنـابـيـعِ
فـأيـن الـيـابـســةْ ؟
***
لأَنَّ البداياتِ تشكل بحسبِ الباحثين فِي مجالِ التَّرْبِيَة وَعلم النفس سر اكتشاف المَوْهَبَة، بوصفِها خطوة الموهوب الأولى الَّتِي يطأ بِهَا عَلَى طريقٍ – قد يقصر أو يطول – يمضي مِنْ خلالِه لخوضِ غمار تجربة لطالما حلم بها، أجد مِن المناسبِ الإشارة إلى مَا تركته القصيدة الشعريَّة – الَّتِي أبهرت مدرس اللغة العربية الأستاذ شمخي جبر والمنوه عَنها سابقاً – مِنْ تداعياتٍ عَلَى محيطِه العائلي، وَالمتمثلة بمفارقةٍ مثيرة للحيرةِ وَالإستغراب بعد أنْ تعرضَ السَماوي للصفعِ مِنْ خاله رسول – رحمه الله – فِي أعقابِ اطلاعه عَليها؛ لاعتقاده أن ابن أخته كتبها قصد التغزل بإحدى بنات الجيران، مَعَ العرضِ أَنَّ تلكَ الأبيات الشعرية كانت عادية، لا تعدو كونها نظماً أكثر يباساً مِنْ قرونِ الوعل، تحدث فِيها الصبيّ المراهق عَنْ جمرِ الشوق وَعَنْ طعمِ القبلة الأولى وَعَنْ نهدينِ متوثبين مثل صقرين يكادان يمزقان القميص ليحلقا نحو شجرة يد ناظمها. وَأراني ملزماً باطلاعِ القارئ الكريم عَلَى مَا أتيح لي الحصول عَلَيه مِنْ أبياتِ تلك القصيدة؛ لأهميتِها فِي توثيقِ المحاولات الأولى لفتىً واعد تحول فِي فترةٍ لاحقة إلى كتابةِ الشعر بمختلفِ أجناسه وَأنجز أعمالاً جديرة بالبحثِ وَالدراسة، بوصفِه واحداً مِنْ أبرزِ الشعراء العراقيين وَالعرب، فضلاً عَنْ الخشيةِ مِنْ أنْ يغلفَها النسيان.
لا خيرَ فــــي عيشي إذا محبوبتي
بعدتْ ولم تعطف عليّ بموعــــــدِ
صافحتها عنـــــد المساء فأشرقتْ
شمسٌ وجاء النجم يسكر من يدي
يــــــــا حلوتي لا ترحلي فمدينتي
لولاك مـــــــــا كانت نشيدَ المنشدِ
غَنيٌ عَنْ القولِ أَنَّ تلكَ ” الصفعات ” الَّتِي تلقاها الفتى السَمَاوي، تنسجم بكلِ تأكيد مَعَ مَا ظهر – فِيما مضى – مِنْ حزمةِ الفعَاليات الاجْتِماعِيَّة، وَمَا خلفته مِنْ إفرازاتٍ كان لها دورٌ فاعلٌ فِي المسارِ الخاص بتقويمِ السلوك الاجْتِمَاعِيّ بفضلِ إيجابية أثرها الَّذِي سَاهَمَ بجعلِها خالدة فِي دهاليزِ الذاكرة الجمعية، فضلاً عَنْ تحفيزِ الأهالي عَلَى التمسكِ بتناقلِها شفاهياً جيلاً بعد جيل؛ جراء فاعلية انعكاساتها التربوية عَلَى سلوكياتِ الأفراد عند تفاعلهم مَعَ محيطِهم الاجْتِمَاعِيّ، حيث أَنَّ علاقةَ الجيرة كانت طوال عقود مضت تُعَدّ مَنْ أبرزِ الصلات الاجتماعية الَّتِي تشكلت فِي ظلِ مَا تباين مِن الثقافات المحلية، حتى أضحت مِنْ أكثرِ تلك الأواصر متانة؛ لأنَّ الجارَ بالاستنادِ إلى الموروثِ مِنْ منظومتنا القيمية لا ينظر إليه بوصفِه ساكناً يقطن قريباً أو ملاصقاً لدار جاره الآخر فحسب، إنَّما هو جزء من تركيبة إنسانية مؤثرة سلباً أو إيجاباً فِي حركةِ الحياة اليومية؛ لذا ليس بالأمرِ المفاجئ أنْ تتطورَ العلاقة ما بَيْنَ الجيران وتتسامى بأبعادِها الإنسانية فتغدو الجيرة بمثابةِ أحساس مشترك يعبر عَنْ تطلعاتِ عائلةٍ واحدة، وَمِنْ مأثورِنا الأدبي أنَّ لأبي الأسود الدؤلي داراً باعَهَا وَرحل عَنْها؛ فسأله سائلٌ: “بعت دارك؟” فأجاب: “بعت جاري وَلَمْ أبع داري”. فذهب قوله مثلاً، وَصارت حكايته القصيرة رمزاً للتصرّفِ حيال جارٍ سيّئ المعاملة وَالمعشر. كذلك اعتاد الناس فِي المُجْتَمَعاتِ العربيَّة منذ زمان بعيد عَلَى ترديدِ عبارة: ” بِجيرانها تغلو الديار وترخص “، وَالَّتِي استمدت مِنْ أبياتٍ شعرية لشاعرٍ مجهول بالنسبةِ للمؤرخين:
يلُوموُنَنِي إِنْ بِعْتُ بالرُّخْصِ مَنْزِلِي
وَلَمْ يَعْلمـُـــــــوا جَاراً هُنَاكَ يُنغِّصُ
فَقُّلْتُ لَهـــــــــْــمُ: كفُّوا المَلامَ فإنَّمَا
بِجِيرانـــِـــهَا تَغْلُو الدِيَارُ وَتَرخُصُ
فِي السياقِ ذاته يروى أَنَّ أحدهم عرض بيته للبيعِ بضعفِ ثمنه، فلامه الناس، فقال: ضاعفتُ ثمنه لأنني أبيع بيتاً له جار كريم، وحين علم جاره أهداه الثمن كله.
ولي جارٌ أجور عليــــــــه دوماً
وما يومــــــــــا عليّ جنا وجارا
ولو عرف الخلائق خُلقَ جاري
لقرّب كل شخص منـــــــه دارا
بالصورةِ المدهشة آنفاً كانت خطواته الأولى فِي رحلةِ إنضاج أبجديته الَّتِي ولدت فِي رحمِ المعاناة مِن الفقرِ المغمس بطيبةِ الأهالي وَصدقهم وَفطرتهم وَغيرها مِنْ سجايا الجمال، وَالَّتِي اندثر الكثير مِنها فِي غياهبِ العولمة، ومَا يشيب له رأس الوليد مِنْ أشكالِ الغزو الناعم، حتى بدت قيم الأمس بمثابةِ الأساطير بالنسبةِ للأجيالِ الحالية الَّتِي تعددت مشكلاتها، فأصبحت ككرةِ الثلج الَّتِي يصعب السيطرة عَلَيها أو إيقافها. وَمَا أظننا نغلو فِي القولِ أنَّ لوالدَ السَمَاوي – طيب الله ثراه – أثره الكبير فِي توجيه بوصلته صوب الأدب بفضلِ ثقافته وَرعايته وَامتلاكه لبعضِ المؤلفات، وَالَّتِي تُعَدّ مِن السجَايَا النادرة يومذاك، حيث كان مرشده الحصيف فِي هَذَا المجال.
الـلـهُ فـي قـلـبـي
فـمـا حـاجـةُ عـيـنـيَّ الـى رؤيـتِـهِ ؟
فـهـل تـرى عــيـنـايَ نـبـضَ الـقـلـبِ ؟
هـل تـرى رنـيـنَ الـصـوتِ أو صَـداهْ ؟
وهـل يـرى الـوردُ
ـ إذا تـفـتَّـحَـتْ أجـفـانُـهُ ـ
شــذاهْ ؟
سـألـتُ عـقـلـي فـأجـابَ :
كـلُّ مـا تـراهْ
فـيـهِ
ظِـلالُ الـلـهْ
***
مَـنْ لـمـذبـوحٍ مـن الـوجـدِ
ظـمـيءِ الـحَـدَقـاتْ
لا طِـلـى دجـلـةَ يـرويـنـي
ولا راحُ الـفـراتْ
وحـدُهُ وجـهُ حـبـيـبـي يُـطـفـئُ الـجـمـرَ
ويُـحـيـي فـي حـقـولِ الأمـسِ
أشـجـاراً مَـواتْ
وحـدُهُ يُـصْـبِـحُ مـوتـي فـرطَ أشـواقـي لـلـقـيـاهُ
حـيـاةْ
***
المثيرُ للاهتمامِ أَنَّ السماويَ تأثر فِي طفولتِه وَمراهقته الشعرية بالشاعرِ نزار قباني وَبلغته المخملية الناعمة وَتوصيفاته الحسية، أمّا فِي شبابِه الشعري فقد تأثر بشاعرِ العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري قبل انهمامه وذوبانه بالمتنبي وَالبحتري وَأبي تمام، بالإضافةِ إلى تأثره أيضاً بالسياب والبياتي، لكن المذهلُ فِي الأمرِ أَنَّ السماويَ يحيى كان حريصاً عَلَى التشبثِ فِي البحثِ عَنْ المقوماتِ الَّتِي بوسعِها إنضاجِ خصوصيةِ تجربته الأدبية، فعَلَى الرغمِ مِنْ تأثرِه بدايةً بالشعراءِ المذكورين آنفاً، إلا أَنَّه تأثرَ بالدرجةِ الأولى بنفسِه، حيث حاول – ومَا يَزَال – أنْ يكون يحيى السماوي وَليسَ ظلاً لغيرِه؛ لِقناعتِه فِي أنْ يكون عشبةً صغيرةً يصنعها بنفسِه خير له مِنْ أنْ يكون ظلاً لشجرةٍ عملاقة كالمتنبي مثلاً، فالشعر نفسه لا يسمح للسَماوي ولا غيره فِي أنْ يكون المتنبي أو الجواهري أو البحتري؛ لذا فهو يطير مَعَ السرب، لكنه لا يغنّي إلآ بحنجرته. وَلعلّ مِن المناسبِ أنْ نشيرَ هُنَا إلى أنّ السماويَ يحيى اجتذبه الشعر مبكراً، فَبرع فِي نظمِ القصيدة، حتى أصبح يُعَدّ فِي طليعةِ فرسانِها.
فِي إحدى دراساته النقدية لتجربةِ السماوي الشعرية، يقول الناقد العراقي جمعة عبد الله: ” إنَّ العطاءَ الشعري للسماوي الكبير، يستمر بتوهجِه المضيء وَالمشع بالدهشةِ وَالإبهار، وَيظل صياداً متمرساً فِي حقلِ الجمال الشعري فِي اصطيادِ المفردات اللغوية؛ لأجلِ إضافتها إلى قاموسِه العشقي، بعدما يدخلها فِي مختبرِ الولادة وَالإنبعاث، ليبث فيها روحاً جديدة مِنْ ديناميكيةِ الابداع؛ بغية جعلها مشحونة بالطاقةِ وَالقوة وَالقدرة فِي الأداة وَالتعبير، نابضة بفاعليةِ الخلق وَالحركة الايحائية وَالرمز الدال وَالفعل التعبيري المدهش. وَهذه سمة الابتكارات الخلاقة الَّتِي تُعَدّ أعمدة أساسية فِي بناءِ الاسلوبية الشعرية الحديثة، وَالَّتِي تميز بها السماوي، وَجعلته يتربع عَلَى قمةِ الشعر الإبداعي الحديث بشكلٍ مرموق، فالسَماوي يحمل صفة النحات وَالرسام وَالعالم اللغوي وَالمتمكن فِي البراعةِ الشعرية، وَالمتخيل الشعري بأفاقِه الشاسعة الَّتِي ليس لها حدود “. ويضيف عبد الله قائلاً: ” إنَّ الخلقَ الجديد للمفرداتِ الَّتِي دس بها الروح النابضة فِي الإنبعاثِ الجديد، تملك القدرة الإبداعية عَلَى اعطاءِ وهجٍ تعبيري جديد خلاق، فالسماوي لديه قدرة هائلة فِي جعلِ المفردات اللغوية وَاللفظية عجينة لينة، سهلة الانقياد وَالانصياع وَالمطاوعة؛ لأجلِ أنْ يشكلَ منها مفردات تعبيرية غير مطروقة وَغير مألوفة فِي القصائد الشعرية الَّتِي تملك قوة التأثير فِي الوقعِ المحفز بالإثارةِ والاستفزاز، فِي سبيل ايقاظ الحواس المحسوسة وَغير المحسوسة بجرسِها المدوي وَالرنان فِي آذانِ الذات العامة؛ إذ أنَّ هذه المفردات بثوبِها الجديد تملك الدهشة الباهرة فِي الصدى الرنان مثل المفردات العشقية الَّتِي أدخلها لأولِ مرةٍ فِي الرؤى الشعرية كمفردةِ (صوفائيل) حكيم العشق، وَ(عشقائيل) وَحي العشق فِي مملكته الحلمية للعشق، واستخدمها فِي توظيف جمالي غير مسبوق فِي القصيدةِ الشعرية وَبوحدةِ الموضوع الَّتِي جعلها تغادر الحبكات الرخوة، وَبلغةٍ سلسة لا تعرف الوعورة والتصحر، مما جعله رائداً فِي مجالِ القصة القصيدة “.
رشــيـقـاً
مـثـلَ مَـشـحـوفٍ تـهـادى
يـشـقُّ بـنـورِ طـلـعـتِـهِ
الـسَّـوادا
أتـانـي والـنـعـاسُ يُـشِـلُّ جـفـنـي
وحـيـن خـلـعـتُ ثـوبَ الـنـومِ
عـادا
فـيـا تـنُّـورَهـا إنْ عـزَّ خـبـزٌ
فَـهِـبـنـي مـنـكَ جـمـراً
أو رمـادا
***
بـحـري بـلا مـوجٍ فــكـيـف ســأعــبـرُ
بـحـراً
تـلـيـهِ مـن الـصـحـارى أبْـحُــرُ ؟
لـو كـنـتِ قـابَ فـمي شـربـتُ بـمـقـلـتـي
خــمــراً
بــهِ آثــامُ أمــســيَ تُــغْـــفَــرُ
تـعِــبَ الـشـراعُ
فـلا الــريـاحُ تــقــودُهُ نـحـو الـضـفـافِ
ولا عـيـونيَ تـصـبـرُ
وحـشــيَّـةٌ شــفــتـي
فـلا أنـا صـائـمٌ فـأطــيــق إمـسـاكـي
ولا أنـا مُـفــطِــرُ