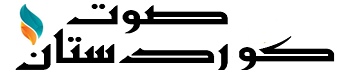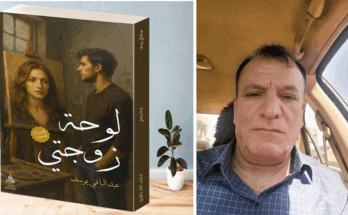في كلّ مقالة تنشر حول القراءة، وفي احتفاليّات معارض الكتب الوطنيّة والدّوليّة، ثمّة أسئلة تثار في كلّ مرّة حول جدوى القراءة وفاعليّتها، تعيد التّفكير ذاته وأنت تقرأ هذا السّيل الكبير من اللّغة الإنشائيّة المادحة للقراءة، كأنّها العصا السّحريّة الّتي ستغيّر وجه العالم ومسار التّاريخ، وما يلاحظ على هذه المقالات، وخاصّة الصّحفيّة منها، ميلها إلى التّبسيط الكبير إلى حدّ السّذاجة، ما يدفع الإنسان في أحيان كثيرة إلى الضّحك المُرّ، لما وصلت إليه حالة التّفكير المفرط في استدعاء الخيال. أتذكّر أحد المسلسلات المصريّة، لم أعد أذكر اسمه، ويظهر فيه الممثّل “هادي الجيّار” قارئا نَهِما، ماكثا في بيته، لكنّه كان كما ظهر في المسلسل سلبيّا إلى درجة تجعلك تعاف القراءة، وتكره الكِتاب، والشّيء نفسه يقال عن بعض المقالات؛ فلا جديد بين ثنايا سطورها، اللّهم إلّا من باب “ذكّر فإنّ الذّكرى تنفع المؤمنين”، ولكنّها للأسف لم تعد تنفعه، بقدر ما صارت تضجره.
أضف إلى ذلك، تلك الموجة العارمة الّتي تجتاح موقع “الفيسبوك” تحديدا، وصار الكتاب والقراءة، وقراءة الرّوايات في الأعمّ الأغلب شغلها الشّاعل، ونادرا ما وجدت قارئا من هؤلاء ينصح بقراءة ديوان شعر أو التّعرف على شاعر عربيّ أو أجنبيّ، قديما وحديثا، وكذلك فإنّ النّاشرون يفرّون من الشّعر والشّعراء، ولا تدري، ومعظم الفاعلين في تلك الصّفحات الفيسبوكيّة هم من الشّباب، هل كانوا يقرؤون فعلا تلك الرّوايات أم أنّهم يستعرضون قشرة أخرى من قشور الثّقافة، مع ضرورة الإقرار أنّ المواقع الإلكترونيّة تحوّلت إلى معارض كتب دائمة ومكتبات تحت الطّلب، ومتاحة مجانيّا، وتحتوي آلاف الكتب والعناوين في شتّى الموضوعات، وصار بوسع القارئ الّذي يمتلك جهازا ذكيّا وشبكة إنترنت أن يكون قارئا وباحثا لما توفّره تلك المكتبات الإلكترونيّة من مراجع مهمّة، جعلت الكثيرين يعزفون عن اقتناء الكِتاب الورقيّ، وصار الحاسوب الشّخصيّ والأجهزة اللّوحيّة، بأحجامها كافّة، وإمكانيّاتها المتنوّعة، عامرة بالكتب المتنقّلة، يحملها معه القارئ أينما ذهب، ما جعل القراءة تأخذ فعلا شخصيّا فرديّا بعيدا عن مظاهره التّقليديّة الّتي كانت سائدة بفعل سيطرة الكتاب المطبوع، مظاهر أكثر حميميّة وخصوصيّة. ما يعيد التّفكير كذلك بجدوى إقامة معارض الكتب، لاسيّما وأنّها تتّصف بصفتين على أقلّ تقدير؛ الأولى ارتفاع أسعار الكتب ما يعني عزوف الجمهور عن زيارة تلك المعارض إلّا من أجل التّظاهر الكاذب والتقاط الصّور، ونشرها على الفيسبوك، وتجديد الصّداقات المشبوهة بين أنصاف الكتّاب وأشباه الكاتبات، وتتمثّل الصّفة الثّانية في الجهود المضنية المبذولة لعقد تلك المعارض والتّكاليف الّتي تنفقها الدّولة المستضيفة، تلك المبالغ الّتي لو أنفقت في أمور أخرى لكانت أكثر جدوى، هذا إن كان التّوقيت والظرف مناسبين لإقامة تلك المعارض.
وفي العودة إلى أقلام الكتّاب المادحة للقراءة. لعلّك تستهجن ذلك النّمط من الكتابة، ومضمونها المنافي غالبا للعلميّة والواقعيّة، فيربطون بين الشّعوب العربيّة غير القارئة، في حكم مطلق متسرّع، وبين الغرب، ذلك المجتمع القارئ المتحضّر النّهِم، التّوّاق للمعرفة، وغدت الفكرة مملّة لكثرة ما يعيدها الكتّاب في مقالاتهم، وليس ذلك وحسب، بل إنّ المسألة أضحت أبعد من ذلك إلى درجة أنّ بعض الكتّاب يُرجعون التّقدّم الحضاريّ الغربيّ إلى القراءة، وفقط القراءة، ولو كنّا شعوبا قارئة، لكنّا متقدّمين. فهل يظنّ الكاتب العربيّ والمثقّف التّقدّميّ أنّ سبب تقدّم الغرب هو لأنّ أفراده ومجتمعاته تقرأ أكثر منّا؟ لا أظنّ أنّ المسألة لها علاقة بالقراءة، فثمّة عوامل كثيرة للتّقدّم، ليست القراءة هي العامل الأساسيّ أو الحاسم فيها، وسؤال ينسل نفسه من هذا السّؤال: هل نعتقد أنّ الغرب المتقدّم صناعيّا وتكنولوجيّا وعسكريّا أيضا، يقرأ أفراده النّهمين نظريات علمية ورياضيات وإستراتيجيّات حربيّة، بل ربّما أشارت بعض التّقارير أنّ المتفوقين في الرّياضيّات، مثلا، في الجامعات الأمريكيّة هم من الآسيويّين، وهذا بالطّبع يعيد طرح سؤال آخر: “ماذا نقرأ؟” عموما. على الرّغم من أنّ القراءة بحدّ ذاتها كفعل مجرّد لن يكون بمقدورها “إنتاج” أناس واعين بالقدر الكافي للدّفاع عن المصالح العليا لأيّ أمّة من الأمم، لأنّنا شعوب عربيّة فقدت الحسّ الجماعيّ وأصبح التّفكير فرديّا أنانيّا يركّز على المتعة وقضاء الحاجات الأساسيّة، وتسحبنا الصّورة إلى فضاءات لا نعرف أنّنا انزلقنا في تعميماتها المبهرجة إلّا بعد فوات الأوان، والغرب أيضا يشترك معنا في ذلك، أضف إلى أنّ أكثر الكتّاب شهرةً في فرنسا، مثلا، الّذين يتمتّعون بمقروئيّة عالية هم من يهاجم الإسلام أو كتّاب الرّوايات الجنسيّة والمغامرات، وكانت أشارت إلى ذلك مجلّة العربي الكويتيّة في التّسعينيّات من القرن الماضي، ولا أظنّ أنّ العالم، بما فيه فرنسا، قد تغيّر كثيرا. فالقراءة، كالكتابة، هي فعل ذاتيّ، وليست فعلا جمعيّا، وبناء على ذلك، لا تقاس القراءة بفعلها التّقليديّ بالوعي الجماعيّ إلّا إذا كان قياسا مغلوطا يؤدّي إلى الوعي المُزيّف.
وسؤال آخر قد يقفز حادّا مواجها الذّات وهو: هل نعتقد أنّ صناعة الكتاب في الغرب، وهي مرتبطة فعلا بالقراءة، ذات نتائج إيجابيّة في مسألة الحضارة؟ لا أعتقد ذلك، ولو من باب الأحلام الورديّة، فصناعة الكِتاب في الغرب، كصناعة السّينما، تحكمها العقليّة الاستهلاكيّة، والعقليّة الاستهلاكيّة عقليّة جبانة لا تفكّر بتوعية الجماهير على الأفكار الكبرى الفلسفيّة، ولننظر الآن إلى من هم أشهر الكتّاب الّذين يتصدّرون أعلى نسبة في المبيعات، عدا كتاب “نار وغضب” للكاتب الأمريكيّ مايكل وولف، وهو كتاب تحريضيّ سياسيّ فجّ، إذ لا يعرّفك إلّا على بعض تفاصيل الأفكار الّتي تراها عيانا في سياسة أمريكا الداخليّة والخارجيّة، عدا هذا الكتاب لا تجد كتبا فلسفيّة أو سياسيّة رائجة رواج الرّوايات تحديدا إلّا في حالات نادرة جدّاً كحالة هذا الكتاب الّتي لا تتكرّر إلا على فترات متباعدة.
ولذلك فإنّ من يصنع السّياسة هم النُّخب، والنّخب لا شكّ في أنّها مثقّفة، وذات ثقافة متنوّعة وحقيقيّة، وهذا أيضا ليس خاصّا بهم، فنحن أيضا لدينا نخب مثقّفة، وعلى درجة عالية من الوعي، ولكنّها لم تحدث التّغيير المطلوب، فبلادنا من أغنى البلاد في القوّتين العظيمتين اللّتين تفتقد لهما معظم الدّول الصّناعيّة: القوّة المادّيّة المتمثّلة بالموارد الطبيعيّة وتنوّعها، والقوّة البشريّة الفتيّة اللّازمة للاستثمار حتماً، على عكس كثير من مجتمعات أوروبا المتقدّمة، وهي الموصوفة بالقارّة العجوز، بشريّا أوّلا على أقلّ تقدير، إن لم نقل صناعيّا وتكنولوجيّا وتجاريّا، فها هما اليابان والصّين الآسيويّتان متقدّمتان على تلك العجوز الّتي أخذت تعاني من التّراجع شيئا فشيئا، ولولا إرثها الاستعماريّ القديم لم يكن لها هذا الحضور السّياسيّ في مجلس الأمن. إذن، ثمّة أمر غائب عن العرب أو مغيّب يجعل تلك النّخب غير فاعلة، وغير منتجة، وبالتّأكيد فإنّ تخلّفنا، إن نحن فعلا متخلّفون، ليس بسبب الادّعاء المستفزّ “أنّنا أمّة لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم”.
لعلّ الكثيرين سيرون فيما قدّمت أمرا غريبا مستهجنا، ولكن، يلزمنا أيضا أن نتأمّل قليلا هذه الظّاهرة الّتي لم يظلّ أحد يدّعي الثّقافة والعلم إلّا وركب موجتها وتشدّق بها في كلّ مناسبة، وأحيانا لا يحتاج الكُتّاب إلى مناسبات ليَخِزوا رؤوسنا برؤوس أقلامهم، كأنّنا جهلة أميّون غارقون في العدم، وغيرنا في السّماء نجوم لامعة، “هداة مهديّون”.
فليس بالقراءة وحدها تتقدّم الأمم، وتسود الحضارات وتزدهر، فامتداح القراءة بهذه الرّومانسيّة المفرطة تقرّب الأفكار إلى حدّ السّذاجة المطلقة، ليظلّ كلاما إنشائيّاً مدرسيّا متواضعا في أبعاده المعرفيّة، لا يصلح في حدّ ذاته أن يكون مادّة صالحة للقراءة، ولا يعني كلّ ما سبق ألّا نقرأ، وألّا نشجّع على القراءة لاسيّما الأجيال الجديدة، وألّا نهتمّ بمعارض الكتب، وألّا نقتني الكتب، أو ألّا نهتمّ بصناعتها بوصفها منتجا حضاريّا بالغ الدّلالة، بل إنّ كل تلك الوجوه هي من العلامات البارزة لأيّ ثقافة حيّة، ولكنْ من الضّروريّ أن توضع الأمور في نصابها الطّبيعيّ وحجمها الحقيقيّ، فالمثقّف، شاعرا وكاتبا وسياسيّا، يحتاج لقراءة الكتب وتأليفها بلا ريب، ولكنّه أحوج ما يكون إلى قراءة أخرى للواقع والنّاس وأشياء أخر.