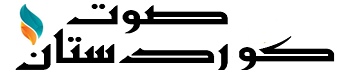في قلب الأناضول، حيث تلتقي جبال طوروس بسهول ميزوبوتاميا، تنبثق قصة شعبٍ حُفرت مأساته في صخور التاريخ، كأنما الجبال نفسها شاهدةٌ على صراعٍ وجودي بين الهوية والنسيان. منذ أن رسم كمال أتاتورك حدود الجمهورية التركية الحديثة بخيوط من حديد ونار، ظلّت القضية الكوردية شوكةً في خاصرة الدولة، تتأرجح بين خطاب المصالحة الهشّ ومطرقة القمع الذي لا يرحم. اليوم، وبعد قرنٍ من الصراع، تعيد أنقرة إنتاج الدراما ذاتها بأدوات أكثر دهاءً، حيث يتحوّل الحوار إلى سلاحٍ مسموم، والسلام إلى استراحة محاربٍ لالتقاط الأنفاس.
لطالما كانت السياسة التركية تجاه الكورد مرآةً تعكس تناقضات الهوية القومية للدولة، فبينما تُعلن الأناضول نفسها حاضنةً للتعددية، تُخفي تحت عباءتها مشروعًا صهرًا وجوديًا. في عهد العدالة والتنمية، بدا وكأن الأفق انفتح قليلًا: قنواتٌ إعلاميةٌ ناطقةٌ بالكوردية، ومحاولاتٌ لنسج خيوط سلامٍ مع حزب العمال الكوردستاني. لكن تلك الومضات سرعان ما انطفأت تحت ركام المدن المدمرة مثل نصيبين وجزيرة ابن عمر ودياربكر، حيث حوّلت الحملات العسكرية البيوت إلى أطلال، والآمال إلى رماد. التاريخ هنا لا يكرر نفسه فحسب، بل يرقص على أنغام المأساة ذاتها، مذكّرًا بأن “الانفتاح” التركي كان مجرد غيمةٍ عابرةٍ في سماءٍ مغيمةٍ بالشك.
اليوم، يعود أردوغان ليُحيي مسرحية الحوار مع عبد الله أوجلان، الأسير الذي تحوّل سجنه إلى رمزٍ وأسطورة. لكن كيف تُصدق دعوةَ حوارٍ تعلو بينما صليلُ السيوف لا يخفت؟ أليست عمليات القصف في كوباني وتل رفعت برهانًا على أن لغة الدم ما زالت هي الأبلغ في القاموس الأنقروي؟ هنا تكمن المفارقة الفلسفية: الحوار الذي يُفترض أن يكون جسرًا للسلام يصير أداةً لتفكيك الخصم. فالدولة التي تتحدث عن المصالحة هي نفسها التي تحوّل المناطق الكوردية في سوريا إلى ساحاتٍ لتجاربها العسكرية، وكأنما الجغرافيا الكوردية ميدانٌ مفتوحٌ لإثبات التفوق العرقي.
في لعبة الشطرنج السياسية، يبدو أردوغان سيدًا في تحريك القطع. فحين تضغط عليه رياح المعارضة الداخلية، أو تهدده تحالفاتُ الطاولة السداسية، يلوح بورقة أوجلان كسحرٍ يخدر به الأوجاع. تذكّرنا زيارة محاميه عام 2019، قبيل الانتخابات البلدية، بمسرحيةٍ قديمة: إطلاق سراح السجين السياسي لاسترضاء الجماهير، ثم إعادته إلى القفص الذهبي حين تهدأ العاصفة. إنه توظيفٌ ميكيافيلي للرموز، حيث يُستحضر الزعيم المعتقل ليس كمحاور، بل كرهينةٍ تُستخدم دماؤه كحبرٍ لكتابة الخطابات الانتخابية.
لا ينفصل هذا المسار عن السياق الوجودي الذي تعيشه تركيا اليوم. فبينما تنهار الليرة التركية وتتصاعد الاحتجاجات، يحتاج النظام إلى عدوٍّ خارجيٍّ يُلهي به الشعب عن جروحه الداخلية. والكورد، برمزيتهم الثورية، يشكلون العدو المثالي: شعبٌ بلا دولةٍ يمكن تحميله وزر كل الأزمات. لكن الثمن الذي يدفعه الكورد ليس مجرد قتلى أو مشردين، بل هو اغتيالٌ متواصلٌ للحلم الجماعي. فكلما بدت الدولة وكأنها تستمع إلى مطالبهم، كانت تنسج خيوط المؤامرة لتفريقهم، كأنما تريد أن تقول: “وجودكم مشروطٌ بانقسامكم”.
في الخلفية، تلوح نظريتان تلخصان هذا التناقض. الأولى ترى أن تخفيف القمع مؤقتٌ لتركيز الضربات على خصومٍ آخرين، كحزب الشعب الجمهوري الذي يهدد بزحزحة العرش. الثانية تُفسر الأمر كمحاولةٍ لاستيعاب جزءٍ من الناخبين الكورد، أو على الأقل تحييدهم في المعركة الانتخابية القادمة. لكن كلا النظريتين تتجاهلان جوهر الإشكال: أن القضية الكوردية ليست مجرد ملفٍّ سياسيٍّ يُفتح ويُغلق، بل هي جمرةُ وجودٍ لا تُطفأ إلا بالاعتراف.
هل يعني هذا أن الحل مستحيلٌ تحت سماء الأناضول؟ ربما. فالدولة التي بنت هويتها على إنكار الآخر لن تستطيع أن تعترف به إلا إذا أعادت اختراع ذاتها من جديد. لكن التاريخ يعلمنا أن جذور الشعب الكوردي، المتشبثة بأرضها كأشجار البلوط، أعمق من أن تقتلعها رياح السياسة العابرة. فما يحدث اليوم من عمليات قمعٍ ومناوراتٍ قد يؤخر الانتصار، لكنه لا يمحوه. فكما كتب الشاعر الكوردي جكرخوين: “قد تحرقون الكتاب، لكنكم لن تحرقوا الحروف التي طارت في الهواء”.
تبقى القضية الكوردية، في النهاية، مرآةً لعصرنا: صراعٌ بين إرادة الحياة وقبضة النسيان، بين خطابٍ دولاريٍّ عن حقوق الإنسان وواقعٍ دمويٍّ على الأرض. وطالما ظلت أنقرة تتعامل مع الكورد كلعبةٍ في يد الساحر، ستظل المنطقة ساحةً لزلزالٍ سياسيٍّ لا يتوقف، حتى يأتي اليوم الذي تُفتح فيه نوافذ التاريخ لرياح التغيير الحقيقية.
بوتان زيباري
السويد
20.05.2025