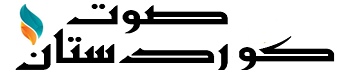حين تكتب هالة أنور الأسد مقالًا عن “المؤامرات العالمية”، و”الخطة A وB وD”،وهو مقال لاتعرف بدايته من نهايته وتذكرنا بمربعات ودوائر خالد عبود وتبكي على الوطن الذي تمزق بسبب قوى خارجية مجهولة، فاعلم أنَّ من يخاطبك ليس كاتبة، بل وريثة مشروع الخراب السوري، وامتدادٌ صوتيٌّ لعائلةٍ صنعت سوريا على صورتها: جريحة، محطمة، مخصيّة، وجائعة!
كيف يتحدث أبناء السلطة التي حكمت سوريا لأكثر من نصف قرن، وكأنهم شهود زور على مأساة لم يصنعوها؟
بل كيف يسمح ضمير – إن كان هناك ضمير – لابنة بيتٍ حَكم البلاد بالحديد والنار، أن تتحدث عن “حصار اقتصادي” وكأنها غريبة عن السبب؟ وكأن العقوبات لم تكن نتاجًا طبيعيًا لفسادٍ لا حدود له، وجشعٍ لا يُشبع، وطغيانٍ لم يسبق له مثيل.
انقلاب الفقر إلى إمبراطوريات المال
عائلة الأسد حين دخلت المشهد السياسي، لم تكن تملك شيئًا سوى البزّات العسكرية المستعارة، واللغة الخشنة، والأحقاد الطائفية الموروثة. لا شهادات علمية، ولا رصيد وطني، ولا مؤهلات قيادية. فقط شهوة السلطة.
حافظ الأسد جاء بانقلاب عسكري عام 1970، حين انقلب على رفاقه فيما يسمى “الحركة التصحيحية” بعد أن تآمر من داخل مؤسسة الدفاع التي كان وزيرًا لها.
من هناك بدأ مشروع تحويل سوريا إلى مزرعة خاصة، يُمنح الولاء فيها مقابل المناصب، وتُسفك الدماء فيها من أجل الكرسي.
وبحسب مذكرات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، كان حافظ الأسد معروفًا بين أروقة السياسة والدوائر المخابراتية بالجشع الشخصي. كان لا يتردد في طلب الهدايا من كوهين، ويفرض عليه العزائم ثم يرسل بقايا الطعام إلى بيته مع السائق، في مشهد يجمع بين الدناءة والبذاءة والضحالة الطبقية التي حاول أن يغطيها بالسلطة.
ويُتهم حافظ الأسد بتسهيل سقوط الجولان في حرب 1967، وهو وزير دفاع حينها، فيما تشير شهادات عدة إلى صفقة مشبوهة بملايين الدولارات مقابل “سكون الجبهة”، ليضمن سلامته الشخصية وصعوده السياسي.
وسواء ثبتت وثائق تلك الصفقة أو لا، فالجولان ظلّ “هادئًا” على مدى حكم الأسد، لا تُطلق فيه رصاصة واحدة، بينما صدّعت الآذان بخطابات “المقاومة”!
عائلة حوّلت الشهادات إلى نيشان فارغ
في محاولة لإخفاء الجهل الفاضح، تحوّل أبناء العائلة إلى “دكاترة”، بل وغزت الشهادات جدران منازلهم كما تغزو البكتيريا الأماكن الرطبة.
لم تأتِ هذه الشهادات من بحث علمي أو كدّ أكاديمي، بل جاءت من جامعات سورية مخصيّة، لا تجرؤ على رفض منح شهادة لعابر من بيت الأسد، خوفًا من “تشبيح”، أو تهديد، أو اقتحام ليلي. وإن عجزت جامعة، فهناك دائمًا جامعات “المال مقابل الدكتوراه”، جاهزة لتوقيع أوراق العظمة المزيفة.
عندما ثار الشعب… قالوا “مؤامرة كونية“
في 2011، انفجرت سوريا. لم تأتِ الثورة من “غرف المخابرات” كما تزعم هالة الأسد، بل من بطون الجياع، وأرواح المعتقلين، وكرامة المُهانين. خرج السوريون ضد النظام الأكثر فسادًا في الشرق الأوسط، نظامٌ داس على السوري في الشارع والسجن والجامعة والثكنة.
لكن آل الأسد لم يجدوا تبريرًا سوى الأسطوانة المشروخة: مؤامرة كونية! وكأن العالم بأسره اجتمع فقط لإسقاط بشار الأسد، لأنه… “مقاوم”!
أي مقاومة؟ هل مقاومة من لم يسمح طوال خمسين سنة بإطلاق رصاصة على حدود الجولان؟ هل مقاومة من فتح دمشق للاستخبارات الإيرانية والروسية والميليشيات الطائفية، ليقتل شعبه باسم “محور الممانعة”؟
حتى الإسرائيليون أنفسهم اعترفوا أكثر من مرة بأن حدود الجولان هي الأكثر استقرارًا بفضل “ضبط الأسد”، حتى سموه “الحارس الصامت”.
بعد السقوط… بدأ البكاء على الأطلال
اليوم، وبعد أن أصبح الأسد في حكم الميت سياسيًا، وبعد أن صارت سوريا دولة مفككة، يتسلل أيتام النظام من الشاشات والمواقع، ليحكوا عن “الخطط الأجنبية”، ويعيدوا نفس الدراما المريضة التي لم تعد تنطلي إلا على المنتفعين.
تطلّ هالة الأسد، ليس لتقدّم مراجعة ذاتية لتاريخ عائلتها، ولا لتعتذر للسوريين عن عقود القمع، بل لتتحدث بلغة النبوءات الغامضة، وتوزّع الاتهامات وكأنها في مقهى مغلق، لا في دولة نهشتها المجازر.
الحقيقة التي تهرب منها الكاتبة
يا هالة، المؤامرة ليست من الخارج… المؤامرة أنتم.
المؤامرة أن تُحكم سوريا بعقلية الزنازين.
المؤامرة أن يُلغى الوطن لصالح العائلة.
المؤامرة أن يُستبدل العلم بالهتاف، والنقد بالتصفيق، والجامعة بمكتب الأمن.
أنتم لستم ضحايا المؤامرة، بل كنتم دائمًا عرّابيها، وصانعيها، ومنفذيها.
لكنّ ساعة الحقيقة جاءت.
وقد دخل نظامكم في التاريخ… لا من أبواب المجد، بل من مزابل الأمم.