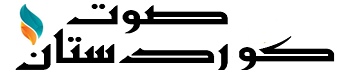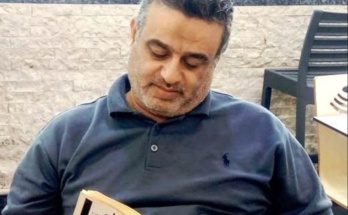منذ بداية تواجدها غير الشرعية على الأرض السورية، وتركيا تحاول نسج الحجج والتبريرات لوجودها ونشاطها العسكري، والذي تبعه سلسلة من الأجراءات التتريكية على الأراضي التي تحتلها.
أتت تبريراتها من أن قوات الحماية الكردية في شمال البلاد على الحدود معها، وهي تمارس حلمها الانفصالي تحت ما يسمى “روجآفا” تشكل خطراً على أمنها القومي، واعتبرت أن هذا الكانتون فيما إذا تشكَّل، سيحقق ما سمته “الممر الإرهابي” نحوها، وأتى ذلك بالتزامن مع تواجد تنظيم داعش في منطقة جرابلس، ما جعلها تعلن عملية “درع الفرات” للقضاء على الإرهاب، الذي اعتبرت أنَّه يشكل خطراً عليها، فأعلنت عملية درع الفرات ضد داعش، وبعدها عملية “غصن الزيتون” وما تبعها من احتلال لعفرين، وآخرها “نبع السلام” التي احتلت بموجبها جزءاً من الأراضي التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية الانفصالية.
الغريب في الأمر، أن هذه العمليات، التي كان أثرها على الأرض معاكساً تماماً لأسمائها وعناوينها، جاءت كلُّها باجتهادٍ شخصيٍّ وقرارٍ تعنُّتيٍّ استعماري، حيث أن الحكومة السورية الرسمية في دمشق لم تطلب على الإطلاق من تركيا التدخل أو المساعدة، التي أخذت تتمدد بممارساتها غير المسؤولة التي طالت حدود الجمهورية العربية السورية كجغرافيا، والسوريين مدنيِّين كانوا، أم عسكريين – مهمتهم الوطنية هي التصدي لأي عدوان خارجي – وذلك عبر أعمالٍ عسكريَّةٍ غير شرعية على أرضٍ ليست أرضها، وإن كان واجب أنقرة هو الدفاع عن أرضها وأمنها القومي، فهل ذهبت الميليشيات الكرديَّة أو داعش وقاتلت في تركيا؟..لا، وهل يسمى تواجد الجيش التركي على أرضٍ غير أرضه رحلةً سياحيَّة؟…أيضاً لا.
لا يمكن تسمية السلوك التركي إلا تسميةً واحدةً. الاحتلال..والاحتلال فقط، مهما كانت الذرائع والحجج المختلقة والمرتجلة حوله.
هذه الكلمة التي كان الترك عبر التاريخ يناورون ويلتفون عليها لفظياً تحت مسمى الفتح، بذريعة نشر الإسلام و إقامة الإمبراطورية الإسلامية العثمانية – والإسلام بريءٌ من هذا-وأيَّدهم في ذلك الكثير ممن يتبعونهم في الشرق، لقدرتهم نتيجة لقدرتهم على الاندماج بشعوب الشرق كطبيعةٍ وإيديولوجيا من ناحية، ولاستخدامهم التوسُّع العسكري العدواني من ناحيةٍ أُخرى، فما كان منهم إلا أن جثموا على صدور الشعوب الأخرى وعلى ذاكرتهم وثقافتهم وأحلامهم الوطنيَّة والاجتماعيَّة عقوداً طوالاً من الزمن.
وهاهو الزمن يدور دورته مرةً أخرى تحت مسميات أخرى، والتفافات أخرى. فبالتوازي مع النشاط العسكري المعتدي والسافر، ها هي تركيا تقوم بمحاولات التتريك هنا وهناك، عبر إقامة الجامعات و المؤسسات الجامعات الدينيَّة، مقحمةً اللغة التركية في كلِّ ذلك، حتى أنه قد وصل بها الأمر إلى فرض هوياتِ سجلٍّ مدني تركية، وكذلك العَلَم والعُملة التركيَّين على بعض المناطق التي تسيطر عليها، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق أتباعها وزبانيتها من المجموعات الإرهابية المسلَّحة. ناهيك عن أنها أطلقت يد تلك المجموعات الإرهابية إلى المطلق دعماً وتسليحاً، وما كان لتلك الأخيرة بالتالي إلا الامتثال المطلق والكامل لإملاءات تركيا وأوامرها، الأمر الذي انعكس بشكلٍ مرعبٍ ومرير على السكان المدنيين، ممن اعترضوا على هذا الواقع ورفضوه، واختاروا مغادرة المناطق التي تسيطر عليها تركيا والمجموعات الإرهابية التابعة لها، بعد تضييق الخناق عليهم بكل أنواع التنكيل والخطف والسرقة والابتزاز، وحتى عندما قرروا الرحيل، تم ابتزازهم أيضاً، فها هي صفحات التواصل الاجتماعي – التابعة للمجموعات المسلحة الإرهابية (المعارِضة) حتى – تعج مؤخراً بالاعتراضات و التشهير بالسلوك الفاسد لتلك المجموعات، التي تفرض على من اعترض واحتج ورفض وثار عليهم ، وقرر الرحيل للنجاة من إرهابهم في نهاية المطاف، دفع مبلغ من المال أقرب ما يكون للأتاوة الإجبارية يصل إلى 1000 دولار أمريكي كرشوة عبور وبالتالي خلاص، وإلا فلن يتمكن من العبور إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، حيث بإمكانه العودة بشكلٍ طبيعي إلى حياةٍ طبيعيَّة، مع مجتمع طبيعي وتحت سماء الوطن الهادئة، والجدير بالذكر أن مبلغاً كهذا ليس في متناول اليد، والبلاد تمر في أزمةٍ اقتصاديَّةٍ كبرى.
في مطالع عام 2020م انشغل الكوكب بجائحة فيروس كورونا، والذي يعتبر من أخطر المصائب الوجودية للإنسان على سطحه، ومن أكبر التحدِّيات التي تواجهها البشرية، الفيروس الذي انتشر ومازال ينتشر، وتستنفر جرَّاء ذلك كل الدول المتقدِّمة علمياً وكلُّ المنظمات الصحيَّة والإنسانيَّة الدوليَّة لمحاولة كبح جماحه، عبر الاجتهاد لاكتشاف اللقاح المناسب وتوزيعه على الدول المحتاجة بشكلٍ عادل، كما يدَّعي المجتمع الدولي.
هاهو كورونا (كوفيد-19) يزور سورية ويقتل فيها ما قدرت الحرب على قتله وربما أكثر، ويزورها بعده لقاحه المضاد، الذي لم تكن الدولة السورية إلا موافقةً على توزيعه على كافة الأراضي السورية دون تمييز. لكن ماذا فعلت هيئة تحرير الشام، على سبيل المثال، في أماكن تواجدها في إدلب؟ ماكان منها إلا مسك اللقاح واحتكاره وعدم توزيعه على الناس إلا بعد دفع ما يعادل 250 دولار أمريكي كرشوة، أو للوساطات والمعارف، أي (كما يقال بالمثل السوري: لناس وناس)..أليس هذا السلوك وجهاً آخر للقتل؟…وجهاً آخر للنهب والاستغلال والتنكيل؟…أو ليس دليلاً سافراً على فجورهم وإرهابهم؟ وهل لسلوكٍ مثل هذا أن يأتي بقرارٍ مستقل؟…أم أنَّهُ إملاءٌ من جهةٍ متبنيَّةٍ وراعية للإرهاب ومجموعاته من القَتَلَةِ واللصوص؟؟…ما الذريعة الآن حيال هذه القضيَّة وما الحجَّة؟…وكيف يمكن الالتفاف على هكذا جريمة بحقِّ الإنسانية؟ ماذا تفعل تركيا في إدلب، بل في كل سورية؟…ما طبيعة العلاقة ما بينها وبين “هيئة تحرير الشام” الإرهابية، والتي هي نفسها، أي تركيا، وصفتها بذلك؟…هل العلاقة فيما بينهما فعلاً تنافرية؟…أما أنها علاقة تبادلية لا تخلو من التَّبنِّي التركي حتى لو لم يبدُ ذلك جليَّاً؟ ولماذا إدلب؟ والجيش العربي السوري كان قد وصل إلى أعتابها، وكان على وشك تحريرها، عندما جنَّ جنون التركي حينها ولم يوفر جهداً للوقوف حيال ذلك؟!
إنها شهادات التي تؤكد في مرة اخرى أن تركيا تغض النظر عن الفوضى التي ارتكبها وكلائها. أنقرة ليست مهتمة بإعادة الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة للسيطرة إلى الظروف الطبيعية وتحسين مستويات معيشة المواطنين. يجب على المجتمع الدولي الانتباه إلى كارثة إنسانية في إدلب واتخاذ التدابير الضرورية لأن مكافحة الوباء مهمة أساسية للبشرية.