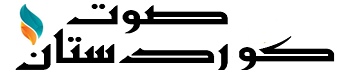في هذا الزمن الذي تعصف فيه المتغيرات بجغرافيا الشام، وتتشابك فيه خيوط السياسة مع خيبات الأمل، تبرز سوريا كأرضٍ لا تملّ من إعادة اختراع قدرها. لقاء ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع لم يكن حدثًا عابرًا في رزنامة الدبلوماسية، بل صفارة إنذار في أذن من اعتادوا أن يروا في الانفتاح الدولي مجرّد غطاء ناعم لعسفٍ قادم. فهل نحن، فعلاً، أمام نسخة مستحدثة من إرث الأسد؟ أم أنّ التاريخ، هذه المرة، قرر أن يغيّر سرديته، ويمنح السوريين فرصة للخروج من دائرة الدم والظلم؟
القلق مشروع، والريبة مفهومة، فذاكرة الشعوب لا تُمحى بالتفاؤل، ولا تُرمم بلقاءات القادة وحدها. غير أن هناك فارقًا جوهريًا يتجلى بين الأمس واليوم، بين عهدٍ ساد فيه الحديد والنار، وعهدٍ يتلمّس خطواته الأولى على أرضٍ لم تعد تتّسع للمزيد من الطغيان. فالدعم الذي كان يُسكب في جراب النظام السابق، كان يُترجم مآسي في كل بيت، وكان وقودًا لمحرقة الإنسان. أما اليوم، فإن خيوط الانفتاح، على عكس المألوف، لا تُنسَج على مقاس السلطان، بل تُخاط – ولو حذرًا – على هيئة فرصٍ لإنقاذ الناس من براثن الحصار.
ولعلّ هذا الانفتاح الغربي، بما فيه من دهاء سياسي وحسابات معقدة، لا يكون سوى لجامًا يحول دون انزلاق السلطة الوليدة نحو مستنقعات الاستبداد التي طالما أغرقتها المنطقة. فهو ليس عربون ثقة مطلقة، بل أشبه بخيطٍ بين السوط والأمل، غايته كبح الجموح، إن وُجد، وتوجيه البوصلة نحو ما يخدم الإنسان السوري قبل الكرسي. هو أداة ضغط لا تُستخدم هذه المرة لإخضاع الشعب، بل لكبح من قد تسوّل له نفسه التفرد بالحكم باسم المرحلة.
إلا أن التحول لا يُمنح من الخارج، ولا تُستورد الكرامة من عواصم القرار، بل تُصاغ داخل البيت السوري، على موائد المصالحة، وفي نبض الشوارع التي لم تفقد صوتها رغم الردم. هنا، الكلمة الفصل لا يملكها ترامب ولا باريس ولا برلين، بل يمسك بها السوريون أنفسهم، إن استطاعوا تجاوز لعنة التشرذم، والالتفاف حول رؤية جامعة لمستقبل لا تكتبه البنادق، بل تحرسه الكرامات.
وفي المقارنة بين ما كان وما يُرتجى، يتضح أن النظام القديم لم يكن يرى في الخارج إلا رافعةً لبقائه، بينما تلوح السلطة الجديدة، رغم ما يُقال، كجسدٍ لم يكتمل بعد، وجهازٍ سياسي لم يتحول إلى أداة قمع شاملة. هو كيان في طور التشكّل، لم تثبت أقدامه بعد، ولم تُصقل ملامحه بالقسوة، ولذلك فإن ما يُقدَّم له من دعم لا يمكن أن يكون، في هذه اللحظة، إلا رافعة لبناء ما تهدّم، لا أداة لقهر جديد.
إنّ رفع العقوبات أو تخفيفها، في هذا السياق، لا يصبّ فقط في صالح الحكومة الجديدة، بل يُعدّ، في المقام الأول، متنفسًا لشعب أُنهك من العتمة والجوع والعزلة. الشعب هو أول من يذوق مرارة العقوبات، وهو الأجدر بأن تُعاد إليه القدرة على التنفس. ولا بأس إن استفادت السلطة من هذا الانفتاح، شريطة ألا يكون على حساب الدم، بل في سبيل استقرار حقيقي يُؤسس لحكمٍ لا ينتمي إلى موروث الجلادين.
ومع أنّ بعض العواصم الغربية تتقن فنّ الانتظار، وتعرف كيف تساوم على المواقف، فإنّها، في الملف السوري، تدرك أنّ الفراغ في دمشق لا يُملأ بالتصريحات، بل بوجود فاعل، يمنع تسلل الأجندات الإقليمية الجشعة. فتركيا، التي تمددت على الأرض السورية باسم النصرة والتحرير، لا تخفي طموحها في إعادة رسم الشمال كملحقٍ عثماني. وإن تُركت دمشق لمصيرها، فإن الخيار الأقرب لها سيكون الارتماء في حضن الجار المتربص، كما فعل النظام القديم مع طهران.
من هنا، فإن الحضور الغربي في المشهد السوري، ولو بدا محاطًا بالشبهات، يبقى ضرورة لقطع الطريق على لعبة الأمم التي لا ترحم. والعاقل من استثمر هذا الانفتاح لا لإطالة عمر سلطته، بل لإعادة ترتيب البيت الداخلي، ومنع انزلاق البلاد نحو لعبة الولاءات.
في النهاية، تبقى سوريا معلقة بين قوتين: سلطة تحاول أن تبني لنفسها شرعية، وشعب يتوق إلى استردادها. وإذا كان الغرب اليوم هو من يفتح الأبواب، فإنّ مسؤولية العبور تقع على عاتق السوريين وحدهم. إن تمكنوا من تجاوز انقساماتهم، ومن بناء تصور موحد لمستقبل تليق به ذاكرتهم، وتمجّده تضحياتهم، فإنهم بذلك يكسرون حلقة الاستبداد، ويفتحون دربًا جديدًا نحو السيادة الشعبية التي تأخرت طويلاً، لكنّها لم تمُت.
بوتان زيباري
السويد
15.05.2025