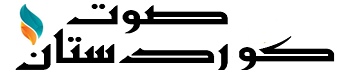صدر الزلزال عن دار لوتس للطباعة والنشر والتوزيع – مصر
الكتاب من القطع المتوسط عدد صفحاته 217
تأتي باكورة الأعمال الإبداعية الروائية للشاعر والناقد ريبر هبون – الزلزال – كأحد الأعمال السردية الأولى التي سلطت الضوء على كارثة طبيعية لا تزال صورتها ، أصداء صرخات الضحايا تتردد في آذاننا ، ولا يزال المشهد ماثلاً في أعيننا جميعاً بعد أن هزت ضمائرنا، ووجدنا أنفسنا- وإن كنا بعيدين عن موطن الكارثة أو قريبين – عاجزين عن فعل أي شيء.
هذه الانطباعات السريعة التي أرصدها هنا تذهب أبعد من حدود هذا الرصد الأولي لأنها تلامس تأثيرات الطبيعة على الإنسان والمجتمع.
يخيل إلى القارىء أن رواية الزلزال للشاعر والروائي ريبر هبون لم تكتب كي تتناول كارثة جيولوجية، فحسب، لكنها في الحقيقة تعيد رسم خرائط الألم الكردي بأدوات الأدب ووعي المأساة.
إذ إنه منذ اللحظة الأولى، يدرك هذا القارئ أنه ليس أمام عمل روائي تقليدي يرصد آثار زلزال ضرب مدن كردستانية متوزعة بين الجنوب التركي والشمال السوري، بل أمام تجربة سردية كثيفة، توثّق وتُدين وتُفكّك، تكتب عن الركام لتكشف ما تحته، وتحفر في باطن الأرض والإنسان في آنٍ معًا.
تندرج الرواية في حقيقتها ضمن أدب الكوارث، لكنها تذهب أبعد من ذلك، صوب كوارث أعمق وآلم، وهي تنحرف عنه بطريقتها الخاصة.
إذ لا تكتفي فقط بنقل صور الدمار والانهيار، بل تحوّل الزلزال من حدث طبيعي إلى استعارة شاملة عن الانكسار الجمعي الذي يعانيه الكرد كهوية ووجود.
تدور الأحداث في مناطق حقيقية كـ”عفرين، جنديرس، جنديرس، مرعش، “هاتاي”، ديار بكر”، وهذه المدن ليست فقط مسرحاً للأحداث، بل تتحوّل إلى شخوص تنزف وتئن وتُسحق تحت أقدام التجاهل والنفاق السياسي والطائفي.
إنها رواية عن زلزال واقعي، محدد، مسمى، لفت أنظار العالم برمته، لكن الزلزال الحقيقي، كما توحي الرواية، ليس في الأرض، بل يكمن ويغوص في الضمير.
يركز ريبر هبون على الفرد العادي، الكردي الهامشي الذي لا يظهر في نشرات الأخبار، ولا في تقارير الإغاثة.
شخصية “أبو بروسك”، الأب الذي يبحث بين الركام عن أولاده، تتكرّر كصورة للإنسان الذي لم يفقد فقط أبناءه، بل فقد وطنه، صوته، كرامته.
حميدة، تلك المرأة التي ارتمت فوق شجرة تحتمي بها من سقوط الكون، ليست مجرد ناجية، بل رمز للأرض الكردية التي تصرّ على الحياة رغم الخوف والتهميش. لزكين وبيكس، هما اختزال للأمل المكبوت، والحب الذي لا تمنحه الحياة فرصة، لكنه يُصرّ أن يُعبّر عن نفسه ولو برسالة في جيب جثة
-شخصيات في وجه الكارثة والغياب:
يحضر لزكين وبيكس في الرواية كوجهين شابين لحالة كردية مقموعة، هشّة، تحاول أن تُبقي على كرامتها في وسط زلزال واقعي ومجازي معاً.
لا يقدَّم الاثنان كأبطال نمطيين، بل كشخصيتين تنبض داخلهما مأساة مزدوجة: الأولى هي المأساة العامة التي أصابت المكان والناس، والثانية هي الغربة الوجدانية التي تركها الحب، الفقد، والوحدة
بيكس يبدو على تماس مباشر مع الزلزال لا فقط بوصفه حدثًا طبيعياً، بل كرمز داخلي يضرب في قلب ذاكرته.
حين يتأمل الفاجعة، لا يرى فقط الركام، بل يرى وجه زيلان الفتاة التي تعرفت عليها في الجامعة، قبل أن تنقطع السبل بها. علاقة بيكس بزيلان ليست مدفوعة إلا عن حاجة لوجود رابطة أشبه بالأخوة، زيلان تمثّل في الرواية جزءًا من بيكس الذي ضاع، أو بالأحرى، لم يُسمح له أن ينضج.
أما لزكين، فيعيش على وقع غياب “رونيا”، التي تبدو وكأنها ذاكرة نَفَس أخير من حياة سابقة، كانت له فيها فسحة من الضوء. حين يقول لزكين إن رونيا “أخذت معه كل شيء حي”، نفهم أن وجوده بعد الفقد لم يعد حقيقياً، بل مجرد مقام مؤقت لجسد يبحث عن روحه.
لا ندري إن كانت رونيا قد ماتت، غادرت، هُجّرت، لكن الأهم أنها غيبت المعنى، وهذا يكفي. لزكين لا يتحدث كثيرًا، لكنه يحمل حزناً هائلًا صامتاً، يصوغ مواقفه، يحدد ردات فعله، ويجعل منه شاهداً مقموعاً على الزمن الكردي.
العلاقة بين لزكين وبيكس ليست سطحية. هما لا يتبادلان الحوارات الطوال، لكن الانكسار يجمعهما. كأن الرواية تقول إن الكردي حين تُسحق هويته، لا يصرخ، بل ينظر في عيني أخيه ويفهم. ما يربطهما هو التواطؤ على الصمت، والإيمان أن الكلام لم يعد مجدياً. وفي لحظة الزلزال، لا يسألان: لماذا؟ بل يتساءلان: من سيبقى ليحمل الحكاية؟
لا زيلان ولا رونيا تظهَران حضوراً مباشراً في الرواية، لكن غيابهما فاعل جداً.
هما ليستا بطلتين، بل أثرين نفسيين، تشكّلا داخل ميران ولزكين بمقدار ما تشكّل الزلزال في الأرض. الرواية تنجح هنا في تصوير كيف أن الحب ليس دوماً فعلاً خارجياً، بل ذاكرة وجودية، توقظ أشياء فينا حين يظن العالم أننا مشغولون بالنجاة فقط.
وفي النهاية، نرى أن لزكين وبيكس ليسا مجرد شابين في كارثة. إنهما ترميز لجيل كامل من الكرد، فُرضت عليه الحياة تحت الركام: ركام الاحتلال، الخوف، الفقد، والصمت. ومع هذا، يبقيان في الرواية نواتين نابضتين للحياة، ولو بأضعف النبض.
أسلوب الرواية جريء، غير خاضع لقواعد الزينة أو التهذيب البلاغي. اللغة هنا شديدة التوتر، مشحونة بالعاطفة، قاسية أحيانًا ومباشرة، وفي أحيان أخرى تنساب بشاعرية مؤلمة. هناك انكسار غير قواعدي حتى في النحو، وتكرار مقصود، وانفجارات لغوية تُحاكي الانفجار الداخلي للشخصيات. لا توجد فواصل أنيقة بين المقاطع، كما لا توجد فواصل بين الحياة والموت، بين الإنسان والحطام. يستخدم الكاتب لغة مشوّشة لتوصيل الشعور بالتشويش، وفوضى لتجسيد الفوضى، وكأن السرد نفسه مصاب بالهزة ذاتها التي ضربت الأرض.
أما البنية السردية، فهي متقطعة ومتشظية، لكن هذا التشظي مقصود، ومنسجم مع طبيعة الحكاية. يتنقل الكاتب بين الشخصيات دون مقدّمات، ويقفز في الزمن والمكان، ليعكس الضياع العام الذي يعيشه المجتمع بعد الكارثة. لا يوجد بطل أو حبكة تقليدية، بل أصوات متداخلة، تحكي وتصرخ وتحتضر وتحب وتكره وتلعن وتكتب وصيتها على جدار مهدّم. الرواية هنا لا تتبع منطقًا سرديًا كلاسيكيًا، بل تتبنّى منطقًا وجوديًا يائسًا، حيث لا شيء يمكن التنبؤ به، كما لا شيء يستحق الانتظار
ومن أذكى عناصر الرواية هو دمج الواقعي بالخيالي، دون أن يبدو ذلك منفصلًا عن سياق المأساة. فالكاتب لا يتردد في السخرية السوداء من رجال دين يتاجرون بالإغاثة، من سياسيين يتظاهرون بالتعاطف أمام الكاميرات، من فصائل توزع الخيام حسب الطائفة، من إعلام يسلّط الضوء على طرف ويتجاهل آخر. في هذا المشهد، لا تبدو الفانتازيا مفروضة، بل منسجمة مع العبث الذي يطبع الواقع. وكأن الخيال هو السبيل الوحيد لوصف واقع أكثر جنونًا من الخيال ذاته.
اللغة في الرواية مشدودة، ممزقة، تنبض أحيانًا كشعر، وأحيانًا كألم محض. الأسلوب متقطع ومتشظ كأن السرد نفسه يعيش ارتجاجًا. الجمل تأتي كأنها أنفاس مقطوعة، والانفجارات اللغوية تعكس الهزة النفسية التي تصيب الشخصيات. تقفز الرواية من شخصية إلى أخرى، ومن زمن إلى آخر، لكن هذه القفزات ليست عبثًا، بل جزء من منطق الكارثة.
الخيال هنا ليس هروباً، بل وسيلة لكشف المستور. الشخصيات تُرى في المنام، الموتى يتحدثون، والأنقاض تحمل رسائل. إنها تقنيات ما بعد المأساة، حيث لا يمكن للنص أن يكون وثيقة فقط، بل عليه أن يكون روحاً حيّة في وجه الموت. ومن أذكى عناصر الرواية دمج الواقعي بالرمزي، دون افتعال، بما يكشف عن وعي الكاتب بجغرافيا الألم الكردي، لا كجغرافيا سياسية، بل كجغرافيا معنوية
أما الشخصيات، فكل منها مرآة لوجه من وجوه الكارثة. “أبو بروسك” الأب المكلوم، يحمل بين يديه ليس فقط أبناءه، بل بقايا رجولته المنتهكة. “أمين”، المسعف الذي لا يسعف نفسه، يبحث عن الجثث كما يبحث عن سبب للنجاة. “لزكين”، و”ميران” العاشق الذي يكتب تحت الأنقاض، لا رسالة حب، بل رسالة اتهام للعالم. و”حميدة”، تلك التي لا تبكي كثيرًا، بل تصرخ في داخلها، تمثل الوجه الصامت للكارثة، الأم التي لا تجد مكانًا تلد فيه حزنها.
أهم ما يميز الرواية أنها لا تقع في فخ الخطابة أو المظلومية الزائدة. نعم، الرواية تصرخ، لكنها صرخة مُسوغة، تستند إلى وقائع، وتشير بأصبعها إلى الجرح لا لتستجدي الشفقة، بل لتعلن الغضب. الغضب من الدولة التي فشلت في الحماية، من الإعلام الذي فرّق بين ضحية وضحية، من العالم الذي يشاهد دون أن يتحرك، ومن الذات التي اعتادت القبول بالقهر.
وتتجلّى في الرواية جرأة غير مسبوقة في نقد المؤسسة الدينية والسياسية، من خلال شخصيات تُفرّغ الدين من مضمونه، وتستخدمه كغطاء للانحراف. مشاهد تعرض فتاوى تُستخدم لتسويغ السبي، قادة فصائل يتباهون بأعداد النساء “المباحات”، رجال يُقيمون الخيام لا للنجدة، بل للهيمنة. كل ذلك يُقدّم بواقعية تهكمية توجع أكثر مما تُضحك، وتقول ما لا يُقال إلا من تحت الأنقاض.
لكن الأهم من كل ذلك أن الرواية، رغم سوداويتها، لا تُفرّغ الإنسان من إنسانيته.
هناك لحظات حنان، صداقة، حب، وفاء. هناك رسائل، أحلام، محاولات بسيطة للبقاء. وحتى الموت في الرواية لا يأتي عبثًا، بل محمّلًا برسائل ودلالات. كل شهيد يُذكَر، وكل جثة تُسترد، وكل ناجٍ يُمنح فرصة ليحكي. هذا الحكي هو جوهر الرواية، والنجاة الوحيدة الممكنة.
ما هو ملفت أن الرواية لا تُغلق بابها على حلّ مسبق، مصنوع. إذ لا شيء يُحلّ. الركام باقٍ، الألم مستمر، والزمن لا يعود إلى الوراء. لكن الرواية تقول: هذه حكايتنا، نحن الذين دفنّا أبناءنا، ونجونا، لا لننسى، بل لنتذكّر ونكتب. الكتابة هنا ليست فقط فنًا، بل فعل مقاومة ضد النسيان، ضد التهميش، ضد التاريخ الذي يُكتب بلغة الأقوياء.
من هنا، فإن رواية الزلزال ليست رواية عن كارثة، بل رواية كُتبت بالكوارث.
صوتها ليس مجرد سرد، بل شهادة، وموقف، واتهام، وبكاء حادّ في وجه عالمٍ أعمى.
هي نصّ جدير بأن يُقرأ، لا لأن فيه حكاية مأساوية، بل لأن فيه إنسانًا قرّر ألا ينسى، ولا يسمح للعالم أن ينسى، لذلك نرى أنه عندما تمضي الرواية أبعد من مأساتها، فإنها لا تكتفي برصد الألم، بل تتجاوزه لتفكيك أسبابه، ومساءلة واقعه، وفضح بنيته. هذا بالضبط ما تفعله رواية الزلزال لريبر هبون. إنها لا تُسجّل مأساة الزلزال بعيون المتفرج، بل تعيد صياغتها من الداخل، بعيون من عايشوها، ودُفنوا تحتها، وخرجوا منها وهم ليسوا كما كانوا.
الرواية تمضي أبعد من صورتها الكارثية، لأنها لا تُعنى فقط بانهيار الأبنية، بل بانهيار المعنى، وبحث الإنسان عن ذاته وسط الخراب. تمضي أبعد لأنها تُعرّي الواقع السياسي والاجتماعي، وتُعرّف المأساة بوصفها نتاجًا للتواطؤ، لا للقدر. تمضي أبعد لأنها لا تكتب عن الزلزال، بل من داخله، حيث يتحوّل الأدب إلى صرخة، واللغة إلى خندق، والشخصيات إلى شهود لا يموتون.
بهذا المعنى، فإن الزلزال ليست مجرد رواية عن حدث مأساوي، بل عن بنية مأساوية تعيد إنتاج نفسها بصمت، في كل مرة يُدفن فيها إنسان دون أن يُذكر اسمه، أو تُنسى مدينة دون أن تُقال حكايتها. و ريبر هبون، في هذا العمل، لا يقدّم مجرد شهادة، بل يُحوّل الأدب إلى محكمة للعدالة المتأخرة.
حقيقة إن الرواية تستعرض تراجيديا الزلزال على صعيدين: مجازي وواقعي – أو مجازي ومعنوي فيما يتعلق بالانهيار الذي يصيب حياة المجتمع أو الفرد في ظل الصراعات الإنسانية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.
تدور أحداث الرواية في إطار زلزال يضرب مناطق كردية وعربية في كوردستان وفي سوريا وتركيا، حيث تنتقل الرواية بين شخصيات متعددة مختلفة تعيش محنة الفاجعة.
فالكارثة لا تكشف فقط عن الدمار المادي ، ولكنها تسلط الضوء على هشاشة العلاقات الإنسانية والتوترات السياسية.
وهنا فإن ثلاثة جوانب تبرز في إطار هذا الحدث العظيم أولها: الزلزال ذاته بتفاصيله المروعة التي تجعل قارئ الرواية يشعر وكأنه يعيش تفاصيل المأساة وهذه النقطة تسجل حقاً للرواية والروائي وثانيها المعاناة الإنسانية التي تعكسها الرواية ، صوراً للموت والنجاة في آن واحد، حيث تتداخل أصوات الضحايا مع أصوات السياسيين الذين يحاولون استغلال الكارثة لمصالحهم، وثالثها ذلك الخراب بل والنهب اللذين يوثقان لما يحدث بعد الكارثة تدريجياً وكأنها امتداد لها أو جزء منها، لابد من استقرائه حيث تظهر شخصيات تستغل المأساة عبر فرض الإتاوات وسرقة المساعدات –بحسب الرواية .
ثمة ثلاث شخصيات تظهر على امتداد شريط الرواية السردي أولها: أبو بروسك وهو رمز للوالد المفجوع الذي يفقد ثلاثة أبناء تحت الأنقاض وتتحول حياته بسبب الفاجعة إلى مسار آخر.
وثانيها رونيا وزيلان اللتان تمثلان الحب الضائع والمغيب تحت وطأة آلة الحرب والكوارث وتعكسان عمق الجراح العاطفية التي تضيف بعداً آخر على الكارثة الطبيعية.
ولا ننسى الشخصيات الثانوية التي تظهر تترى على خلفية الشريط السينمائي للرواية وهم عمال الإنقاذ، الجيران، المارة الذين يمثلون المجتمع المتنوع والمتأثر بشكل جماعي بالمأساة.
من هنا فإن رواية الزلزال تقدم رؤية فلسفية خارج عين الكاميرا الراصدة فيما يتعلق بالتداخل بين الطبيعة القاسية والإنسانية المتضررة، والزلزال الذي يمثل رمزاً للانهيارات النفسية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الممزقة كي تكشف الرواية عمق التراجيديا الإنسانية في احدى محطاتها الكثيرة التي لا تقتصر على الزلزال وحده فحسب بل تمتد إلى النزاعات والحروب والتطاحنات على صعيد الحياة الاجتماعية والسياسية المحيطة به.
وتأسيساً على كل هذا فإن الرواية تبرز نقداً قوياً وصادماً للسياسات المحلية والدولية التي تستغل الكوارث لتحقيق مصالحها كما أنها تنقد بقسوة المجتمعات الهشة التي تعاني في مواجهة أزمات كهذه.
تزاوج الرواية بين الواقعية المؤلمة والرمزية العميقة، إذ أنها تجسد الكارثة من جهة بشكل يجعل القارئ أن يشعر وكأنه حقاً جزءاً مما يدور حوله وهذا ما يسجل لهذا العمل الروائي حقاً، كما أنها تتبنى أو تعتمد الرمزية العميقة من خلال الاستخدام الذكي للرموز بما يعزز من قيمة النص بالإضافة إلى أمر آخر ألا وهو إبراز النص للأبعاد الإنسانية على نحو متكامل متشابك فيما يتعلق بالمعاناة في وجهيها الفردي والجماعي على نحو متوازن مهندس بطريقة واضحة.
ولعل إغراق الرواية بالجانب الرمزي قد يكبح عملية فك بعض الشيفرات من قبل المتلقي غير المتسلح برؤية عميقة ، ما ينعكس عملياً في عملية التفاعل مع النص بسبب كثافة الرموز، ناهيك من أن تعدد الشخصيات يجعل التنقل بين العديد من الشخصيات قد يؤدي إلى تشتيت القارئ.
إن رواية الزلزال ليست فقط رواية عن كارثة طبيعية بل هي مرآة تعكس أعماق النفس، الفرد والمجتمع من خلال مزج الواقعية بالرمزية ، يقدم ريبر هبون نصاً يلامس جوهر المأساة الإنسانية ويدعو للتأمل في القيم التي تحكم علاقاتنا.
الرواية تظل شاهدة على قوة الأدب في تقديم رؤى فلسفية واجتماعية تتجاوز حدود الحدث.
إذ إن رواية الزلزال ليست فقط عن كارثة طبيعية بل هي مرآة تعكس أعماق النفس البشرية والمجتمع ، من خلال مزج الواقعية بالرمزية.
يقدم ريبر هبون نصاً يلامس جوهر المأساة الإنسانية ويدعو للتأمل في القيم التي تحكم علاقاتنا فهي تظل شاهدة على قدرة الإبداع في تقديم رؤى جمالية فلسفية واجتماعية تتجاوز حدود الحدث.