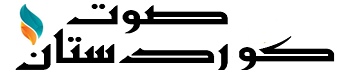منذ سقوط النظام السابق والعراق يواجه الازمات تِلو الازمات, ما أن أُفرجت أزمة الا وبدأت أخرى اشد من تلك التي قبلها, بدءً بتواجد قوات المتعددة الجنسيات الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية, وما رافق هذا الاحتلال من تدمير وحل للعديد من مؤسسات الدولة العراقية, العسكرية والمدنية, وانتقالاً الى أزمة الطائفية وما صاحبها من انقسامات مذهبية وعرقية احدثت شرخاً واسعاً بين اغلب مكوناته المجتمعية.
وصولاً الى احداث 10 حزيران 2014م, وسيطرة جماعات ما تسمى بالدولة السلامية “داعش” على مدينة الموصل العراقية, هذه الجماعات سيطرة ولأول مرة على دولتين ذات سيادة منذ قيام الحرب العالمية الثانية (العراق وسوريا) من خلال مشروع فوضوية متطرف مدعوم من قوى إقليمية ودولية، لكن بسواعد رجال العراق الابطال ممن لبوا نداء أعظم فتوى دينية صدرت بتاريخ العراق الحديث, وبمساعدة ودعم كبير لجارته إيران, استطاع أن يحقق الانتصار على تلك الجماعات, الا ان ما تَبعَ هذا الانتصار من هزائم شنيعة مُنيت بها السياسة الاميركية في سوريا ولبنان اثارت حفيظة التوجس الاميركي من ان يُستكمل بهزيمة اكبر من سابقاتها, ان حصلت في العراق لصالح محور المقاومة الذي تدعمه ايران، وهو ما اضطرها لوضع خيارات استراتيجية متوجة سلفاً في سياستها الامبريالية الرسمالية امام الحكومة العراقية المقبلة حتى قبل تشكيلها.
وهنا البعض قد يسأل ما لنا وايران حتى نكون طرف في صدام نحن في غنى عنه؟ اقول: ان الامر ليس بهذه البساطة التي يتصورها البعض, فالاستراتيجية الاميركية هي استراتيجية لا تعرف المحدود في نظرتها للعالم، وبالتالي لا تقف عند معاداة العراق لجارته ايران أو بقطع العلاقة معها, فالتاريخ لم يذكر يوماً ان من كان محتلاً لبلد ما, وقد خرج منه دون ان يُعيد ترتيب اجنداته في هذا البلد, وبما يتطابق مع مصالحه ومعطيات الحالة التي جرى في ظلها الاحتلال, وقطعاً لا تعد حالة العراق خارجاً عن هذا لسياق, خصوصاً وان ما يشكله العراق من أهمية كبيرة بالنسبة للإدارة الاميركية، فلا يصح لدولة عظمى كالولايات المتحدة ان تكون ذات سلوك في السياسة الدولية دون هادٍ لها.
بالتالي فأن اميركا لها استراتيجية تهتدي بها تجاه العراق سابقاً ومستقبلاً, وإن حصل هنا بعض الفتور والتراجع في سلوك هذه الاستراتيجية أحياناً, الا ان هذا التراجع في السلوك ليس من جانب المحدد الداخلي للإدارة الاميركية فقط والمتمثل بالحزبين “الديمقراطي والجمهوري” اللذان يتباينان في نظرتهم لإدارة وتأثير هذه الاستراتيجية تجاه العراق، الا ان كلاهُما لا يجحدان هذه الاستراتيجية اطلاقاً, وإنما المحدد الخارجي هو الذي يكون مؤثراً وفاعلاً في نشاط هذه الاستراتيجية, وأحد هذه المحددات ولعل ابرزها؛ هو وجود حركات المقاومة الاسلامية المدعومة ايرانياً في الشرق الاوسط.
على مستوى العراق اصبح لهذه الحركات قوة عسكرية سياسية خصوصاً بعدما ستُشكِل الحكومة القادمة, التي تكون هذه الحركات احد مكوناته الاساسية وقطعاً هذه الحركات ستصبح من المتضادات مع هذه الاستراتيجية الاميركية, التي ستجد ان القضاء على هذه المتضادات لا يمكن الا بارتهان الحكومة العراقية المقبلة للاستراتيجية الاميركية التي تُفرض عليها كمغنمه اميركية تحصل عليها بعد الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش وبدوافع متعددة, لعل أبرزها هو الحماية التي لا تقدمها اميركا مجاناً مثلما هو حاصل مع المحمية النفطية السعودية, التي وفرت لها في صفقة واحدة اكثر من 650 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة في وقت يعاني كثير من الشباب السعودي المسلم من البطالة!.
وادراكاً لهذه المصلحة وأهميتها في الاستراتيجية الاميركية “ترامبيا” ذهبت الادارة الاميركية الى فرض مزيد من العقوبات على ايران لتحجيم دور المقاومة الذي تدعمه, بل الى ما هو أبعد من ذلك كتقديم الكونجرس الاميركي بعض هذه الحركات التي ستشارك في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لمجلس الشيوخ من اجل ادراجها على قائمة الجماعات الارهابية ومن ثم استصدار العقوبات بحقها, وبهذا الاقدام فإن الاستراتيجية الاميركية تضع امام الحكومة المقبلة خياران لا ثالث لهُما, وهذان الخياران هُما:
الاول: الانضمام للدور العربي في مواجهة المحور الايراني, ومن ثم التسليم بما تمليه توجهات الادارة الاميركية دون قيد او شرط, كما هو الحال مع المملكة السعودية، اما الخيار الثاني: العقوبة والمجابهة التي ستفرض عليها إقليمياً ودولياً, كما هو حاصل مع حزب الله في لبنان.
على هذا فإن ايجاد قراءة واقعية دقيقة لطبيعة التجاذبات الاقليمية والدولية بات ضرورة من ضروريات الحكومة المقبلة, التي ستكون هي المسؤولة عن ادارة الدولة وبالتالي فإن أي سوء في التقدير أو خطأ في الحسابات سيتركها رهينة لاستراتيجيات خارجية, ولذا سيكون لزاماً عليها البحث عن مساحة جديدة لحركتها الخارجية بما يضفي لها مزيداً من النفوذ ويحقق تعدد في البدائل.